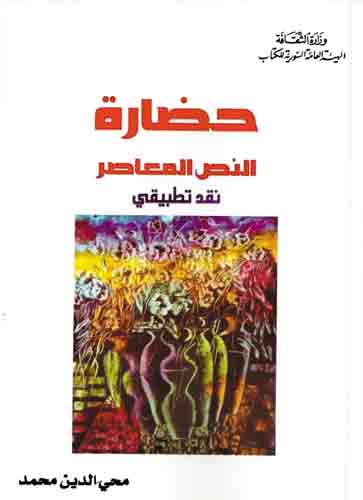الملحق الثقافي:ألوان إبراهيم عبد الهادي:
ما لفتني في كتاب «حضارةُ النصِّ المعاصر – نقدٌ تطبيقيّ» لمؤلّفه الشّاعر «محي الدين محمد»، استطلاعه لحلبةِ النصّ النقدي، الذي تفتقر الساحة الأدبية إلى معناه الحقيقي، وبعده الموضوعيّ، ففيه يأخذك المؤلّف إلى حضرةِ لفيفٍ من النقّاد والشّعراء، فتكون بين كاتبٍ ناقد، وآخر مبدع، وأمام ما يطرحه «محي الدين» حول النصّ الأدبيّ، من شعرٍ ونثرٍ ورواية.
يقول في المقدمة: «اخترت في السياقِ العام للدراسة، خطوات الطريق إلى الشجاعة النقديّة، وخاصة النقد التطبيقيّ الأصعب فنّاً، لأن العامل عليه يجب أن يمتلك أدواته، بحيث ينتج نصّاً آخر غير النص المنقود، وذلك في الوقوف على قيمته المعرفيّة والجماليّة، ودلالات المعاني التي حقّقت غرضاً فكريّاً محدّداً، وبما يُغني المذهب التعبيريّ، في انتمائه للعناوين المختلفة..».
يتناول الكاتب أسماء شعريّة لشعراء الحداثة المؤسّسين، ممن وضعهم النقّاد تحت عدسة نقدهم، وأخذوا في تشريحٍ طبيعة وقيمة نصوصهم، ليقدّم بعدها أصواتاً ثقافيّة مميزة، وضعت هذه النصوص في رؤياها المنبعثة من عمالقة الفكر الانسانيّ النقديّ، كـ «اسبينوزا و مونتسكيو» في ثورةِ المدنيّة، والصراعات الكونية القاذفة للحضارة إلى الهاوية، حيث السقوط المريع، مستبعداً الزمان والمكان، كما في «عنزة غاندي» و»السكن في الخيمة» وغير ذلك مما يوضّح فيه الصدمة المعرفيّة التي اشتغل عليه النقاد، من ثنائياتِ التضادِ في التقابل اللغويّ الذي يرفض النصوص التي لم تنضج ثورتها المعرفية، وتصورها الحديث لحضارةِ عصرها..
ويؤكّد الكاتب على حيويّة النصّ الأدبيّ، كالرواية والقصة والمسرحية، كجنسٍ أدبيٍّ مضاف إلى الشّعر، مشيراً إلى أن العمل النقدي الحديث، في اليدِ الثالثة، هو المصفاة التي تصعدُ منها رائحة الموهبة، فهو الثوب الشفّاف لمحاسنِ الموهبة الفطرية، المرصّعة بروحِ الفكر والثقافة الجمعيّة، دالاً على «دون كيخوت» الفارس الذي علّم الانسانيّة، وأعطى الأدباء الطريق لتجاوز عصورهم، من خلال لغةٍ تلامس دواخلهم، وتلهب حسّهم الجماليّ، لينتقل من «سرفانتس» الإسباني، إلى «رسول حمزاتوف» ابن داغستان، بنصوصهِ الحيّة الحاملة للضمير الوطنيّ، والإنسانيّ الموحِّد وغير المفرِّق، حيث يقول: «أيها البين بين/ إني لا أحبّك/ ولن أشرِّفكَ بعداوتي»..
يقول الكاتب، إنهما يدٌ ثالثة تحاول الحفاظ على الإبداع الإنساني، بعيداً عن السياسة والدين والعوامل الأخرى في تفاعلها الكونيّ، ضد العولمة الثقافيّة المدمّرة، التي تقودها أميركا، وإن الطاقة الصوتية لحرفٍ يشكّل البناء اللغويّ للكلمة، هي مؤسّسة العربية التي لا منافس لها، وإن النصوص تحتاج للتفاعل معها بأدواتٍ معاصرة للآخر، كالترجمة التي تتجدّد فيها أصوات البناء الداخليّ للنصوص المبهمة، التي تحتاج إلى نقّادٍ أذكياء، ويسأل «محي الدين» ويجيب: «هل يمكن أن نفصل بين النقد وثقافة النقد؟.. وهل يشكّل النقد خطراً ما»؟!.. لا أعتقد، لأن النقد هو الذي يقوّم الفعل الثقافيّ، ويدخل في معركةِ الإبداع دون إقصاءٍ لأحد، ولتحقيق ذلك لابدّ من التقيّد الصحيح، عبر تصنيفِ النقد وإبعاده عن التهاون في التعاون، مع النصّ المراد تحليله».
يوضّح هنا، أن «أبو حيان التوحيدي» أحرق كتبه انتقاماً من نفسه ومن أهل زمانه، و»الجاحظ» قضى نحبه بين أسرار الكتب التي وقعت عليه، و»جبران خليل جبران» و»يوسف الخال»، أكثر ولوعاً بالمجهول الذاتيّ في وديان الرمز العميقة، و»سعيد عقل» المنسي ومقولة «فيثاغورث»: «إن التماس المعرفة أعظم ألوان التطهير، ويبرز موقف د.»طه حسين» في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» المناهض لمظاهر القمع والعنف الذي يمنع المبدعين من التفاعل البنّاء، في حضارة الأمة ونهضتها المعاصرة.
ويبرزُ الكاتب أهمية المكان في اللغة الابداعيّة، كما في رواية «أحمر خفيف» للروائي المصري «وحيد طويلة» الذي أكّد على خرابٍ امتدّ إلى القرية، ويقول «ميخائيل عيد» في كتابه المترجم عن الكاتب البلغاري «ايفير يمكار نفيلوف»: «في حياة كلّ أديب وخاصة في شبابه، حادثٌ دراميّ يتجمّع حوله كفعلٍ مثير، ويمنح الاتجاه لهذا المبدع كي يمضي قدماً نحو الأمام، مثل تولستوي وحرب القرم، وبوشكين القفقاس، وحياة دوستويفسكي في سيبيريا، وفي الجريمة والعقاب، والإخوة كارامازوف، والأبله.. وهي نصوصٌ أصبحت مرجعية ومشروع أدبي حضاري للإنسانية.
هذا الحدث الدراميّ، يبرزه الكاتب في الإشارة إلى الهمِّ الوطنيّ والإنسانيّ عند الشّاعر «بدر شاكر السياب» و»عبد الوهاب البياتي» في منفاه الإلزامي، و»خليل حاوي» الذي أنهى حياته عند احتلال بيروت، و»أمل دنقل» في غربته بالريف المصري، وينعكس عند «البياتي» في موت ابنته الذي حطّم قلبه. يقول في كتاب «غيبوبة الذكرى» للناقد د.»حاتم صكر»: «قبرك في المنفى/ وفي الوطن/ قبرك في كلّ مكانٍ/ شعَّ فيه الضّوء والكفن/.
وفي بحث «المعايرة في النقد» طرح «شيفرة دافنشي» ووضع رموزها في البناء الفنيّ، في اندماج المكان بالذات المبدعة التي أفرزتها مخيلة ملهمة، عبر «الموناليزا» و»العشاء الأخير»..
ويقف الكاتب عند أسماء ذات حضور شعريّ على كلّ الصعد، كـ «أدونيس» و»جبرا ابراهيم جبرا»، و»الشابي» و»سركون بولس» وآخرين، ومجلة الشعر الصادرة ١٩٥٧ شكّلت منعطفاً مهماً في تجربتها التي احتضنت كلّ الفعاليات الحداثية، متجاوزة بلغة أصحابها، الصورة المألوفة للنصّ الشعريّ.
يتابع في كتاب «التفكيكيّة» ترجمة «عبد الجواد جليل»، بأن مهمة النقد الأساسية، توفير إطار عملٍ شرعيّ، أو نظام للرؤية الداخلية يمكن للقارئ الوصول إليها، مثل «السراب الصحراوي يخدع العطشان»، و»ماء النهر يكذّب الغطاس»..
لقد أفرد «محي الدين» ثلثي كتابه المؤلف من ٢٥٥ صفحة، لثلّةٍ من رواد الحداثة الشّعرية، واضعاً نصوصهم تحت مجهر النقد التطبيقي، ليوحّدها الحدث الدراميّ، أو صدمة حداثوية جدّدت في البناء الفنيّ للنصّ الشعريّ المعاصر.
يأخذ ومضات عن هذه الدراسة، بادئاً بالشاعر «السياب» الذي حاوره في قصيدة «رئة تتمزّق»: /كم مرّة ناديتُ باسمك أيها الموت الرهيب/ ووددتُ لاطلع الشروق علي إن مال الغروب/.. يليه «ناظم حكمت» في حسرة أكبر وحلم أوسع، فقد شكّل جسراً ثقافياً بين الغرب والشرق، وقد توفّرت لنصوصه الأدوات والأسلوب الذي استخدم فيه الألفاظ السهلة والجمل القصيرة والتنويع الموسيقي، ما جعله من روّاد الحداثة، يناصر الطبقة الكادحة وثورة الجياع، كما في قصيدته لـ «زويا» فتاة الثلج التي أعدمها الألمان وهي غضّة»: أخرجوها من الغرفة/ كان رأسها مجرّداً من القبعة وجسمها عارياً من الثياب/ وشفتاها متورمتين من شدّة ماعضّت عليهما/ تسيلُ منهما الدماء/..
كانت لقاءاته مع كبار الشعراء، أمثال «بول ايلوار» و»بابلو نيرودا» و»لويس أراغون»، فاستفاض في تبيان أدواته الحداثية العالية، في نصّه الشعري المكفّن بالألم والأوجاع والصدق والإنسانية.
أما عن «حامد حسن»، فيقول إن همّه كان كونيّاً، رغم غلبة الشخصنة على استهلالاته وأفكاره، وعلاقته مع الطبيعة عبر التعبير عن الصورة بالصورة ذاتها، حيث يصف كوخه: /كوخي على السفحِ المطلّ على المروجِ على الضفاف/ يغفو على الشبّابة السَكرى على ثغوِ الخراف/.. ويقول: «كان حامد حسن في سفره الخياليّ، شاعراً لا تُضبط حدود تأويلاته، لأنه يلاحق آفاقه البعيدة بمرجعياتٍ متأصلة في الرؤيا، وقال عن حبّ الوطن: «يحتاج إلى لغةٍ قد يضيق بها الشّعر والنثر».. ويؤكد أن «حسن» واحدٌ من شعراء العربية الكبار، الذين ظلّلوا محارقهم بالحبرِ الأخضر واحتفظوا بالقيمة الأدبية، دفاعاً عن الحياة والحرية.
والشاعر «إيليا أبو ماضي» في نصّه المجدّد الرافض للابتذال، يقول لزملاء الرابطة في أمريكا، إنه «رسول المحبة والسلام والحرب»: إنما نحن معشر الشعراء/ يتجلى سرُّ النبوّة فينا/.. وفي ديوان الجداول يقول: «نسي الطين ساعة أنه طين/ حقيرٌ فصالَ تيهاً وعربدْ/.. والكاتب في دراسته الموسّعة لشعره، خلص إلى حكاية العلاقة التبادلية، بين الشّاعر ومجتمعه الذي عاش فيه زماناً، فقصيدة «طلاسم» تحمل قضيّة وجوديّة محيّرة، في «لست أدري» و»الطين» و»الصوفي»، إذ كان الصوت الشّعري فيهم علامة أخرى، على كلّ المستويات الفكريّة والخلقيّة، وكانت لغته قد تأثرت بالتلاقح الثقافيّ العالميّ، نتيجة الاحتكاك مع الغرب والاطلاع على تجربتهم.
يستعرض الكاتب أيضاً، نصوص «عصام خليل» في ديوان «لها وعليها السلام»، واختراقه الموقف الوسط بين النقاد، ليحقق درجة عالية من الإثارة، ما شكّل افتتاحية تدل على خصوبة مفرداته، كما في الإهداء المثير في قوله: «إلى شوكةٍ ضجرت تحت جلدي..»
يقول الكاتب:» لم يعتمد عصام في تكنيكه الفنيّ، وهو يخاصر أحزانه، لغة النوح كما الكثيرين، بل كان خطابه الجنائزيّ رقيقاً، وكأنه يستعيد قول «طاغور»: يا إلهي إن بيتكَ واسع.. وإن بيتي صغير»، ليقول «خليل»: «ماكنت أعلم أنني سأضيف مقبرة إلى قلبي/ وأرقدُ في حنانِ العشب/ ساقية من الألم/.. فهي لغة عادية، ولكنها مكثّفة ومملوءة بالانفعالات والارتطام العاطفيّ.
ولا ينسى الكاتب، الشاعر «عبد اللطيف محرز» وقوله: «لن تكون شاعراً إذا لم تستطع أن تعيد ترتيب أوراقك العصيّة على التقليد، ففي البساطة يتجلّى سحر العظمة».. يقول الكاتب: «نلمس في تكوينه الفنيّ صدق معاناته، وكأنه يعيش بين لغتين، لغة قلقة على من يعيش حوله، وأخرى مقاومة لفوضى وخراب كلّ مجالات الحياة، كما في ديوان «حياة ذاتية» و»قيثارة الكهولة»: «أسيرُ كهلاً على أنغامِ عشريني/ لأكسب العمر في كاسات سبعيني/.. وتبرز شعرية المكان في قصيدة «قريتي»: «قريتي أرجوحة الضوءِ على صدرِ الليالي/ غزلتها من جفونِ الشّمس آيات الجمال/.
التاريخ: الثلاثاء19-10-2021
رقم العدد :1068