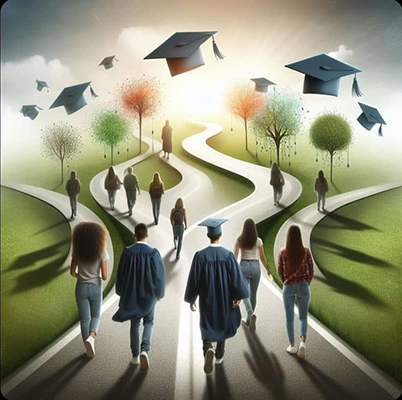الثورة – ميساء السليمان:
في عالم تتصارع فيه الحقائق مع الأحلام وتضيع فيه البوصلة أحياناً بين الركام والحنين، تبقى الأجيال تنتقل عبر الزمن متأرجحة بين الأمل والألم، ولعل سوريا تجسد هذه المعادلة بأوضح صورها، فمنذ أكثر من عقد من الزمن لم يعد الألم فيها حدثاً عابراً، بل تحول إلى مشهد يومي محفوراً في ذاكرة أطفالها، ووشم على جبين شبابها، وترنيمة صامتة في قلوب أمهاتها، لكن رغم ما حدث أو ربما بسببه يولد الألم من رحم المعاناة ففي شوارع وحارات دمشق والمحافظات الأخرى والقرى النائية يتردد سؤال بصوت خافت لكنه عميق: “إلى أين نمضي؟”.. بين جدران البيوت المهدمة أو التي ما زالت صامدة بالكاد تنشأ أجيال من الشباب السوري وسط تناقضات قاسية أحلام كبيرة وواقع ضيق في زمن الحرب أو شبّ في ظلاله يتأرجح بين الأمل في مستقبل أفضل وألم الحاضر الذي يخنق كل محاولات التقدم.
“الثورة” رصدت آراء بعض الشباب في دمشق:
شباب بلا خيارات
مرهف (23 عاماً- خريج كلية العلوم- دمشق) تخرج منذ عامين ولم يجد عملاً، حتى وإن وجد عملاً فالراتب لا يكفي أجرة مواصلات، وبالتالي كل أحلامه صارت مؤجلة أو ربما منسية، فكر جدياً في الهجرة إلى مصر مثله كآلاف الشباب الذين يرون في الخارج فرصة لحياة إنسانية أفضل.
في المقابل تقول رغد (19 عاماً- طالبة في كلية الآداب)، بينت كيف تحاول أن تصنع مساحة للعمل، فهي تقرأ.. تكتب.. تغني، لكن الصدمة بالنهاية هي بانقطاع الكهرباء والإنترنت البطيء.
بينما حسين(طالب هندسة معلوماتية- حمص)، يقول: كنا نحلم أن نكون مبرمجين ناجحين وروّاد أعمال، لكننا الآن نحلم فقط بالنجاة، الإنترنت ضعيف والمعدات غير موجودة، والفرص كلها خارج سوريا حتى التخرج لم يعد يعني شيئاً.
روان (٢٥ عاماً- خريجة كلية التربية ) أوضحت أنه في بداية دراستها كانت تحلم بمستقبل يناسب طموحها وقدراتها، بحثت كثيراً عن عمل في مجال دراستها، لكن للأسف الفرص قليلة والرواتب لا تكفي لمتطلبات الحياة الأساسية، وهكذا بدأت العمل في المنشآت الخاصة وخارج مجال ما ترغب وفقاً لدراستها لكي تستطيع أن تعيش في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وهكذا بدأ الحلم يتلاشى حتى وإن فكرت في السفر خارج البلاد، فالموضوع صعب أيضاً حسب رأيها.
ولكن أستطيع أن أقول: بعد عناء بدأ الحلم يتحقق وحصلت على وظيفة مناسبة لي، لذلك أقول لكل الطلاب الجامعيين.. علينا ألا نفقد الأمل لابد للحلم أن يتحقق.
حين تدفن الأحلام في صمت
رأي الآباء والأمهات لا يقل مرارةً.. لكنه غالباً مزيج من القلق والإحساس بالعجز.
أم ورد (45 عاماً- أم لثلاثة شباب في مرحلة الدراسة) تقول: نشأنا على أن العلم هو الطريق، وعلمنا أبناؤنا نفس القناعة، لكن ماذا نقول لهم اليوم شهاداتهم معلقة على الجدران والحياة معلقة على الانتظار.
أبو ياسر (57 عاماً- موظف سابق في مؤسسة حكومية) يعلق بأسى: أبنائي يسألونني ماذا أفعل بعد التخرج، وأنا لا أملك جواباً، قلبي ينكسر كل مرة أراهم عاجزين فيه حتى عن التفكير بمستقبل آمن.
وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع، توجهنا إلى الباحثة الاجتماعية شهد خزاعي، موضحة ما يعانيه الشباب السوري من أزمة حقيقية تبدأ من مقاعد الدراسة ولا تنتهي بعد التخرج، فالحصول على الشهادة الجامعية يتطلب جهداً كبيراً في ظل ظروف معيشية صعبة، لكن المفارقة أن هذه الشهادة لا تفتح أبواب العمل كما ينبغي، إذ يواجه الخريجون سوق عمل محدود، وفرصاً ضعيفة، ورواتب لا تكفي لتأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
هناك فجوة واضحة بين التعليم وسوق العمل، وغياب للسياسات التي تدعم الشباب أو تستثمر في طاقاتهم. كثير من الشباب يفكر بالهجرة بحثاً عن فرص لا يجدها في بلده. وأشارت إلى أن المطلوب اليوم هو إعادة النظر في السياسات التعليمية والاقتصادية، ودعم المشاريع الصغيرة، وتشجيع ريادة الأعمال، حتى يتحول الشباب من عبء إلى قوة فاعلة في بناء مستقبل البلاد.
وأخيراً نقول: إنها حكاية شعب لم يستسلم.. وجيل قرر ألا يكون الضحية إلى الأبد، بل أن يكون شاهداً وصانعاً لمستقبل أكثر عدلاً، فبين الألم الذي لم يعد غريباً، والأمل الذي لم يعد مستحيلاً، تعيش أجيال سوريا كما كانت دائماً، مثالاً على أن الحياة ممكنة ولو في قلب الرماد.