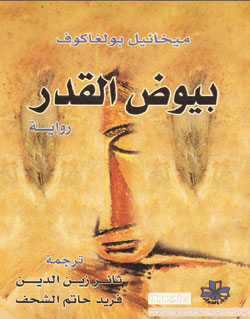الملحق الثقافي..د. ثائر زين الدين
منذ زمن طويل وأنا أطرح هذا السؤال على نفسي، وكنت أخصّ به السياسيين العرب في البداية؛ ولاسيما حين كنت أفرغ من قراءة نصوص أدبية جميلة، أنتجها مبدعون عرب فخلبت ألبابنا، وسلّطت الضوء على أمراض الواقع العربي المختلفة؛ ابتداءً من الجهل والأميّة والجوع والفقر، وصولاً إلى غياب الديمقراطيّة، دون أن تتنازل عن جماليات الكتابة. وأذكر أن هذا السؤال كان يتواتر بعد قراءة أعمال مثل: «ثلاثة وجوه لبغداد» و»سلطانة» لغالب هلسا، و»شرق المتوسط» و»مدن الملح» لعبد الرحمن منيف، و»الزيني بركات» لجمال الغيطاني، و»الوباء» و»التلال» لهاني الراهب، و»الانبهار» لرشيد بو جدرة، و»الرجل الذي عرف تهمته» للطيفة الزيات، و»مسك الغزال» لحنان الشيخ، و»فردوس الجنون» لأحمد يوسف داود وغيرها الكثير.
ولم يكن السؤال يقرع الأذن والضمير بعد قراءة الأعمال السرديّة فحسب، بل كان لا يقل ضجيجاً وحفراً في الوجدان حين أنتهي من قراءة شاعرٍ كأمل دنقل أو مظفّر النوّاب، ومحمود درويش وغيرهم..
وكنت أصل إلى قناعة شبه تامة مفادها أن السياسيين في وطننا العربي لا يقرؤون أدب شعوبهم!! والدليل هو النتائج والحالات والأزمات التي عاشتها تلك الشعوب، وكان بالإمكان تلافيها قبل وقوعها أو التخفيف من شرورها؛ لأن الأدب الذي نتحدّث عنه شخَّصَ تلك الحالات المرضيّة وقدّمها بجلاء، صحيحٌ أنه لم يضع حلولاً لها، وقد لا يكون هذا من مهمّته، لكنّه اختصر نصف الطريق..
وكنت أردّ كل ذلك إلى العلاقة الأبديّة بين السياسي والمثقف (أديباً كان أو مبدعاً بصورة عامة) وهي علاقة لا نستطيع أن نصفها بأنها «علاقة وئام»؟!
فبينما يتعامل السياسي مع الراهن والممكن والتكتيكي، ويسعى إلى قوننة الواقع من حوله وضبط حراكه وتوجيهه حيث يرغب نشداناً للهدوء والاستقرار والثبات؛ نرى الأديب الحقيقي يتعامل مع الحلم والمستقبل والطموح، وينزع إلى التمرد وتجاوز القوانين والأطر الجامدة، ينزع إلى مواجهة القبح وتسليع حياة الناس الروحيّة والاجتماعية، وينشد أولاً وأخيراً الحريّة والعدالة!
ولهذه الأسباب وغيرها ظلّت العلاقة بين السياسي والأديب، علاقة يشوبها الحذر أحياناً والريبة والخوف، وقد سعى السياسي دائماً إلى جذب الأديب نحوه، إلى ترغيبه وترهيبه رغبة في نقله من حقله إلى حقل آخر، وتوظيف إمكاناته وملكاته في خدمة مشروعه السياسي، واستطاع كثيراً أن يحقق ذلك، فرأينا عدداً غير قليل من المبدعين يسير في ركاب السياسيين ويخدم مشروعاتهم، سواء أدرك ذلك أم لا، ولاسيما حين تتفق رؤيا السياسي مع رؤيا الأديب في لحظاتٍ مصيريّةٍ محددة، لحظاتٍ ثوريّة على الأغلب كما رأينا عند بعض المبدعين الروس مثل ماياكوفسكي وسيرغي يسينين ومكسيم غوركي وآخرين.. حتى إذا اتضحت الصورة، وانقشع الضباب عن الدرب، انتبه المبدع إلى أنه خلق لغايات أخرى، فجاءت الصدمة مروعةً أحياناً، وانتهت بصاحبها إلى الانتحار أو القتل؟! وقد تكون نفس المبدع ضعيفة فيرضى بالمكتسبات التي يقدمها السياسي له، بل يصبح مدافعاً عن سلطته ويغض الطرف عن ممارساتها وأخطائها!
وربما لكل هذا وغيره رأينا السياسي العربي يـُعـْرِض عن قراءة مثل تلك الأعمال التي ذكرناها لشعوره أنه فوق الأديب، وأن هذا الثاني إنما هو خادمه أو على الأقل رهن أوامره، وإن قرأها سخر ممّا جاء فيها، أو عمل على محاسبه المبدع عوضاً عن الأخذ بآرائه وبالتالي تلافي النتائج التي قد يصل إليها المجتمع.
ثم انتبهت بعد ذلك أنني ظلمت السياسيين العرب؛ لأنهم ليسوا وحيدين في عدم اهتمامهم بأدب مبدعيهم، وكان ذلك حين قرأت «دكتور جيفاكو» لبوريس باسترناك، و»المعلم ومرغريتا» لميخائيل بولغاكوف، ثم أصبت بدهشةٍ بالغة حين ترجمت لميخائيل بولغاكوف نفسه بالتعاون مع صديقٍ أديب روايتي: «بيوض القدر» و»نشيد الشيطان»، وسبب دهشتي تلك هو قدرة هذا الأديب الكبير على رصد الواقع الروسي السوفييتي بعمق إبان ثورة 1917 وما بعدها، وتلمّس أخطاء الثورة المبكرة وبذور المشكلات القادمة، قبل أن تطرح ثمارها الخطيرة أواخر القرن الماضي وتؤدي إلى دمار بلدٍ عظيم!
لقد كتب بولغاكوف روايته «بيوض القدر» عام 1924، بعد أن ترك مهنة الطب وتفرّغ للإبداع الأدبي، وكان قد أنتج قبلها أعمالاً غير قليلة منها كتابه الطريف «مذكرات طبيب شاب»، وروايته «الحرس الأبيض».
«بيوض القدر» روايةُ سخريةٍ مرّة، وهجاءٍ مقذع لروح المغامرة غير المحسوبة، التي قادت السياسيين المتحمسين في السلطة السوفييتية، والمندسين فيها، ممّن سخّروا العلم والثقافة والمعرفة لغاياتٍ غبيّة، فإذا باكتشافٍ عظيم ٍ لأحد العلماء الروس العاملين في مجال عالم الحيوان يتحول على أيدي البيروقراطيين والمدعين إلى كارثة تعصف بالبلاد والطبيعة، عوضاً عن أن يستثمر لصالح الناس، الذين يندفعون إلى الشوارع في النهاية ولا ينجو منهم حتى العالم المكتشف «للشعاع الأحمر»؛ الغافل عن استثمار اكتشافه ذلك الاستثمار المدمّر!!
وقد حظيت «بيوض القدر» بإعجاب الكتّاب الكبار ومنهم مكسيم غوركي، الذي انتصر لها ولصاحبها، لكنها جوبهت بنقدٍ حادٍ من أعضاء الرابطة الروسيّة للكتّاب البروليتاريين وهي إحدى أهم التكتلات الأدبية والفنيّة في العشرينيات.
واتّهم بولغاكوف «بسوء النيّة»، وباتباع «مزاج ٍ برجوازي جديد» وما إلى ذلك.
والرواية الثانية التي ذكرتها هي «نشيد الشيطان»، وقد أنجزها أيضاً نهاية عام 1924، ولا تبتعد كثيراً عن سابقتها من حيث نقدها التهكّمي للأوضاع التي آلت إليها روسيا؛ فقد رسمت باقتدارٍ وعمق حالة الفوضى التي أصابت البلاد، وإحساس المواطن بالضياع والغربة، والخوف على المستقبل، ووصوله إلى مرحلة الانهيار، أمام عصبة من الأشخاص تعبث بكل شيء وتدمّر كل شيء لغايةٍ لا يدركها إلا «الشيطان»!
إن بطل العمل «كوروتكوف» أمين السر في مستودع أعواد الثقاب – الذي نزع من رأسه فكرة «تقلبات الدهر» وغرس عوضاً عنها ثقةً راسخة بأنه سيستمر في عمله هذا حتى نهاية الحياة على سطح الكوكب – وجد نفسه يعيش محنةً قلّ أن تحدث إلا في الأنظمة الشموليّة، أو المراحِلِ الانتقاليّة بين نظامٍ ونظام!
يجد كوروتكوف نفسه مطروداً من عملِهِ بحجة خطئهِ في كتابةِ اسم مديرهِ الجديد ولأن عينَهُ تورمت وهو يختبر علب الكبريت التي استلمها عوضاً عن مرتّبه الشهري. الشخصيّة التي تطرده – والتي أسماها المؤلّف «كلسونير» شخصية غريبة جداً؛ فيها من البشر شيء ومن الشياطين أشياء. إنها تحتل المؤسسة وتعبث بها وبموظّفيها، وحين يحاول كوروتكوف أن يفهم ما الذي يجري تبدأ متاعبُهُ؛ من سرقة وثائقِهِ الشخصيّة، إلى اكتشاف أن «كلسونير» وجماعته يديرونَ البلاد، ثُمَّ كلسونير هذا ليس إنساناً مثلنا، إنه قادرٌ على التحول إلى كل ما يخطر على بالك: ديك أبيض، طائر يخرج من ساعة الجدار، تنين، وقد يغوصُ في باطن الأرض تاركاً رائحة كبريت نفاذة، وهو قادرٌ مع مجموعته على ملاحقةِ كوروتكوف ودفعه إلى الجنون، لينتهي العمل – الذي يشبه كابوساً تراه ولا تستطيع الخروج منه – بمحاصرةِ الرجل، على سطح أحد أعلى المباني في موسكو، فيختار عندها أن يلقي بنفسه إلى الهاوية وهو يردّد «الموت لا العار» لكنّه حين يُسلم جسده للهواء يشعر أنه يطير إلى الأعلى نحو الشمس، ويواصلُ طيرانه حتى يُحس باصطدام تلك الكتلة الذهبية المضيئة برأسهِ، فيتوقف عن الإحساس بأي شيء!
إن «موضوعة الشيطان» هي إحدى الموضوعات المحببّة للروائي، ومن يقرأ «المعلم ومرغريتا» ستدهشه شخصيّة «فولند/ الشيطان» التي اضطلعتْ بالدور الأهم في العمل وكشفت تناقضات الواقع الحي وعيوبه، بما يشبه الواقعيّة السحرية، التي عرفتها أمريكا اللاتينيّة بعد ذلك بخمسين سنة تقريباً!
وأعتقدُ أن كبار قادة تلكَ المرحلة في روسيا لو انتبهوا إلى ما ضمّتهُ هذهِ الأعمال الأدبية وغيرها؛ أو لو أنهم تعاملوا معها بشيء من التواضع والاعتراف بأهميّة ودور الأديب لجنّبوا بلادهم وشعوبهم الكثير من المآسي والخيبات، التي تراكمت خلال ما لا يقل عن سبعين عاماً وأدّت كما رأينا إلى انهيار تجربةٍ حالمة هي الاتحاد السوفييتي!
وأخيراً أختمُ مقالتي الصغيرة هذهِ بحادثة يعرفها محبّو الأديب والشاعر الفرنسي الكبير فيكتور هيغو. تقول الحادثة إن هيغو عندما عاد من منفاه في لندن إلى باريس عام 1870 سألهُ الناس والكتّابُ عن سبب إبعادِ نابليون الثالث له عن وطنه كل هذا الزمن، والمسألةُ لا تتعدى الخلاف في الرؤيا السياسيّة، فأجابهم: «لن أفصح عن هذا الخلاف حتى لا أتهم بالادعاء والمكابرة، وإنْ كشفَ الحادثُ للرأي العام الفرنسي أن الأديب أكبر من السياسي؛ وأن كل الألقاب السياسيّة مهما علت تهتزّ أمام سطوة الكلمة!».
فيا أيها السياسيون في العالم أجمع اقرؤوا أعمال كتابكم وشعرائكم ولا تستهينوا بها وبهم!!
التاريخ: الثلاثاء2-4-2019
رقم العدد : 16946