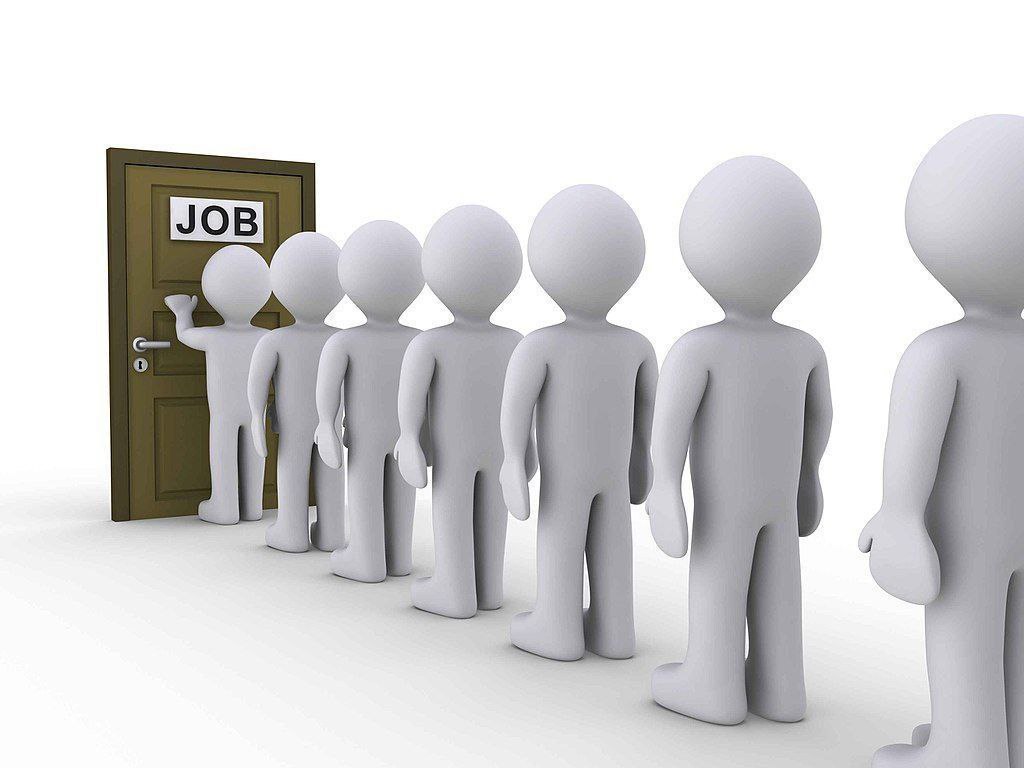الثورة ـ تحقيق: سنان سوادي:
عبر عقود تسللت البطالة المقنعة إلى المؤسسات والشركات العامة فسبّبتْ تضخماً في النفقات وتراجعاً في الإنتاج والنمو الاقتصادي، فالبطالة المقنّعة هي “مرض اجتماعي”، لأنها تكرّس مبدأ “الوظيفة من أجل الوظيفة”، بدلاً من “العمل من أجل الإنجاز”.
في هذا التحقيق نتعرف على تأثيرها على الإدارة والاقتصاد والمجتمع، وعلى الحلول المقترحة للحد من آثارها السلبية.

أخطر من البطالة الصريحة
تمثل البطالة المقنّعة ظاهرة اجتماعية مركّبة لا تقل خطورة عن البطالة الصريحة.
رئيسة قسم علم الاجتماع في جامعة اللاذقية الدكتورة ايفا خرما، ترى أن المواطن يبدو – ظاهرياً – موظفاً، لكنه عملياً مجرد رقم إداري، لا يُطلب منه إنتاج حقيقي، ولا يُمنح فرصة للإبداع أو المبادرة، فالفرد الذي يعيش هذه الحالة غالباً ما يشعر بالفراغ النفسي وفقدان القيمة الذاتية، لأن غياب الجدوى من العمل يولّد لديه إحساساً بالعجز، ويضعف دافعيته للإنجاز، ما ينعكس سلباً على صحته النفسية وعلى مفهومه للذات والنجاح.
وبحسب د.خرما، فإن البطالة المقنّعة تُضعف ثقافة العمل والانضباط والمسؤولية، وتؤدي إلى انتشار الاتكالية داخل المؤسسات، إذ يُكافأ الحضور الشكلي بدلاً من الكفاءة والإنتاج، وهذا يخلق بيئة عمل غير محفزة، تقتل روح المبادرة وتؤسس لثقافة “الراتب مقابل الوقت” لا “الراتب مقابل الجهد”.
ومن جهة أخرى، يسهم انتشار الوظائف الشكلية في إهدار الموارد البشرية والاقتصادية، إذ يشغل الأفراد مواقع لا يحتاجها المجتمع فعلاً، بينما تبقى الكفاءات الحقيقية بلا استثمار أو تقدير، وهكذا تصبح البطالة المقنّعة عائقاً أمام التنمية الاجتماعية، لأنها تُنتج جيلاً يفتقر إلى الدافع والإبداع.
وعن نظرة المجتمع لهذه الظاهرة، بيّنت د.خرما أنها تتراوح بين اللا مبالاة والسخرية، إذ يدرك الناس أن كثيراً من الوظائف ما هي إلا مظاهر شكلية تُخفي فراغاً تنظيمياً، وهنا يبرز السؤال الأخلاقي والاجتماعي: هل العمل مجرد حضورٍ في المكان، أم هو مساهمة في بناء المجتمع؟.

وظائف وهمية
وعن الفرق بين البطالة العامة والبطالة المقنّعة، يوضّح الخبير الاقتصادي، الدكتور رامز درويش لـ”الثورة” أن هناك خلطاً شائعاً بين البطالة العامة والبطالة المقنّعة، وهما ظاهرتان تختلفان في المضمون والأسباب والآثار الاقتصادية والاجتماعية.
فبينما تُعرّف البطالة بالمعنى التقليدي، بأنها عدم توفر فرص عمل حقيقية في المجتمع، فإن البطالة المقنّعة تمثل نوعاً مختلفاً وأكثر تعقيداً، لأنها تختبئ خلف وظائف وهمية وأدوار شكلية لا تُضيف أي قيمة إنتاجية.
وتشير إلى العاملين الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم، أو لا تحتاج إليهم المؤسسات فعلياً، وهؤلاء يتقاضون أجوراً دون أن يسهموا في الناتج الحقيقي، وسحبهم من سوق العمل لا يؤثر على الإنتاج، وهذا يؤدي إلى تضخم إداري وتشويه للمؤشرات الاقتصادية، وهدر للموارد، ورفع التكاليف التشغيلية، والأسوأ من ذلك أنها لا تُحتسب رسمياً ضمن نسب البطالة، لتبقى “غير مرئية” في الإحصاءات، لكنها حاضرة بقوة في الواقع.
سوء تخطيط وفساد إداري
ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم البطالة المقنّعة – بحسب د.درويش – سوء التخطيط في تقدير الاحتياجات من الموارد البشرية، إذ تُوضع خطط توظيف غير دقيقة لا تستند إلى دراسة واقعية لاحتياجات العمل الفعلية، ويتحمل المديرون المسؤولية الكبرى في ذلك، لأنهم المخولون بتحديد أعداد العاملين المناسبين ومؤهلاتهم وفق الهياكل التنظيمية.
كما أن تجاهل مبدأ “وضع الشخص المناسب في المكان المناسب” يسهم بشكل مباشر في خلق بطالة مقنّعة، فالتعيينات التي تتم بناءً على المجاملة أو العلاقات الشخصية لا على الكفاءة، تؤدي إلى وجود موظفين غير مؤهلين يشغلون مواقع حساسة، وتزداد المشكلة عندما تتحول المؤسسات إلى ساحات لتوظيف الأقارب والمعارف دون النظر إلى الخبرة أو المؤهل العلمي، فيصبح الجهاز الإداري عبئا على الاقتصاد.

انعكاسات سلبية
وللبطالة المقنّعة آثار سلبية على بيئة العمل، كونها تؤثر بشكل سلبي على الأداء العام والإنتاجية، إذ تنخفض الأرباح نتيجة وجود عمالة غير فعالة، وتُمنح الحوافز والمكافآت لغير المستحقين، ما يُضعف روح الإنتماء ويُعزز الشعور بالظلم برأي د. درويش. وعلى المستوى الاقتصادي، تتسبب البطالة المقنّعة بتشويه المؤشرات القومية، مثل الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي، فهي تُحدث تضخماً في النفقات التشغيلية مقابل إنتاجية منخفضة، ما يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي وتراجع القدرة التنافسية، ومع تراكم الخسائر، تجد المؤسسات نفسها عاجزة عن رفع الأجور أو حتى الاستمرار في دفعها، ما يفاقم الأزمات الاجتماعية والمالية.
إصلاح إداري
ورأى د. درويش أن معالجة هذه الظاهرة تحتاج إلى إصلاح إداري شامل يبدأ من محاربة الفساد، وتطبيق مبدأ الكفاءة والعدالة في التعيينات، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وإعادة هيكلة خطط الموارد البشرية وفق احتياجات فعلية مدروسة، بعيداً عن المجاملات والمحسوبيات.
وفي الجانب الاقتصادي، يلعب دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً أساسياً في امتصاص البطالة المقنّعة وتوفير فرص عمل حقيقية، فكل مشروع ناجح قادر على خلق وظائف منتجة تُسهم في تحريك عجلة النمو، وتقليل الاعتماد على التوظيف الشكلي.
وتتطلب مواجهة البطالة المقنّعة تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني، عبر سياسات واقعية توازن بين الكفاءة والعدالة، وتعيد الاعتبار لقيمة العمل والإنتاج، فالقضاء على هذه الظاهرة لا يعني فقط تحسين الأداء الإداري، بل إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

تهديد جهود التنمية
بدوره، أستاذ الاقتصاد في جامعة اللاذقية الدكتور علي ميا أكد أن البطالة المقنّعة آفة خطيرة، وهي واقع معاش وملموس في كل شركات ومؤسسات القطاع العام، ومع تعدد أسبابها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية المدمرة، التي تهدد جهود التنمية المستدامة، فإنه من الواجب اتخاذ كل السبل والإجراءات التي يمكن من خلالها اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها من خلال:
أولاً: إعادة النظر في كل الهياكل الإدارية والتنظيمية لهذه المؤسسات العامة، والعمل على إلغاء الوظائف والأعمال غير الضرورية، ودمج الأعمال والإدارات المتماثلة في أعمالها مع بعضها البعض.
ثانياً: إعادة تأهيل وتدوير العاملين في كل هذه المؤسسات بعد إخضاعهم للتدريب التحويلي الضروري الذي يُمكّن من إعادة توزيع هؤلاء العاملين وفقاً للاحتياجات الفعلية لكل مؤسسة، ففي الوقت التي تعاني فيه بعض المؤسسات الحكومية من فائض كبير في العمالة وظاهرة ما يسمى “عاملون بلا عمل”، أي إنهم يعملون اسماً لا فعلاً، ويتقاضون أجوراً دون أي إنتاجية محققة من عملهم، فإن هناك بالوقت ذاته مؤسسات أخرى تفتقر إلى الكوادر البشرية المؤهلة.
ثالثاً: إعادة تحليل وتوصيف كل الأعمال والوظائف لتحديد مهامها والشروط والمؤهلات اللازمة لشغلها، لأن ذلك هو السبيل الوحيد الذي يمكّن من وضع الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة لمؤهلاته.
رابعاً: وضع سياسات موضوعية لاختيار وتعيين العاملين في كل المؤسسات تعتمد على أسس الكفاءة والجدارة، والابتعاد عن سياسات الاعتماد في التوظيف على المحسوبيات والعلاقات الشخصية، التي كانت السبب الأكبر في نشوء البطالة المقنعة في كل شركات ومؤسسات قطاعنا العام.
خامساً: تحديث الخطط والمناهج الدرسية بما يؤهل الخريجين لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.
سادساً: تطوير التعليم المهني وتغير نظرة المجتمع الدونية للتعليم المهني والتقني، لاسيما أنه يشكل الدعامة الأساسية لأي نهوض صناعي واقتصادي، وتحقيق المعادلة التي تنص إلى وجوب وجود 50 خريجاً مهنياً مقابل خريج واحد جامعي، بينما لدينا وللأسف الشديد المعادلة معكوسة، ما يؤدي إلى نشوء البطالة السلوكية في مجتمعنا.
سابعاً: تهيئة الخريجين وتوجيههم نحو العمل في القطاع الخاص بشكل أكبر، ودراسة أسباب العزوف عن العمل فيه، ووضع الحلول الجذرية لتلك الأسباب.
ثامناً: تعزيز الشراكة مع جهات القطاع الخاص لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بما يتوافق مع احتياجاته الفعلية.
تاسعاً: تشجيع الاستثمار داخل المؤسسات الحكومية، ما يساعد في خلق فرص وظيفية ذات جدوى اقتصادية كبيرة تسهم بتدعيم الموارد الاقتصادية للحكومة.