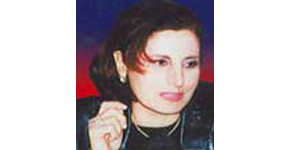في كل لقاء يسألها «كيف الحال ؟».
وفي كل مرة وبنفس الطريقة تقول «ماشي الحال».
غير أنها قررت أخيراً أن تخبره عن حالها الذي توقف في نقطة ثابتة منتظراً أن تغيره.
كانت تنوي ذلك فعلاً وكانت تريد أن تخبره عن الورد الذي تقطفه عن سور بيتها وتشمه لأن رائحته تشبه عطره الذي يبقى عالقاً في ذاكرتها طويلاً. لم تكن تتوقع أن الزمن التالي للعطر هو زمن الكورونا.. زمن الجدران المغلقة والموت الواقف على الأبواب.. والحسرة على زمن كانت تتأفف منه.
وقفت خلف النافذة وراحت تراقب النوافذ المغلقة والياسمين المتدلي على الأسوار.. لا أحد يقترب منه ولا أحد يسرقه.. فكرت أن تخترق الحجر المنزلي وتخالف القانون وتنزل لجمع الياسمين، ربما استطاعت أن ترسله إليه بطريقة من الطرق باعتبار الورد هو اللغة الأرقى والأكثر جرأة على التعبير والبوح، فقد يشرح الياسمين حالها ويخبره عن هذا الحال الحزين لأنها تريد أن تعترف له.
تراجعت عن قرارها.. ماذا ستعترف له ؟ ماذا ستقول؟.. كيف ستخبره بأنها تحبه وأنه لا يبرح خيالها.. فكرت أن تكتب رسالة إلكترونية له تشرح فيها كم هي تقدره.. ضحكت من نفسها – التقدير غير الحب – . طيب، تلمّح له بأنها اشتاقت له.. سيقول «وأنا كذلك اشتقت لك»، ثم ماذا بعد ؟ لا.. الحب يحتاج إلى أكثر من رسالة إلكترونية.. يحتاج إلى انتظار ولهفة للموعد.. ويحتاج إلى ارتباك ورجفة يد وهي تحمل القهوة وتندلق على البلوزة الملونة.. ثم الأسف والحروف المتقطعة، ثم النظرة الحزينة العميقة الواشية التي تفضح خفايا القلب.. وهنا لا يحتاج التعبير عن الحب إلى المطولات كما في الرسائل، ولا إلى النقط والفواصل والتشبيهات والمترادفات والاتكاء على أسماء روايات وكتاّب وأسئلة حول مضامين بعض القصص.. النظرة هي الرسالة الأقوى الفاضحة المعترفة التي لا تحتاج إلى تعابير كثيرة ولا إلى مفردات مجنحة.. لكنها تساءلت «معقول أنه لم يلاحظ حزنها وهو يخبرها بأنه سيسافر؟».
يومها قالت له «سأفتقدك».
لكنه رد بصوت رفيع «وأنا سأشتاق إلى البحر والكورنيش ولمة الأصحاب»، صدمها الجواب، ولكن ظنت أنه سيخجل من الرد المباشر، غير أنه لم يسافر بسبب أزمة كورونا.. توقف العالم.. توقفت المحطات وتوقف الحلم.. وحين رأته فرحت لأن الكورونا منعته من السفر، وإنه بإمكانها أن تلاقيه ذات صباح أو مساء على الكورنيش سارقاً بعض الوقت من الحجر المنزلي.
غير أنها لم تلاقيه أبداً.. كان يقول «أنا أطبق القوانين».
ضحكت وقالت «كنت سأقول لك شيئاً».
ابتسم وقال «قولي».. وبعد تردد طويل قالت هامسة وبصوت موجوع «إلى متى الكورونا ستمنع لقاءنا ؟.. ضحك وقال «مصر لا تبعد عن عاشق».
قالت له «يعني تعرف أني.. مثلاً..» ثم صمتت قليلاً وتابعت.. «بأني أحبك ؟».
تنهد ولم يعلق بكلمة واحدة.. ظلّ صامتاً يسمع أنفاسها المتلاحقة العجولة المتقطعة.. قالت: «خفت أن تسافر ولا تعرف بأني..» لم تكمل، وهو لم يسألها، بل ظل صامتاً مما زاد في حيرتها وقلقها، وبعد أن هدأت أنفاسها واستراحت كلماتها، قال لها بصوت بارد: «ها أنا لن أسافر، العالم كله أغلق في وجهي».
همست.. أنت عالمي.. تنهد بانزعاج وقال بصوت واضح: «ليتك لم تخبريني بحبك.. ليتك بقيت تلك الصديقة الغامضة الجميلة التي لا أعرف كيف أقرأ مشاعرها.. أهي مشاعر حب أم مشاعر صداقة وكفى ؟».
اهتز صوتها وشعرت أنها لم تجد التعبير، وحين أرادت أن تتابع، قال لها: «لا تضيفي شيئاً.. لكن سأعترف بأني فقدت صديقة غالية».
قالت: «وهل الحب يقتل الصداقة ؟».
رد بحزن.. «ولكن صداقتي لم تتطور إلى درجة الحب، لذلك ستتضرر صداقتنا لأنك ترينني بعين العاشقة وأنا لا أراك إلا بعين الصديقة.. وما بين النظرتين يمر زمن طويل حتى تلتقي النظرات وتتحول الصداقة إلى حب».
انغلقت سماعتان وهاتفان فعبر الزمن متهادياً بين وجع الحجر المنزلي وحجر البوح الأليم.
معاً على الطريق- أنيسة عبود