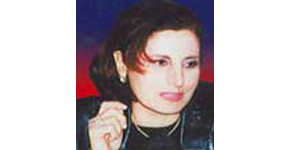ربما هو ورق الحور أو ورق شجر الأزدرخت الأصفر الذي تناثر أمامي بصمت بعد أن بلله المطر، هو الذي أخذني إلى دمشق وأجج حنيني، وتحديداً إلى نهر بردى قرب المعهد العالي للمسرح، حيث كنت أحب السير وحدي لأراقب النهر والعابرين والشجر الواقف بكل كبرياء وهو ينظر إلى قاسيون العظيم.
كنت أمشي وفي ذهني مجموعة كبيرة من الأفكار التي راحت تصعد قاسيون، وتنزل بردى، وتمشي بين الناس، وتأخذ من ملامحهم الصبر والتحدي والعنفوان.
نظرت حولي فرأيت دمشق كبيرة على قدر أحلامي وعظيمة مثل آمالي في المستقبل القادم الذي سيأتي قريباً جداً.
خُيِّل لي أن دمشق تمشي معي وهي تبتسم لي وتعاتبني، لأني أطلت الغياب.. ابتسامتها تشبه ابتسامة رقيقة واثقة تمنحك الشعور بأنك في بيتك، وأنه عليك أن تقول ما في قلبك بكل براءة وصدق وعفوية. لم يكن في قلبي سوى سورية وحكاياتها الأليمة التي طالت ودماؤها التي سالت كثيراً حتى ارتوت الأرض، ليأتي بعد ذلك بأسبوع الحجر الصحي وإغلاق دمشق وأبوابها السبعة على نهرها وشجرها وأحبابها فضلاً عن باقي المحافظات والمدن السورية بسبب جائحة الكورونا.. وكأنه كان ينقصنا نحن السوريين المعذبين فيروس كورونا لينهكنا أكثر ويوقف مشاريعنا ويؤثر في معيشتنا وفي الحياة في مجمل نواحيها. فانتابني شعور بأنني سجينة في فكرة ضيقة ولا حروف تنجدني، أو أنني أقنع نفسي بأن الكورونا لا تصيب السوريين الذين يناضلون في سبيل أرضهم وكرامتهم قرابة السنوات العشر، ولم يتخاذلوا..
خلال تلك السنوات كتبنا الكثير من الألم على ورق قد يمر عابراً مع الأيام، إلا أنه سيجد يوماً من يقرؤه في المستقبل، ليعرف كم دفع السوريون في سبيل عزة وحرية وطنهم. طال الحجر الصحي، وطال الغياب عن الشام. لم أعتد أن أفارقها كل هذه المدة الطويلة، فأنا كلما شعرت بفتور الدهشة واختلال الطاقة الأدبية أدرك أنه عليّ الذهاب إلى دمشق، لأستعيد طاقتي وحماستي للكتابة، فالذي مرّ علينا ليس بقليل نحن السوريين الذين صبرنا وصمدنا وتحدينا كل أشكال القهر الذي نزل علينا، سواء من الصديق والقريب أم من البعيد والغريب.. ولكن إنها سورية كما قال الرئيس بشار الأسد: بأنها لم تكن يوماً بمنأى عن أطماع الدول المتسلطة بحكم موقعها الجيوإستراتيجي ومواقفها ومبادئها الثابتة دفاعاً عن قضيتها والتمسك بهويتها العربية.
ازداد تدفق الأوراق الصفراء المتناثرة مع اشتداد هواء تشرين.. المطر يهطل بطيئاً ونحن نتحسر في الساحل على قطرة مطر. في دمشق نزل المطر وفي الجزيرة السورية الحبيبة نزل المطر.. وأنت يا بحر لم تحمل لنا الغيوم الممطرة بعد! أأنت والزمن علينا؟
ظلت الرياح بطيئة.. رائحة المطر بعيدة. رماد الغابات المحترقة مازال علقاً في الهواء. ينتابني حزن مفاجئ حين أتذكر الحريق. راقبته من نافذتي. نيران هائلة تصل الأرض بالسماء. الزيتون يستغيث.. والحجارة تستغيث.. تقصف الأشجار العالية وهي تهوي يشبه تقصف الروح.
ماذا يجري يا وطني؟ كيف يمكن لهذه الآلام أن تنتهي؟ الريح تشتد فجأة والنار تشتد والسماء تذرف لهبها وتنظر مع الناظرين. لم أكن يوماً في مثل هذا الهلع. لم يفزعني الرصاص ولا الصواريخ التي انفجرت في قريتي.. ولم ترهبني طائراتهم المسيرة التي قتلت العشرات في القرى القريبة. لكن للنار حكاية أخرى لا نعرف بدايتها ولا نهايتها.. الزيتون يكتب قصة العمر الذي ضاع والشربين ينوح على جذوره.. والعصافير ماتت في أعشاشها، لم تستطع أن تهرب.. وحده الزمن هرب من أصابع الفلاحين ومن معاولهم وقبورهم.. هو وحده الهارب ونحن الباقون لنعيدك أيها الزمن من الحريق الكبير كما يعود طائر الفينيق إلى بداية الاخضرار والزرع والعطاء، والدليل أن السيدة أسماء الأسد منذ أيام زارتك وتفقدت حجارتك المحروقة واشجارك الواقفة ودموعك اليابسة، ورأت بأم العين كيف صمد الفقراء، وصبر الفقراء وعاهدوها على الزرع والعمل والبناء، لتعود شجرة الزيتون والبرتقال والشربين خضراء شامخة كما يعود الأبطال من المعركة منتصرين رافعين راية المجد، فلنرفع راية الأمل مع سيدة الأمل والياسمين.
معاً على الطريق – أنيسة عبود