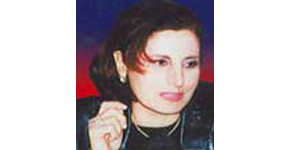بداية، لا أعرف لمن سأتوجه بمقالتي هذه.. فهي ليست مقالة أدبية وليست سياسية، بل هي من الناس ومن واقعهم المرير، فهل ستجد من يقرأها؟ حيث إن موضة القراءة صارت موضة قديمة، فضلاً عن أن الجريدة لم تعد توزع على مكاتب المديرين والمسؤولين ليكون لديهم علم وخبر بأحوال الناس، وخاصة في الريف الذي يعتمد على الزراعة وتربية الحيوانات الأليفة من أبقار وغنام ودواجن وغير ذلك.
ولعلّ الكثيرين لا يعرفون أن ثمن البقرة الواحدة وصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين ليرة سورية.. أي ما يعادل راتب خمسين موظفاً على الأقل. من هنا لا بدّ من الانتباه إلى الثروة الحيوانية، والاهتمام بها قبل أن تنقرض في سورية.. وذلك لأسباب كثيرة منها تهريب الأغنام وخاصة أغنام العواس إلى الخارج وبيعها بأسعار خيالية لجودة لحمها وصوفها المرغوب جداً في صناعة السجاد.
وإذا كانت الأغنام في سورية باتت قليلة وتربيتها مكلفة وتحتاج إلى مناطق مفتوحة وواسعة من أجل الرعي… فإن الأبقارعلى العكس، تعيش في بيئات متعددة ولا تحتاج إلى فضاء واسع إذا ما توافر لها العلف.. لذلك باتت الأبقار الحلوب هاجس المزارعين والريفيين ليسندوا قليلاً حيطان حياتهم المنهارة، إلا أن الأمر لم يكن سهلاً بعد غلاء الأعلاف.. والأبقار التي تناقص عددها بشكل كبير، مع ذلك استمر الريفيون -وخاصة في الجبال- حيث الحواكير الضيقة والمياه الشحيحة- بتربية الأبقار، غير أن كارثة كبيرة حلت بها منذ ىشهور، فقد انتشر وباء الجدري القاتل الذي أدى إلى نفوق عدد كبير من الأبقار لدرجة أن قرية مثل (معرّين) في ريف جبلة خسرت معظم أبقارها الحلوب وعجولها الصغيرة التي كانت تعدها لتكون بديلاً للبقرة الأم.
وقرية معرّين المشلوحة في آخر البرد والعطش والجوع مثلها مثل باقي القرى (الجردية) المنسية في جرود جبلية نائية لا يصلها المسؤول ولا يسكنها من يداه تطول.
لذلك لن يصل صوتها مهما صرخت، مع أنها سمعت صوت الوطن حين ناداها فلبت النداء، وأرسلت أبناءها الأعزاء ليدافعوا عن الوطن.. هذا الوطن حماه الفقراء أولاً، وحقهم على البلد أن يسمعهم ويسأل عنهم، فهم يعانون شظف العيش وانقطاع المياه لشهور، وأخاف أن يطول العطش لدهور وتعود قرانا إلى سابق فقرها وعطشها ونسيانها. وحتى تكتمل الصورة البائسة جاء الجراد (أو الجادوم) -كما سماه أهل القرية- أفواجاً أفواجاً إلى (خرايب سالم.. ومنطقة الشيخ حيدر بالضهر، ومعرّين، وباقي القرى القريبة) وحصد الأخضر واليابس، فتعرّت الأشجار من أوراقها، والحواكير الصغيرة من خضرتها، وبدا المنظر حزيناً موجعاً وكأن هذه القرى خارج خريطة الحياة، وخارج عين المسؤولين.
لقد خسر الريفيون أبناءهم في الحرب وأبقارهم من مرض الجدري وأشجارهم من الجادوم.. فانتشرالتحطيب في الغابات من أجل ربطة الخبز، حيث لا زراعة ولا مشاريع إنمائية ولا مشافي ولا مؤسسات تساعد على اجتياز مرحلة من أشدّ المراحل شقاءً وقهراً على السوريين، لدرجة أن أحد العجائز اتكأ على باب بيته الخاوي من الماء والكهرباء والهاتف ووسيلة المواصلات وهو ينظر إلى بقرته التي تموت أمام عينيه بسبب الوباء ودمعته تنزل على أخاديد وجهه النحيل كما لو أنه وجه منحوت من الصخر الصلب.. وبعد أن مسح دمعته ونظر إلى صورة ابنه الشهيد المعلقة على عمود الكهرباء قال: (أخاف من سفربرلك جديد).
وحتى لا يفاجئنا سفربرلك آخر لكون العقوبات الغربية علينا طويلة الأمد ونحن لم نتحضر لها ولم نؤسس لمواجهتها، ما قد يجعل مقالتي هذه تمر سهواً ولا يقرأها أحد.. غير أني أحمل بعض الأمل في أن تصل الرسالة إلى المسؤول المحتمل ويتم التعويض للفلاحين والمزارعين الذين فتكت بحيواناتهم الأمراض واجتاحتهم موجة الحرّ فقضت على محصول الزيتون والكرمة والليمون وباقي المحاصيل من تبغ وخضار وغير ذلك.
لذلك لابدّ من إقامة مشاريع إنمائية للريف المثقل بالشقاء لتساعده على البقاء في قريته وأرضه ولا يضطر للهجرة ليعمل في بيوت اللؤماء ويهدر كرامته في غير وطنه.. وكلنا يتذكر ما عاناه العامل السوري في لبنان وغير لبنان عبر عقود طويلة من القرن الماضي حتى الآن، فلماذا لا يكون في الريف النائي المشافي والمدارس النموذجية والمعامل الصغيرة والمؤسسات الخدمية التي تعمل بجدارة؟ وليس كمشاريع على الورق فقط كما هو الحال في كثير من الأحوال.
معاً على الطريق – أنيسة عبود