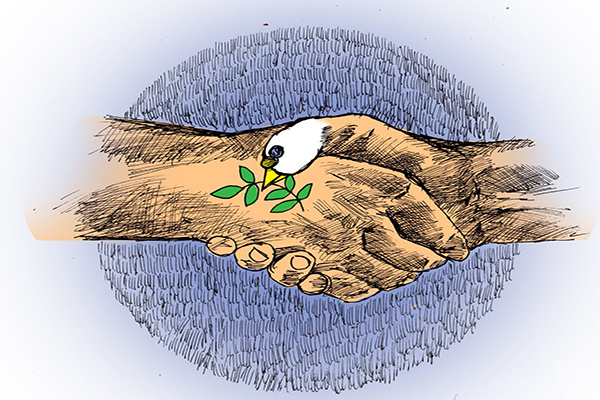الثورة – لينا شلهوب:
في زمن تتزايد فيه التحديات، وتتكاثر فيه الأزمات التي تهدد النسيج الاجتماعي، يصبح من الضروري أن نعود إلى الأساسيات الأخلاقية والروحية التي تشكّل العمود الفقري لأي مجتمع سليم.. ولعل أول تلك الأساسيات حرمة النفس الإنسانية، التي جاءت في كتاب الله تعالى: “وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا” [الإسراء: ٣٣].. إنّ هذه الآية الكريمة لا تمثّل مجرّد توجيه ديني، بل تؤسّس لقاعدة قانونية وأخلاقية وإنسانية يمكن أن نبني عليها مفهوم الدولة الحديثة.
 دم السوري على السوري حرام
دم السوري على السوري حرام
وفي هذا الشأن التقت صحيفة الثورة الباحث الإداري والقانوني وصفي أبو فخر، وقال: لقد أجمع علماء التفسير على أن النفس التي حرّم الله قتلها، لا تقتصر على المسلم فحسب، بل تشمل كل من دخل في ذمّة المجتمع المسلم، سواء كان ذمياً أم معاهداً أم مستأمناً، وإذا كان هذا هو حال غير المسلم في الدولة، فمن باب أولى أن تكون حرمة دم المسلم على المسلم أشد وأعظم، وعليه، فإن أي اعتداء على حياة الإنسان هو خرق مباشر للقيم الدينية والإنسانية، ناهيك عن كونه جريمة تهدّد أمن المجتمع واستقراره.
من يُنقذ العقد الاجتماعي؟
وأضاف أبو فخر، إذا ما انتقلنا من هذا الفهم الشرعي إلى الإطار المدني للدولة، نجد أن الدولة الحديثة تقوم على ثلاثة أركان: الأرض، الشعب، والسلطة، ولكن هذه الأركان لا تصمد إلا إذا قامت على أساس المصالح المشتركة والأهداف الجامعة، والتي تتجسّد في العقد الاجتماعي، هذا العقد ليس مجرد اتفاق سياسي، بل هو تعبير عن رغبة جماعية للعيش المشترك، في ظلّ احترام القانون، وتوزيع عادل للحقوق والواجبات، لافتاً إلى أنه عندما يستقوي مكوّن من مكونات المجتمع على الآخر، أو يلجأ إلى العنف لحسم الخلافات، فإننا نكون قد نسفنا هذا العقد الاجتماعي، وهدّدنا بنيان الدولة من أساسه، فالعنف الداخلي لا يولّد إلا العنف المضاد، ويؤدي إلى نزاعات أهلية لا تبقي ولا تذر، وقد رأينا في تجارب عديدة– عربية وغير عربية– كيف أن انفراط عقد المواطنة يقود إلى الحروب والانهيارات.
من فوهة البندقية إلى طاولة الحوار
وانطلاقاً من ذلك- بحسب رأي أبو فخر- تظهر مسؤولية النخب الفكرية والدينية والسياسية والثقافية، التي يفترض أن تلعب دور صمّام الأمان، فالنخبة ليست ترفاً فكرياً، بل ضرورة اجتماعية لتوجيه الوعي العام، وتحصين المجتمع من الانجرار وراء الدعوات الطائفية أو المناطقية أو الأيديولوجية الضيقة، وكلما كانت هذه النخب مدركة لدورها، ومتمثّلة لقيم المواطنة والتعدد والعدالة، ابتعد المجتمع عن مناطق الخطر.
واستطرد قائلاً: لا يمكن تجاهل الدور المتعاظم لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، التي تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى أدوات قوية للتأثير على الرأي العام، ومع أنها تمثّل فرصة للتثقيف والتواصل، إلا أنها أيضاً تُستغل بسهولة في بثّ الكراهية والشائعات والتحريض، ولاسيما حين تقع في أيدٍ غير مسؤولة أو تعمل وفق أجندات مشبوهة، ولهذا فإن الوعي الإعلامي لم يعد ترفاً، بل ضرورة ملحّة، ويجب أن يبدأ من الأسرة والمدرسة والمؤسسات التربوية والدينية، مشيراً إلى أن المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية، من المدارس إلى الجامعات، ومن المساجد إلى دور الثقافة، تملك قدرة هائلة على تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ مفهوم العيش المشترك، وحين تقوم هذه المؤسسات بدورها بوعي واستقلالية، فإنها تنتج مواطناً متوازناً، يرى في اختلاف الآخر ثراءً لا تهديداً، وفي التنوع ميزة لا نقمة.
لا غالب بين الإخوة
ولا يجب ألا ننسى أننا لا نعيش في عزلة، بل في عالم متشابك تتقاطع فيه المصالح وتتصادم فيه الإرادات، وقد أثبتت التجارب أن بعض القوى الخارجية لا تتردد في استثمار الانقسامات الداخلية لضرب استقرار الدول، وتحقيق مصالحها الخاصة، هذه القوى لا تحتاج إلى جيوش، بل إلى شرخ صغير في الجبهة الداخلية تنفذ منه، وغالباً ما تفعل ذلك عبر أدوات ناعمة كالإعلام، والتعليم، والدعم الموجّه لجماعات متطرفة أو تيارات مشككة في الدولة ومؤسساتها.
لهذا، فإن حصانة الداخل باتت خط الدفاع الأول، وكلما كان البيت الداخلي متماسكاً، صعب على العدو اختراقه، هذه الحصانة لا تبنى بالشعارات، بل بالممارسات الديمقراطية، وبناء دولة مدنية عادلة، تقوم على المواطنة الكاملة، وتضمن الحقوق للجميع دون تمييز.
تبدأ بكلمة.. وتنتهي بخراب وطن