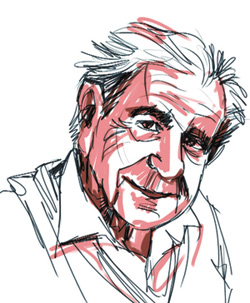ملحق ثقافي..حاتم حميد محسن :
كارل بوبر (1902-1994) فيلسوف نمساوي المولد اكتسب فيما بعد الجنسية البريطانية، اشتهر بمبدأ التكذيب أو التفنيد falsification principle(1) وهي طريقة العلوم في بيان زيف الفرضية العلمية، وبالتالي السماح بإيجاد فرضية أفضل. الفرضية يمكن بيان أنها زائفة حتى ولو بملاحظة مضادة واحدة. المثال الكلاسيكي على ذلك: افتراض «كل البط أبيض اللون» ثبت زيفه عندما لوحظ وجود بط أسود في أستراليا. لكن مساهمات بوبر العظمى للفلسفة هي في هجومه على التاريخية historicism(2) وهي الفكرة بأن التاريخ له أسلوب وهدف ونهاية، وأنه يتحرك بلا توقف نحو تلك الغاية طبقاً لقوانين معينة. بوبر درس بعناية التاريخية في كتابه (فقر التاريخية) الصادر عام 1957 وذهب بعيداً نحو الفلسفة السياسية والمجتمع في كتابه من جزأين (المجتمع المنفتح وأعداؤه، عام 1962). هذا الكتاب العالي الإتقان في الفلسفة السياسية، يمثل حالة دراسية أنموذجية في فن النقد، ويجسد دفاعاً حماسياً عن الديمقراطية الليبرالية. الأعداء الفلاسفة للمجتمع المنفتح، يرى بوبر، يدخل ضمنهم أفلاطون وهيغل وماركس.
الجزء الأول من الكتاب يتعلق بأفلاطون الذي رأى التاريخ ليس كتقدم وإنما دائري، وهو في تراجع عن العصر المثالي الذهبي. أفلاطون في جمهوريته حفز على النظام الاجتماعي المحكوم بالفلاسفة الملوك، المحميين بالنخب العسكرية وبمساندة طبقة كبيرة من العمال. بعض الخصائص الكريهة في نظامه الاجتماعي دفعت بوبر للهجوم عليه.
لكننا نهتم هنا بالجزء الثاني من كتاب بوبر الذي يناقش هيغل وماركس – خاصة ماركس، رغم أننا عند مناقشة ماركس والتاريخ لا يمكننا تجنب هيغل. في الحقيقة، كان ماركس قد تأثر بعمق بنظرية هيغل في التطور التاريخي. كلاهما اعتقد بأن التاريخ له غرض وقدر محتوم، وأن البشرية منذ البداية تحركت نحو مصيرها مندفعة بالصراع عبر سلسلة من المراحل المستمرة، كل مرحلة جديدة تأتي إلى الوجود عبر الصراع الناتج عن التناقضات أو النفي للمرحلة السابقة. وعندما تتحرك العملية التاريخية نحو الأمام، فإن الظروف تتحسن حتى يتم في النهاية حل التناقضات والوصول إلى نوع من الحرية.
ولكن رغم هذا التشابه، فإن النظريتين في تضاد مع بعضهما. نظرية هيغل في التاريخ التي عرضها في فينومولوجيا الروح هي تجريدية، تتكشف دائماً في الذهن. مختلف حركات الفكر أو العقائد تتصارع مع بعضها مجتمعة لتعطي دفعاً لظهور حركات جديدة تستمر بدورها بالصراع مع أخرى في عملية مستمرة تسمى الديالكتيك. تاريخ العالم هو انكشاف لما يسمى الذهن المجرد أو الروح من خلال الديالكتيك. بهذا المعنى، يعتمد العالم على الذهن، على الأفكار، وعليه تسمى نظرية هيغل بالمثالية الديالكتيكية. في أوج الحركة الديالكتيكية، يمارس الفرد التحرير من خلال علاقته مع الدولة التي يمجدها هيغل حين كتب «الدولة هي فكرة دينية كما تتجسد على الأرض»(محاضرات هيغل في فلسفة التاريخ، جزء 41). (3)
فكرة هيغل عن العملية التاريخية – ديالكتيك التناقضات – بدون شك أثّرت على ماركس وإنجلس. ذكر إنجلس في وصفه ديالكتيكية هيغل بأنها منطق جديد «لامع». لكن هذا المنطق فيه مشكلة. فكما ذكر ماركس «ليس وعي الناس منْ يقرر وجودهم، وانما وجودهم الاجتماعي هو من يقرر وعيهم»(نقد الاقتصاد السياسي، 1859).
نظرية ماركس، بالمقابل، تنكشف في عالم العمل، لذا هو يسميها المادية الديالكتيكية. صراعها هو بين الطبقات الاقتصادية، وأن ذروة حركتها تتمثل في بلوغ المجتمع اللاطبقي، وبالنهاية زوال الدولة. كلا الرجلين تأثرا بقوة بهيرقليطس الذي ذاع صيته في القرن الخامس قبل الميلاد. هيرقليطس قال بأن كل شيء في حالة من التدفق أو السيلان، يتغير إلى الأبد من خلال قوانين الطبيعة التي أسماها اللوغوس أو المنطق، يقوده التصادم بين الأضداد، ولكن بما أن هيرقليطس كان مادياً، لذا اعتبره ماركس مبشراً لماديته التاريخية.
بوبر حول ماركس
طوال تفحصه لماركس، اتّبع بوبر خطاً رفيعاً بين الإعجاب والخشية. هو يشعر بالاحترام تجاه ماركس، وجده صادقاً في عقيدته، حاد الإدراك في تحليلاته، متحمساً نحو المسحوقين. اعتقد بوبر أن ماركس ذاته «قام بمحاولة شريفة لتطبيق الطرق العقلانية على معظم المشاكل العاجلة للحياة الاجتماعية… أمانته وإخلاصه في بحثه عن الحقيقة ومصداقيته الفكرية ميّزته دائماً، نعتقد ومن خلال العديد من أتباع بوبر «… أن الماركسية هي التي أزعجت بوبر الذي أسماها «شكل التاريخية الأنقى والأكثر تطوراً والأكثر خطورة».
يرى بوبر أن الاختلاف الأساسي بين ماركس وغالبية المؤرخين (بمن فيهم هيغل) هو أن الآخرين رأوا التاريخ «ومصير الإنسان» يتقرر بالصراع بين الأمم. ماركس رأى التاريخ يتقرر بالصراع بين الطبقات. وكما ذكر ماركس «تاريخ جميع المجتمعات القائمة حتى الآن هو تاريخ الصراع الطبقي»(البيان الشيوعي). وكما يوضح بوبر «التفسير السببي الماركسي للتاريخ بما فيه الحروب القومية، هو أن مصلحة الطبقة يجب أن تأخذ مكان المصالح القومية المزعومة، والتي هي في الحقيقة فقط مصلحة الطبقة الحاكمة في الأمة».

طبقة المرء تتقرر بموقع المرء في نظام المجتمع لإنتاج السلع والخدمات. في الرأسمالية، البرجوازية هي من يملك وسائل الإنتاج، وبهذا هي من يصنع الطبقة الحاكمة. أما أولئك الذين يقومون حقاً بالعمل لإنتاج السلع والخدمات، فهم يصنعون الطبقة العاملة أو البروليتاريا. المالكون يُجبرون لزيادة الإنتاجية لكي يمكنهم التنافس، وبهذا هم مجبرون لإجبار العمال على إنتاج المزيد وبكلفة أقل، وهو ما يعني أجور عمل قليلة. هم أيضاً واعون تماماً بأن حريتهم تعتمد على انعتاقهم من العملية الإنتاجية. هم يمكنهم «شراء مقدار أكبر من الحرية فقط على حساب استعباد أناس آخرين»، كما يذكر بوبر. «فقط عبر جعل الآخرين يقومون بعمل قذر، يمكن للحكام أن يكونوا متحررين». ولكن مع استغلال العمال، هم يطورون وعياً طبقياً: نتذكّر أن ماركس اعتقد أن وجود الإنسان الاجتماعي يقرر وعيه. وبهذا فإن العمال يصبحون باستمرار واعين بأن حاجتهم للحرية تتقرر بموقعهم في وسائل الإنتاج. الحكام ملزمون باستعباد المحكومين، والمحكومون ملزمون بالكفاح ضد الحكام. «وهكذا دائماً، الحكام ومعهم المحكومون يقعون في الفخ، ويُجبرون على الصراع ضد آخر»، يوضح بوبر «إنها العبودية»، هو يضيف: «هذه الحتمية في الصراع… نبوءة تاريخية علمية». يلخص بوبر حتمية ماركس بالقول إن علاقات الطبقة التي تميز النظام الاجتماعي هي مستقلة عن رغبة الإنسان الفردية.
من المفزع أن كل هذا يبدو غير شخصي – أزيل من الواقع الوحشي للحياة اليومية. لكن ماركس رأى القسوة المميتة للرأسمالية في إنجلترا في أواسط القرن التاسع عشر. ماركس يعطي هنا أمثلة:
1- وليم وود شاب عمره 7 سنوات.. يأتي للعمل كل يوم من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء.. «15 ساعة من العمل لطفل بعمر سبع سنوات، شيء مدهش حسب تقرير رسمي للجنة استخدام الأطفال عام 1863».
2- ماريا آن والكلي شابة عملت دون توقف لمدة 26 ساعة ونصف، مع 60 من البنات الاخريات، 30 منهن في غرفة واحدة.. «استدعي الطبيب لاحقاً، شهد أمام الطبيب الشرعي بأن والكلي ماتت بسبب ساعات العمل الطويلة في غرفة عمل مزدحمة».
مفارقة الحرية
يربط بوبر الظروف المزرية للرأسمالية المنتصرة بشيوع فكرة الحرية الاقتصادية: «هذا الاستغلال المخزي جرى الدفاع عنه وبسخرية من جانب المنافقين الذين لجؤوا إلى مبدأ الحرية الإنسانية، لحقوق الإنسان في تقرير مصيره، وللدخول بحرية في أي عقد يراه مفضلاً لمصالحه».
مفارقة الحرية هو مفهوم يعود تاريخه إلى أفلاطون الذي يقول بوضوح إن «الحرية اللامحدودة تقود إلى لاحرية». بوبر طبق هذه المفارقة على نوعين من الحرية، هما الفيزيقية والاقتصادية. «الحرية في أي ميدان تهزم ذاتها إذا كانت غير محدودة»، هو يكتب: الحرية الفيزيقية غير المقيدة هي حرية البلطجيين في إيذاء الضعفاء. ولكن في النهاية، ذلك البلطجي سيأتي ضد بلطجي أقوى، وذلك البلطجي أيضاً سوف يواجه آخر وهكذا. لذا من الضروري للدولة أن تقيد الحرية الفردية في طرق قانونية معينة لحماية حرية كل شخص. السلطة الاقتصادية غير المقيدة تقود إلى نفس النتيجة في العالم الاقتصادي. «في دولة كهذه، القوي اقتصادياً حر في إيذاء الضعيف اقتصادياً، وسرقة حريته»، يكتب بوبر. فمثلاً، «أولئك الذين يمتلكون فائضاً من الطعام يمكنهم إجبار الآخرين الجياع على «عبودية مقبولة «بشكل حر». لذا من الضروري أيضاً للحكومة أن تحمي الضعفاء اقتصادياً.
يجادل بوبر أن الدولة يمكن أن تبني مؤسسات لتوفير هذه الحماية من خلال الوسائل القانونية. هو سمى هذه العملية «الهندسة الاجتماعية التدريجية»piecemeal social engineering(4). ماركس اعتبر السياسة والنظام القانوني خادماً للطبقة الحاكمة. هو آمن بأن الأنظمة السياسية البرجوازية أنكرت الحريات الأساسية للعمال والفقراء. ورغم أنهم جرى التعبير عنهم في لغة العدالة والحرية، لكن هذا كان مجرد ديكور خارجي. بوبر في وصفه عقيدة ماركس في هذا، كتب «هذا يبين أن الاستغلال ليس مجرد سرقة. إنه لا يمكن منعه فقط بالوسائل القانونية». بالنسبة إلى ماركس، الخيار الوحيد هو الثورة.
طبقاً للتاريخية الاقتصادية لماركس، النظام الاجتماعي لفترة تاريخية معينة يجب أن يزيل نفسه لينتج الفترة التاريخية القادمة. هذا يبين كيف أن الإقطاعية أنتجت الرأسمالية. الرأسمالية بدورها، تحتوي على بذور فنائها. تلك البذور توجد في ظروف الإنتاج. في كتاب رأس المال، ادّعى ماركس أن هناك تركيزاً متزايداً للثروة في أيدي القلة، وزيادة مماثلة في شقاء وتعاسة الطبقة العاملة المتزايدة. هذه أول خطوة من ثلاث خطوات في نبوءة ماركس بالثورة. هذه النزعة ستؤدي إلى الخطوة الثانية، محتوية على نتيجتين. كما يوضح بوبر حول نظرية ماركس: «كل الطبقات ما عدا البرجوازية الحاكمة الصغيرة والطبقة الكبيرة العاملة المستغلة ملزمة لتختفي أو لتصبح بلا أهمية». وأيضاً، «التوتر بين هاتين الطبقتين يجب أن يقود إلى ثورة اجتماعية» من خلال الصراع بين المالكين والعمال. أخيراً، في الخطوة الثالثة، العمال سيبرزون كمنتصرين على المالكين ويؤسسون ما يسميه ماركس ديكتاتورية البروليتاريا. بالنسبة إلى ماركس هذه الديكتاتورية ضرورية للدفاع ضد الثورة المضادة ولخلق المجتمع اللاطبقي.
اعتقد ماركس أن هذه العملية التاريخية حتمية. هذه التاريخية وجدها بوبر خطيرة، ومن هنا هو فصل نفسه عن ماركس. بوبر بوضوح شجع مفارقة الحرية لمواجهة الشروط الضرورية لثورة ماركس الحتمية:
«نحن يجب أن نبني مؤسسات اجتماعية، تُفرض بسلطة الدولة، لحماية الضعفاء اقتصادياً من الاقوياء اقتصادياً.. يجب أن نطالب بأن الرأسمالية غير المقيدة تسمح بالتدخل الاقتصادي. وهذا بالضبط ما حدث. النظام الاقتصادي الذي وصفه وانتقده ماركس لم يعد موجوداً في أي مكان».
يعطي بوبر أمثلة لما حدث في تحديد الحرية المطلقة للسوق مثلما كان أيام ماركس: تحديد ساعات العمل، الحماية ضد المرض والعجز والبطالة والضرائب التصاعدية، وظهور اتحادات العمال وغيرها. يذكر بوبر أن ماركس «لم يستوعب أبداً مفارقة الحرية، وهو لم يفهم أبداً الوظيفة التي يمكن لسلطة الدولة تأديتها في خدمة الحرية والإنسانية». يجب التأكيد أن بوبر لم يكن ساذجاً فيما يتعلق بسلطة الدولة وإمكانية الاستبداد. «تدخّل الدولة»، هو يكتب «يجب أن يقتصر على ما هو ضروري لحماية الحرية». باطلاع تام على سيكولوجيا الإنسان، شدد بوبر على أهمية السيطرة على المسيطرين. في الحقيقة، معظم الدول الغربية أسست إطارا قانونياً للفصل بين السلطات لتحديد سلطة الدولة بالإضافة إلى الحرية المطلقة للسوق.
نهاية التاريخية
سبب فشل نبوءة ماركس «يكمن كلياً في فقر التاريخية» يكتب بوبر: «في أبسط الحقائق حتى لو نلاحظ اليوم ما يبدو من نزعة تاريخية، نحن لا نعلم أنها سيكون لها نفس المظهر غداً». بوبر ذكر أيضاً أن الناس عندما يتحدثون عن تاريخ البشرية «ما يعنونه وما تعلموه في المدرسة هو تاريخ السلطة السياسية. لا وجود لتاريخ البشرية، هناك فقط أعداد لامتناهية من التواريخ… وأحد هذه التواريخ هو تاريخ السلطة السياسية. هذا التاريخ رُفع إلى مستوى تاريخ العالم. لكن هذا جريمة ضد كل تصور لائق للبشرية.. بالنسبة إلى تاريخ السلطة السياسية لا شيء عدا تاريخ الجريمة الدولية والقتل الواسع». لكي يوضح هذا يستشهد بوبر بالثورة الروسية وتأسيسها دولة صناعية باستخدام العمل الإجباري.
في نهاية المجتمع المنفتح وأعدائه، يعرض بوبر مرة أخرى غموضه نحو ماركس. «ماركس أوهم الناس الأذكياء ليعتقدوا بأن النبوءة التاريخية هي الطريقة العلمية في حل المشاكل الاجتماعية». مع ذلك، هو يسمي عمل ماركس «نظاماً فلسفياً فخماً، مقارناً أو أرقى من الأنظمة الكلية لأفلاطون وهيغل. ماركس كان آخر العظام من مؤسسي الأنظمة الكلية. نحن يجب أن نحرص على تركه هناك، ولا نستبدله بنظام آخر عظيم».
وهنا يجب ذكر ملاحظتين. أولاً، أن بوبر الذي مات عام 1994 ربما سيشعر بالقلق من التصاعد الأخير للقومية المتشددة في أوروبا والولايات المتحدة، وأيضاً سيلوم الفجوة الواسعة بين الأغنياء والفقراء. كلاهما يعزز انتعاشاً مفاجئاً للماركسية أو أنظمة شمولية أخرى، وهو موقف سيواجهه بوبر بمزيد من الهندسة الاجتماعية المتدرجة.
أخيراً، ملاحظة بشأن هيغل وماركس. الفلاسفة الحديثون أحياناً يبحثون عن دعم من اليونان القديمة لإعطاء نظرياتهم بريق الحكمة القديمة. هيغل وماركس كلاهما وجد ضالته في هيرقليطس. هيغل كان فخوراً به :»لم توجد فرضية لهرقليطس لم أتبنّاها في منطقي.. كل الأشياء تمر طبقاً للصراع»، بينما ماركس اعتبره سبّاقاً في ماديته الديالكتيكية للتاريخ. وكما ذكر الفيلسوف وليم ساخان في تاريخ الفلسفة 1968: «هرقليطس اعتبر العالم كنظام يتغير بلا توقف، لا يكتمل ولا ينتهي أبداً في بلوغ أهدافه أو التوقف في حالة من الكمال».
التاريخ: 2-7 -2019
رقم العدد : 17014