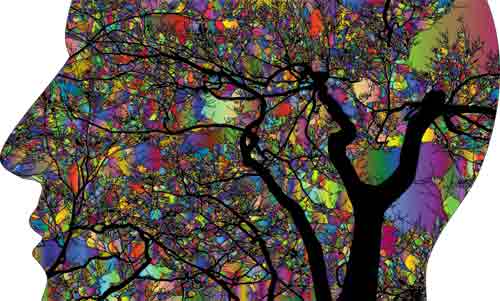الملحق الثقافي:ثراء الرومي:
ثمّة حاسّةٍ سابعة، لم يرد ذكرها على ألسنة العلماء والباحثين. إنّها حاسّة الحنين التي تجعلني أحمل جرّتي وأمضي إلى نبع الذّكريات.. أغرف أوّل رشفةٍ أستعيد معها ملامح ماضٍ جميل عشناه نحن -جيل السّبعينيّات والثّمانينيّات- بحلوه ومرّه، ورسمَ لنا ملامح حياة وطموحاتٍ، في زمنٍ لم تكن الحياة فيه يسيرةً أبداً، ولكن كان فيها لكلّ شيءٍ، نكهة أذابتها التّكنولوجيا اليوم.
أغترفُ بضعة من تلك الذّكريات، لأتذكّر عباراتٍ من مسرحيّاتٍ محلّيّة وعربيّة، حفظناها عن ظهر قلب، لكثرة ما حضرناها وباتت ثقافة مجتمعيّة سائدة، إذ لا تزال حتّى الآن منبع تندّر وفكاهة، نربطه بمواقفٍ حياتيّة يكفي لأحدٍ منّا، أن يذكر معها ثيمة أو عبارة من هذه المسرحيّة أو تلك، لنضحك من الأعماق.
لن أدّعي أنّني من مناهضي هذا التّطوّر التّكنولوجيّ المعاصر، فأنا أوّل المستفيدات منه على أكثر من صعيد، ولكنّ زحفه الممنهج إلى العقول، يستدعي وقفة طويلة، وتأمّلاً أطول..
ما دفعني للخوض في هذا الموضوع، جلسة حلّقت فيها فكريّاً وروحيّاً، مع إحدى صديقاتي المقرّبات، وشاركتنا جلستنا ابنتها الجامعيّة اليافعة، وقد تفاجأتُ بثقافةٍ جميلة تتزيّن بها تلك الشّابّة، وهي تذكر لي أسماء أعلام من الكتّاب الذين تقرأ لهم، أمثال حنّا مينا ونجيب محفوظ، وتحدّثني عن المسرح بعشقٍ وشغفٍ نادرين، مع دعوةٍ صادقة لمشاركتها وأمّها، حضور مسرحيّات ستعرض لاحقاً، على مسارح دمشق، إن سنحت لي الفرصة.
ما أجمل ما زرعته تلك الأمّ في ابنتها!.. فما أثار إعجابي وعجبي فعلاً، هو أنّ فتاة في زمنِ التسطّح الفكريّ، لديها هذا العمق المعرفيّ النّادر، والشّغف الذي لا يضاهى.
فتاةٌ أخرى أصغر منها بسنواتٍ قليلة، لفتتني فصاحتها وبلاغة مفرداتها، كما لفتني اهتمام شاب بعمرٍ مماثل بالمطالعة، عبر قدومه المتكرّر إلى مكتبة المركز الثّقافيّ في المنطقة، من أجلِ استعارة كتابٍ تلو الكتاب.
هؤلاء الرّائعون، الواعدون، المتفائلون.. يمثّلون ظاهرة غريبة في زمنٍ عزّ فيه إيجاد من يلقي بالاً لمقالٍ أو كتاب، أو مجرّد سطورٍ إبداعيّة قصيرة، تحت أيّ مسمّى. فمعظم الشّبّان والشّابّات في هذه الأيام، لا يصرفون أبصارهم عن شاشاتهم البلهاء، حتّى أثناء عبور الشّارع، أو تبادل حديثٍ في جلسة جماعيّة، يتحكّم بمحاورها كائنٌ رقميّ ذو سحرٍ غريب، يُشعرك بأنه يسري بين أيدي كلّ الجالسين.
بين هاتين الصّورتين المتناقضتين، يعود بي الحنين مُلحّاً، إلى زمنٍ كان أثمن ما يُقدّم لي فيه من الهدايا، كتاب أو ومضة تشجيعٍ من أهلي أو من كادر مدرستي.. زمنٌ كان المدرّسون فيه، لا يدّخرون جهداً لغرس بذور الإبداع فينا، حتى في الدّقائق القليلة المتبقّية من الحصّة الدّراسيّة.. ولا تغيب عن ذهني في هذا المقام، مدرّسة مادّة الاجتماعيّات التي كانت تكرّم الطّلّاب المتفوّقين، عبر إهداءِ كتبٍ شيّقة، من سلاسل روائيّة تاريخيّة، لا زلت أحتفظ بأحدها في مكتبتي، ويثير في نفسي كوامن فرح نادر.. تلك المدرّسة حملت ذات مرّة، مجلّةً نُشرَت لي فيها قصيدة، ومضت تطلب من كلّ شعبة تدخل إليها، أن يصفّقوا غيابيّاً للطّالبة المبدعة..
وثمّة مدرّسٍ، رسمَ لي جغرافيا إبداعيّة، كنت بحاجةٍ ماسّة إليها، حين كسر عندي رهاب كتابة القصيدة الموزونة، على بحور الشّعر العربيّ، رغم تهيّبي الكبير منه، بل وأكّد لي أنّني قادرة على ذلك، وأدين له بهذا الفضل ما حييت، ومن محاسن الصّدف، أنّه كان مدرّس مادّة اجتماعيّات أيضاً.
ولن أنسى أبداً فضل من درّسوني اللّغة العربيّة، فمنهم من شدّ على يدي، ومنهم من فتح لي بوّابة مكتبته، لأنهل منها ما يطيب لي من الكتب التي أثرت مخيّلتي وذخيرتي اللّغويّة، وسيبقى ذكره خالداً، وقد غيّبه الموت.
لعلّ في هذا الاستعراض، لماضٍ يشتعل في القلب الحنين إليه، دعوة خالصة لإحيائه بشتّى السّبل.. ولا شكّ أنّ كلّ جيل جديد، فيه من يحملون راية الإبداع وإن قلّ عددهم، ومن المؤكّد أنّه لا زال هنالك، المدرّس أو المدرّسة الأنموذج في رعاية المواهب، وإنارة مشاعل النّور لها، مهما مرّ من الزّمن، ومهما اختلفت أو تقلّبت ظروف الحياة.
إنّها رسالة إنسانيّة سامية، تقع على عاتق الأسرة بالدّرجة الأولى، بما تغرسه في نفوس أطفالها، وبما يحدّد ملامح نشأتهم، وأيضاً على عاتق المدرسة، بكلّ كوادرها، مهما اختلفت الاختصاصات وتشعّبت الاهتمامات.
بوجود أسرة تبني، ومدرسةٍ تتبنّى وترمّم ما أفسدته ظروف الحرب، سيكتمل بناء الإنسان.. سيكتمل رغماً عن كلِّ من لا يريد لهذا الاكتمال أن يتمّ.. سيكتمل مهما قست الظروف عليه، ومهما استُهدف وعيه وفكره وطموحه وحلمه، بل وحاضره ومستقبله..
التاريخ: الثلاثاء27-7-2021
رقم العدد :1056