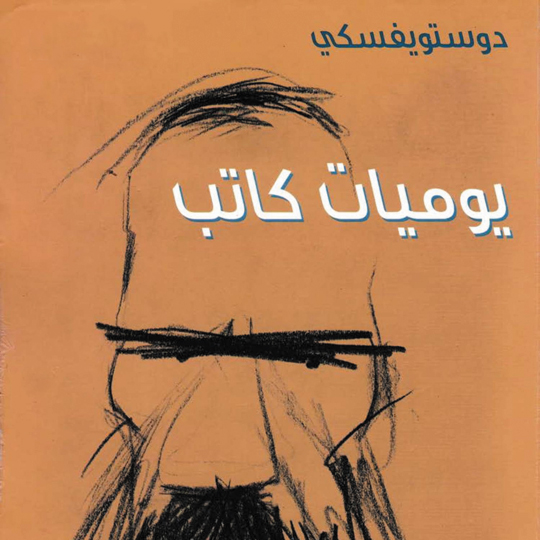الملحق الثقافي – ترجمة: ثائر زين الدين:
تأليف: دوستويفسكي – يوميات الكاتب: شباط 1876
كنتُ للتو قد كتبتُ في عدد كانون الثاني من «دنيفينك»، إن شعبنا بعامته أميل لأن يكون فظّاً وجلفاً وجاهلاً، ومنقاداً للظلمةِ والفساد، بل بربرياً أيضاً…
ولم ألبث أن قرأتُ مقالةً في «براتسكوي بوموتشي»، «وهي مجموعة أو دوريّة، تصدر عن اللجنة السلافية لدعم المناضلين في سبيل حُريّة السلافيين» للكاتب الخالد الذكر، الذي أحبّه الروس جميعاً، المرحوم قسطنطين أكساكوف ، يمتدح فيها الشعب الروسي أنّه متنوّر منذُ غابر الأزمان، ومتعلّم ومثقّف ومهذّب في تعامُلِهِ…
ماذا إذن؟ هل أزعجني اختلافُ الرأي مع قسطنطين أكساكوف؟ إطلاقاً! فأنا أشاطره رأيه، وأحسُّ به، بل وأتحمّس له! ومع ذلك فثمّة تناقض… أو لنقل: اختلافٌ يمكن تفسيره عندما نتعلّم كيف نستنبط الجمال الساكن داخل كل إنسان روسي، ونستخرجه من إطار الهمجيّة الدخيلة عليه!.
عاش الشعبُ الرّوسي ظروفاً عسيرة عبر مراحل تاريخه كافة تقريباً، وكان هذا الشعب خلالها مفسداً ومستسلماً للفساد، ومضللاً ومعذّباً… ومع ذلك فقد عاشَ محافظاً على جمالِ شخصه فحسب، بل حفظ جمال أسلوبِهِ في الحياة والعيش… وكل صديقٍ صدوقٍ للإنسانيّة، أو كلّ من خفق قلبه ولو مرّة واحدة بمعاناة الشعوب يستطيع أن يتفهّم هذا الشعب، وأن يصفح عن هذه القذارة الداخلية المتكوّمة حوله، والمطبقة عليه، بل ويستطيع أن يستكشف معدنه الماسي وسط هذهِ القذارة!
أعيدُ: لا تحكموا على الشعب الروسي من خلال الرذائل التي غالباً ما يرتكبها، ولكن من خلال أفكارِهِ العظيمة التي يفكر بها دوماً, وهو في حمأة الرذيلة! وليس جميع الناس خاطئين… بالعكس… بين هؤلاء أشخاص مستنيرون، بل يضيئون الدرب لنا جميعاً… ولديّ يقينٌ أعمى أنه ليس من بين أفراد الشعب الروسي شخصٌ لئيمٌ أو سافل أو شرير إلا ويعلم أنه كذلك! في الوقت نفسه الذي لا يعترف فيه الآخرونَ بخطاياهم، بل يطرون عليها، ويشيدونَ بها، ويؤكدّون أنها الاستقامة بعينها… بل وأنها نور الحضارة!.
لا تحكموا على شعبنا من خلالِ ما هو عليهِ الآن، بل من خلال ما يتمنّى أن يكونَه! فمبادئهُ قويّة ونيّرة… وهي التي أنقذتهُ في عصور العذاب، وهي التي نمت في روحه، ووهبتهُ النزاهة وصفاء القلب، وتفتّح العقل، وسعة الأفق…في تناغمٍ جميلٍ وجذّاب، وإذا كان في هذا شيءٌ من الدناءة، فإن الإنسان أوّل من يحس بالغم والحسرة، ويؤمن بأنها وسوسة شيطان مؤقّتة.. وأن الظلام سوفَ ينقشع.. ويحل محلّه نورٌ خالد في وقتٍ ما!.
لن أسترسل في استذكار رموزنا الأدبية العليا عبر التاريخ، مثل سيرغييف ، وفيودسيف بتشيرسكي ، أو حتى تيخون زادونسكي ، وبالمناسبة نحن لا نعرف الكثير عن تيخون زادونسكي، ولعلّنالا نحاسب أنفسنا أصلاً لأننا لم نسعَ لقراءة هذه الرموز. صدقوني أيها السادة كنتم ستعرفون أشياء رائعة لو أنكم قرأتموها.
لا بأس أن أعود إلى روائع أدبنا الروسي… فهي مُستقاة من روح شعبنا … ابتداءً من «بيلكين» الوديع البسيط الذي أبدعه «بوشكين»… وبوشكين منحنا أجمل ما لدينا من أدب..وتوجّهَ إلى شعبنا منذُ باكورة أعماله.. كان إنساناً استثنائيّاً… مُدهشاً، فاجأنا دوماً بمفرداتٍ وموضوعات فريدة تجعلنا نتساءل: هل هو معجزة؟ أم أنها العَظَمة الاستثنائيّة للعباقرة؟! لدرجة أننا ما زلنا عاجزين عن إيفائها حقّها الثمين حتى اليوم!!.
لن أُذكّر بنماذج الأبطال الشعبيين الذين ظهروا في زماننا…تذكّروا «أُبلوموف» تذكّروا «عش النبلاء» لتورغينيف، تذكّروا غونتشاروف العظيم وتورغينيف الخالد عبر العصور… فقد تواصلوا جميعاً مع الشعب ولامسوا حياتَه فمنحتهم زخماً غير عادي، اقتبسوا من الشعب النقاوة والدماثة وجمال الروح وسعة العقل… وكل الصفات الجميلة التي وقفت بالمرصاد للجانب الآخر الدخيل المظلم والمستبد… لا تعجبوا كيفَ بدأتُ الحديث هكذا فجأةً عن الأدب الروسي، فالفضل يعودُ بالذات لهذا الأدب برمّته، بأفضل أعلامِه، بطبقتنا المثقّفة التي انحنت أمام صدق هذا الشعب واعتَرفَت بعظمةِ رموزهِ الشعبيّة، التي أجبرتْهُ أن يتخذها نماذجَ يحتذى حذوها، وأظن أنها أثّرت فيه بذوقها الفني الرفيع، أكثر من إرادتها الخيّرة.
يكفي! لعلّي أسهبتُ في الحديث عن الأدب، لكنني أردتُ الحديث عنه في معرضِ حديثي عن الشعب فحسب.
كيف نرى نحن الناس؟! كيف نفهم الشعب؟ هذا هو السؤال المهم في اللحظة الراهنة، وهذهِ هي المعضلة العملية، التي يكادُ يتلخّصُ وفقها سيرُ الأمور في المستقبل، فمفهوم الشعب أو «الناس» مازال حتى الآن مجرّد نظريّة! وما زلنا نتعامل مع الناس – نحن الذين نحبّهم – كما كنا نتعامل مع نظرية! ويتراءى لي أننا جميعاً لا نحب الناس كما هم في حقيقة الحال، وإنما كما يتصورهم كل منّا في مخيّلته!… والأدهى من ذلك أنّه لو ظهرَ شعبنا الروسي على صورة لا تتوافق مع ما يتصوّرُهُ كلٌّ منا عنه فإننا جميعاً، وعلى الرغم من الحبّ الذي نكنّهُ لَهُ سوفَ نبتعدُ عنه دون أدنى أسف، والكلام هنا عن الجميع دون استثناء من أحد، حتى الموالين للنزعة السلافيّة، بل لعلّ الكلام يعنيهم أكثر من الآخرين.
وفيما يتعلّق بي شخصيّاً، فَسأُفردُ قناعتي بوضوح وأقول: لسنا رائعين أو مثاليين، إلى الحدّ الذي يجعلنا نضع من أنفسنا مثلاً أعلى للناس، فنطالبهم أن يكونوا مثلنا تماماً، ولا تعجبوا هنا من أن يُنظرَ للأمر من زاويةٍ محدودةٍ كهذه، إذ إنّهُ لم يوضع من قبلُ إلّا على هذه الصيغة: «من الأفضل: نحنُ أم الشعب؟!»أو «هل على الشعب أن يسير خلفَ رايتنا، أم علينا أن نسير خلفَ الشعب؟!» هذا ما يطرحُهُ الجميع الآن! فما هو جواب من يحملُ في رأسه ولو ذرّة من التفكير المنطقي، ومَن يُعنى حقاً في سريرتِهِ بالشأن العام؟! أنا أجيب بصدقٍ وصراحة: علينا نحنُ أن ننحني أمام هذا الشعب، ونأمَلَ منه كل خير شكلاً ومضموناً، نحنُ الذين علينا أن ننحني كالأطفال الشُّطّار أمام صدق الناس وأن نعترف به كحقيقة، وألّا نساوم على شعبنا مقابل أي ثمن… فلا شيء يُعادل فرحة الالتحام بهؤلاء الناس، بكيانهم.. بتفكيرهم، بمساكنهم الرّوسيّة، التي بالكاد تستعيد رونقها وأصالتها لتكون لنا مأثرةً عظيمة، ولكن من ناحية أخرى: سوفَ ننحني أمامهم بشرطٍ واحد: أن يأخذوا منا الكثير مما نحملُهُ من أفكار، فنحنُ نستطيع أن نتلاشى تماماً أمام الشعب… وإذا لم يحصل هذا، فإننا سنموتُ كلينا، كلٌّ على حدة.. ولكن الاحتمال الثاني: لن يحدثَ أبداً!.
يتقوّل الكثيرون: إنَّ الحضارة تفسد الشعب، وإنَّ السباق الطبيعي لتطوّر المجتمعات يجري هكذا دوماً، فبالتوازي مع تنوير المجتمعات ورفع سويّتها يبدأ الكذب والتزوير والبلبلة والعادات السيّئة، التي تتنامى من جيلٍ إلى جيل، ونصطَدم بها نحن، وأبناؤنا من بعدنا… لتصبح واقعاً مُرعباً أمامنا، ألا ترون الأمور هكذا؟! هل محكومٌ على شعبنا أن يتخطّى مرحلة جديدة من الفساد والكذب، كما كان شأننا مع مفرزات الحضارة؟! «أعتقد أنَّ أحداً لن يجادل في أننا قد بدأنا حضارتنا بالذات من مظاهر الفساد!» كم أتمنّى لو أسمع ما يطمئنني بهذا الخصوص.
لست أشكُّ بعظمة شعبنا التي تتحطّم أمامها تلقائيّاً كل التيارات العكرة، كائناً ما كان مصدَرُها، وعلى هذا الأساس تعالوا نسهم معاً، ونمدُّ أيدينا كلُّ حسب إمكاناتِه، ولو كانت صغيرة لكي ننجز الأمور دون أخطاء… ولديّ قناعة – في الحقيقة – بأننا نحن وحدنا الذين لا نملك أي شيء سوى «حُبّ الوطن»… وقد نتفق وقد نختلف لكننا، متفقون على أننا أشخاص لسنا بالسيئين… إذن مهما يكن الأمرُ… فسوفَ تستقرّ الأوضاع في النهاية.
أُعيدُ: مضت مئتا عام من الكسل والخمولِ والانحلالِ.. ختمنا بعدها «عصرنا الأدبي» بنتيجةٍ مفادها أننا لم نعد نَفهم بعضنا بعضاً، وبالطبع انا هنا أتحدّثُ عن الناس الجادين المخلصين -فهؤلاء يختلفونَ بالرأي ولا يوافقُ واحِدُهم الآخر، أمّا أولئك المضاربون والمنافقون فمعهم الأمرُ مختلف: إنهم دائماً يفهمونَ بعضاً…
العدد 1089 التاريخ: 29/3/2022