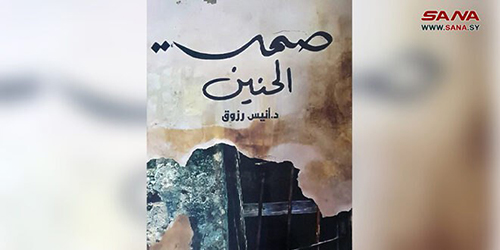الملحق الثقافي-أحمد علي هلال:
لعل الحنين سيظل ثيمة العبور لاستنطاق دواخلنا وحالاتنا ومواقفنا من الذات والآخر والعالم، هكذا تغدو هذه -الثيمة- بوصفها الطاقة الخفية والأكثر غوراً في الذات بديناميتها كلحظة ليست عابرة، لا سيما حينما تتحول إلى لحظة شعرية، فكيف للشعر إذن أن يقاربها بمستويات دلالاتها واستنهاض كمونها ليتعالق بالأشياء والعالم؟.
فمن «ألوان الحنين» إلى «صمت الحنين» يستمر الشاعر والأديب المغترب د. أنيس رزوق، في استنطاق الحنين وتأويل مستوياته ووجوهه، قبضاً على الإشراق، إشراق المعنى الكلي بتضافر جزئياته وإيقاعاته الملونة برهافة لغته المنضدة في نصوص مفتوحة قوامها تلك المفردات الأثيرة والمطعمة بنكهة خيال لطيف وذاكرة على اتساع، من أجل أن يقف على المعنى الكلي وهو أنسنة الحنين، هي تجربة ثانية في مواجهة اللغة وحمولاتها النفيسة والاجتماعية، لينسج بخيطها الذهبي لوحات ومشهديات تعلو بها غنائيات ذاته، وبتأسيس لمّاح لتلك النصوص أي بافتتاحيات تشكل عتبات ومنمنمات وموتيفات شذرية، ذات التماعات تضيء متن النصوص من أجل شعرية المعنى، «الحنين طفل مشاكس/ نام على رصيف الذكريات/ ليعانقك»… «صراخ معتق في خابية الروح/ يعانق الأنين»… «تشهق الإنسانية بأرواح ثكلى»… «يولد الحنين من رحم الذكرى/ التي أنجبت ملامحك».
ومع النصوص ومتوالياتها وتواتر خيط الحنين الخفي فيها، نذهب إلى شعرية المعنى وإشراقاته، وكيف نتقرى صمته، إذ الصمت هنا لغة ثانية تشي ولا تقول، وتضفر جدائل اللغة لتبث غزليات موحية، وفي أفقها ترتسم لحظات يدونها الكاتب ولعله يوقعها أيضاً، لتستوي «رعشة الحنين» في جسد النصوص، بوصفها كيمياء النار والاشتعال والانطفاء، هي دينامية الفكرة في مضارعة كل مالا يستقيم مع المعنى، وافتراع لقيم جمالية يعود بها الكاتب إلى ما هو بديهي، وصولاً إلى المركب في أنساق الهوية «من نحن»، كما الأقدار بوصفها أساطير افتراضية، فهل يتلامح هنا النزوع لتأريخ دقائق وسويعات كابدها وعي المغترب، ليدوزنها عشقاً للمكان والإنسان، بانخطافات وجده «كحرب وضعت على كاهلي أوزارها».
يقول الشاعر ولا يكتفي مستحضراً مأثرة يوسف، وليعصرنها صوغاً وإنشاداً «على تلال روابيها/ ترمينا في عمق الأحلام/ كيوسف والذئب يعوي بوادي غربتنا وواديها».
ولعل القارئ الكريم وبالمعنى النقدي هنا، سيدخل مختاراً طقس هذه النصوص ليؤلف معانيها، إذ الصمت يشي ولا يتكلم، ويلهم ولا يكتفِ، لتبلغ ذروة الصمت في مضارعة «المتربصين والتائهين على منابر الشغف بالجمال، والنائمون والناجون المتوارون خلف أقنعتهم، ليعبثوا ببهجة الكون، والفارون من إنسانيتهم إلى غاباتهم الوحشية، والمتربصون للسنابل الممتلئة… والحاقدون/ سارقو الفرح ومفسدو البهجة»، أولئك هم اللا استثنائيين.
ويصّعد الشاعر من غنائية لغته، حينما يطيف حنينه على المكان «شام وشام وشام/ أحلام تعانق ذاتها/ مع نسمة ونسمة وأنسام/ يا شوق المهاجر/ العين عن حماك/ لا تغفو ولا ترنو ولا تنام/ توقظنا برشفة مطر/ وعلى حدود السحاب تنام».
وهكذا هي دمشق حينما تلتقطها عين الشاعر، ليقول: «دمشق قباب/ تعلو وتعلو/ لتقطف السحاب برفق/ نسائم عز شامخات/ تهفو على الجبين وتغفو».
اللاوعي هو وعي شعري، يدخل الشاعر طبقاته ووعورته وتضاريسه المشتهاة، كما لو أنه نداء الأقاصي، وفيه تصغي اللغة لهمساتها حينما يوشّحها الشاعر بالغزل، ولتتواتر غير صورة يفتح في أفقها سرد ونبض يمتح من الذاكرة والذكريات، ولتستوي معزوفة الشجن هنا، يذهب الشاعر إلى تأبيد اللحظة واستجلاء خصائصها الشعورية في مناددة الآخر، وبث بوصلة المعنى هي ا لحب، بوصفه شعاعاً تستقيم فيه الأرواح والأمكنة والذكريات، لتأخذ منه إيقاعها وأشكالها التعبيرية، والتي لا تنفك عن استقراء الصمت ليصبح لغة كاشفة، تتعلل بالبوح والانتشاء عبر لغة صافية، سهلة وممتنعة بمفرداتها وخطابها ذو النزوع الإنساني، وقرابات اللغة والفكر، فهل نلتقي مع الحنين بوصفه كائناً لغوياً، وليصبح إنساناً بتمامه وتمائمه ونذوره، وتعاويذه التي يضخها الشاعر كدمٍ طري طازج في جسد نصوصه المفتوحة، بانخطافاتها إلى المعنى، وذلك المعنى الذي يعني الجمال الثاوي في الكلمة عمقاً لا سطحاً، وفي تعبير صورها رؤيا تؤرخ ولا تكتفي، إنه نشيد الذات في أزمنة مختلفة، لا تُستدى بغير ثيمة الحنين والتنويع عليها، ليصبح الصمت في انفتاح الدلالة هو اللغة العليا.
العدد 1214 – 19 – 11 -2024