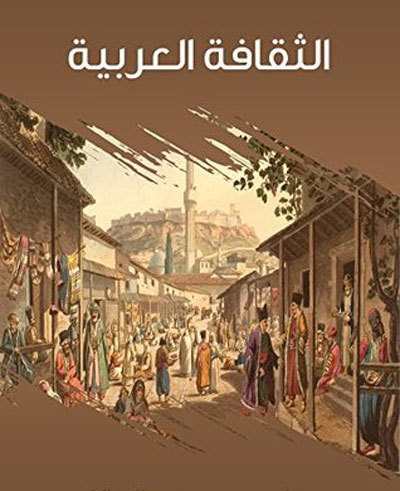الثورة أون لاين- الدكتور سومر منير صالح
لماذا تقدّم الآخر وتأخرنا نحن؟ وبعبارةٍ أكثر تحدياً لنرجسيتنا العربية يُطرح السؤال التالي: هل تخلفنا بالمعنى الحضاري عن الآخر؟ أم هنالك ما أعاق حركتنا الحضارية المعاصرة، وربما يحتاج الجواب مؤلفاً ومجلداً، ولكن بحدود المتاح نبحث عن العناصر المفقودة في سيرورة الحركة الحضارية لثقافتنا العربية، ونعير اهتماماً في هذا المقال لمفهوم الزمن، ورغم صعوبة البحث في مفهومه وتعدد المدارس والعلوم التي تحاول مقاربته، بين اتجاهاتٍ ميتافيزيقيةٍ تبحث عن مفهومه في رؤية الإنسان عن الكون، واتجاهاتٍ فيزيقيةٍ، تبحث عن تفسير حركة الموجودات ومعناها من خلاله، إلّا أنّه من المفيد في مقالنا هذا وبحدود معرفتنا البسيطة في الفيزياء بحث هذا المفهوم من جوانبه التي تؤثر على ثقافتنا العربية، منطلقين من التساؤل الإشكاليّ التاليّ، هل الزمن مرتبطٌ بإدراكنا له، أم إنّه مستقلٌ عنه؟!.
ففي الفيزياء المجردة يختلف الجواب بين الزمن المطلق والزمن النسبيّ، في المطلق وهيّ نظرية نيوتن، الزمن ثابتٌ في مساره، بينما في النسبيّ وهيّ نظرية ألبرت أنشتاين النسبية (هو نسبيّ) مرتبطٌ بمتغيراتٍ أخرى، كالمكان، والحركة، والجاذبية..، والزّمن عنده هو البعد الرّابع بعد الطّول والعرض والارتفاع، هذا الجدل ليس حكراً على الفيزياء المجردة، بل أيضاً في الفلسفة التأملية المجردة، فكلٌّ من كانط وهيغل جردا مفهوم الزمن والمكان، بعكس فيورباخ الذي نفى إمكانية تجريد الزمن وعدّه (مرتبطٌ بالإحساس والإرادة)، وعدّ (الوجود مرتبطٌ بالزمن)، وبالتالي لا يوجد فرقٌ جوهريٌّ بين الفلسفة والفيزياء في جدل التفريق بين الزمن المطلق والنسبيّ، ولو عدنا إلى الاتجاهات الميتافيزيقية لوجدنا أنّ أرسطو قد ميّز بين الزمن البطيء والسريع كما هو الحال في الحركة والتغيير، وعليه النسبية العامة لآنشتاين فيزيائياً هيّ استمرارٌ لمفهوم الزمن عند أرسطو فلسفياً، ولكن الحركة ليست وحدها ما يشوش الزمن، بل الجاذبية أيضاً، والقاعدة الفيزيائية البسيطة تقول إنّ الزمن هو السرعة مقسوماً على المسافة، وبالتالي الحركة تغير حكماً في قياس الزمن، ولعلّ هذا الأمر هو ما يهمنا في السياسة، فالثقافة العربية تعاني من تأخرٍ تاريخيّ، وهذا التأخر التاريخيّ غير مرتبطٍ بالبعدين الزمنيّ أو المكانيّ، ولكن هذا الأمر لا يعني إطلاقاً غياب العامل الزمنيّ عن ماهية التأخر، لأنّه حاضرٌ في الأزمة البنيوية للتأخر بصفته أمراً ذهنياً مرتبطاً بالإدراك، لا بصفته وحدة قياس، وفي هذا يجادل المفكر محمد عابد الجابري في غياب مفهوم الزمن عن مشروع النهضة، يقول (إنّ غياب عنصر الزمان كمحددٍ لمعنى النهضة والتقدم، جعل من الجائز الاتجاه نحو الماضي عند التفكير في أسبابهما)، وقصد أنّ غياب مفهوم الزمن كسيرورةٍ نحو الأمام أجاز لنفرٍ من الناس إحالة مفهوم التقدم بمعنى المستقبل بالعودة نحو الماضي.
هذه الإشكالية تجد صدىً واسعاً في دعوة (الإسلام صالحٌ لكلّ زمانٍ ومكان)، وهو أمر لا نجادل في صحته كدين وعقيدة، فإننا نجادل في فهم هذه العبارة، بمعنى ما معنى عبور مفهوم الزمان والمكان، وهل (فهم الإسلام) (كما فهمه البعض في التراث) عابرٌ للزمان أيضاً، أم إنّ المطلوب إعطاء الزمن مكانته في فهم الإسلام الحنيف، أيّ تجديد فهمنا للكون مع سيرورة الزمن، وتجديد فهمنا لكلّ الأمور التي بطبيعتها نسبيةٌ، قابلةٌ للتأويل والتجدد بالفهم والإدراك، وهذا لا يعني إخضاع كلّ العقائد لمبدأ النسبية، بل إخضاع فقط النسبيّ بطبيعته منه، فإغفال مفهوم الزمن في فهم العقائد مسببٌ رئيسٌ لنشوء الدوجمائيات كنمطٍ عقليٍّ، ومادةٍ فكرية، ونركز هنا على أنّ غياب الزمن يعيق حركة الإدراك العقليّ (البشريّ) لفهم العقيدة، وليس على العقيدة نفسها، ويكرس تبعية العقل المعاصر للعقل التراثيّ دون تمحيصٍ وتجديد، وبالتالي يتحول مفهوم التراث إلى (ثقالةٍ) كبيرةٍ يتباطأ معها الزمان في إدراكية العقل، ويصبح عاملاً بنيوياً للتأخر التاريخي.
وكذا الأمر إنّ إغفال عامل الزمن عن الإيديولوجيا السياسية، يحولها لخطابٍ وجدانيّ، غير مرتبطٍ بالمكان، متعالٍ عن الواقع، غير مرتكزٍ على حاجاتٍ موضوعيةٍ متغيرةٍ، سرعان ما يتحول لشعاراتٍ تخاطب الضمائر لا مرتكزاتٍ معرفيةٍ تنطلق من الواقع نحو الغاية المنشودة، ولأنّ هذه الضمائر مرتبطةُ بالزمكان الذي تعيش فيه، وتبحث فيه عن وجودٍ وكينونة، سرعان ما تنفصل عن الأيديولوجيا وتُعدها، فوقيةً، لا موضوعيةً، فيقع الانفصال بين الفكر الأيديولوجيّ وحامله البشريّ، وإذا كان الزمن عنصراً فعالاً غير مهتمٍ به في ثقافتنا المعاصرة، فإنّه عنصرٌ مهمٌ في رسم مقاربات المستقبل، لذلك إعادة بناء الوعيّ بالزمن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمرين: العقل، والحرية، فالعقل بلا زمنٍ لا قيمة لإنتاجه لفقدانه الحاجة الموضوعية التي ينبثق منها…والعقل بلا حريةٍ مقيد الإدراك ومسيطرٌ عليه، والزمن بلا عقل
مُدركٍ هو عدم، والزمن بلا حريةٍ تاريخٌ منسيّ، والحرية بلا عقلٍ فوضى، والحرية بلا زمنٍ عبث..، ولما كانت الثقالة التراثية الراهنة (المفكر واللامفكر فيه وبه) من التراث هيّ عامل إبطاءٍ للزمن اللازم لسدّ الفجوة الحضارية مع الآخر المتقدم، فإنّ هذا يستلزم بالضرورة الحفاظ على الكتلة التراثية، وانقاص الوزن التراثيّ عبر أمرين: الأول هو إهمال التراث غير الحيّ وإحالته إلى الحجم التراثيّ، والثاني تحرير التراث من مفهوم “الزمن المقدس” المعياريّ الذي نقيس عليه أوضاعنا في الثقافة والسياسة والعقيدة دون مراعاة لحركة التاريخ (المستمر).