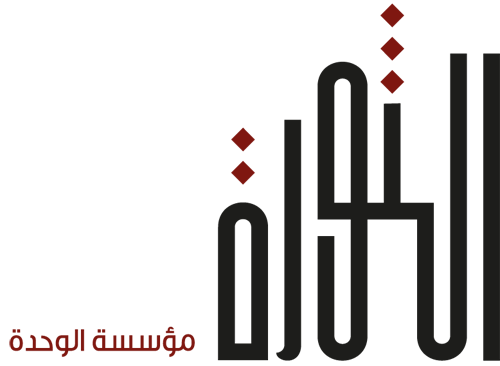الثورة أون لاين:
لم يشأ أن يكون غيره، ولم يكن ليكون إلاهُ.. كان طاقة عشقٍ متحرّكة باتِّجاه الآتي، يوغلُ في تجاعيد الزمان، ليولده المكان آيةَ نجوى على البلوى.
قاسم الهموم مشاغلها، فمنحها لواعج نفسه بآلامه التي عزفت على أوتار الرحيل، بقايا عشقٍ مفجوعٍ، حين أنكر دهره عليه حبّهُ الجامح لابنةِ الأرض. ابنة التين والزيتون، فإذ به يغيب تاركاً ظلّ قلبه، على ريفٍ صخري باح له يوماً بشاعريةٍ ممتلئة بهواجسٍ إلهية لا تُبقي ولا تُذر.
إنه الرحيل، وهو الأنجع لوقف النزيف الهائج بين قلبين إلى حين، فالشجن يبعث الشجن، وبقايا لقاءٍ يحمله على ظهرِ زيوس الذي حمل أوروبا إلى ما وراء المتوسط، فهل يقوى شاعرٌ على هجرِ الحبيبة؟.
يقوى ولا يقوى، ويحملها معه طيف آلهةٍ شرقية.. هكذا بدا له أن الأمر يستحقُّ المغامرة، فتمرّد على مجتمعٍ أعياه جهلهُ الذي رماهُ في قاعِ العصبية، جثّة ما زالت تتفسّخ، ناشرةً روائحَ البغض الكريهة.
قد يصقلُ السفرُ سجايا المرءِ فيدرك رغم البعد، بأن هناك صوت فلاحٍ عجوز، ما زال يوقظ تراتيل فجر القرية الجبلية، وبأن الصباح يشرقُ من وجهِ حبيبة، ستبقى تلقّم التنور استعداداً لإطعام النهار أرغفة الشمس.
هذي بقايا شاعرٍ، حمل آلامهُ عبر البحار، فعتّقها هناك حتى أصبحت، نوافير نورٍ لمن يتقنُ منادمة النور. عاد، ولم يكن يدري أنه غير قادر على العودة، فعاود الرحيل مرّة أخرى، حتى دعَّم استكانة القلب إلى حين، بعد أن أطبقت شبكة الصياد على من يُحب، وبقوة المجتمع المنغلق على ذاته، فقفل عائداً نديماه الشعر والخمر، فإن غضب يجرح بلا رحمة، وإن حنَّ إلى شعاب الحبيبة، يدمي القلوب رقَّة، فيُبكي الحجر والشجر، حتى لتسمع أنين النهرِ، وتأوّهات البحر، في ثنايا القصيدة:
“ما لهذا الهوى يمزِّقُ أوصالي ويفري جوانحي كالحسامِ/ ويمجُّ اللهيبَ في كبدي الثكلى ركاماً ينهدّ فوق ركامِ/ فأغنِّيهِ من دمي ويغنيني من السحرِ أوجع الأنغام/ ما أبالي شحوب لوني وضعفي ونحولي ورقتي وسقامي/ ما أبالي ضحك العواذلِ من شيبي وعجزي ورعشتي في الزحامِ/ وخمودي سكران في مطلع الفجر على الشوك والحصى والحطام/ أيها المشفقون/ لا تلمسوا الكبر بنفسي/ فتقصِّروا أيامي”.
يالهذا العشق كم يمنحنا وكم نمنحهُ.. كم يعانينا وكم نعانيه، بين حرية الضوء وحرية القلب. بين الطبيعة وما وراء الطبيعة، هو ذاك الذي يحدِّد حرية الشاعر، فإن هُزمت حريته، مضى أعرجاً يتَّكئ على فشله، وإن تقمّص حرية العشق.
كان خلاَّقاً بحرِّيته، مليئاً بإنسانيّته، ثائراً كالعاصفة، هادئاً كالعاطفة. هذا هو ومن هو؟.. وكيف كان ولم يكن ليكون لولاها.. لولا ذاك الوجه المنير، تحت منديل فلاحةٍ لا شرقيةٍ ولا غربية.. بل سوريّة سوريّة.
هكذا تجرفنا تيارات الذاكرة إلى شواطئ الشعراء العظماء، الذين فتحوا أبواب الغفلة بالثورة الفكرية، على مجتمعاتهم الرازحة تحت نير العبودية الثقافية والعقلية، فكانوا كوكب الشرق المضيء.
مع ألمه الأخير، نستدعي قوله، علّنا نتعلّم الصبر من صبره، ونمتلك بعض الحكمة من قوله: “قدرُ الحرّ أنه يركبُ الصعبَ/ ويسري في جوفِ ليلٍ مطير”.
نعم، من جوف الليل إلى شرفةِ الفجر، كان الشاعر “نديم محمد” يعاشق حرّية الألم، بألمِ حرّية الضوء.