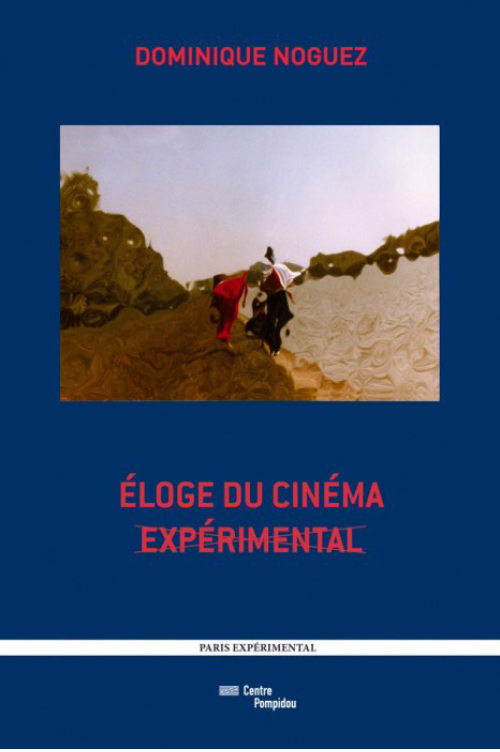باريس- صلاح سرميني:
في الحقيقة، يُمكن للسينما أن تكون «حكايةً»، أو «وسيلةً» لتقديمها، ولكن، يُمكن لها أن تفعل أفضل من ذلك بكثير، أن تمنح المتفرج إمكانية «الفُرجة»، وهذا يعني تقديم الواقع، أو التعبير عنه (لا نسخه).
دعونا نتساءل: من أين يأتي مصدر «الألم» الذي يُحدثه «الملل» الذي تخشاه النسبة العُظمى من متفرجيّ السينما؟
يمكن اعتبار الضيق بمثابة لسعة حارقة يُصيبنا بها «الزمن» الذي يمضي، منذ اللحظة التي نمنحه انتباهنا، وتُجبرنا السينما بدورها على أن نكون في حالة تيّقظ، فهي مرآةٌ/تجسيدٌ للزمان، والمرآة تُخيف أحياناً عندما تعكس صوراً لا نحبها، أو لا نحب مشاهدتها، ولكن، لنعترف أيضاً، بأنّ هناك الكثير من المتفرجين لا يحسّون بالملل، أو الضيق، وعلى العكس تماماً، فهم يستمتعون بمشاهدة أفلام لفيليب جاريل، أو فيلم مثل «جين ديلمان، 23 رصيف التجارة – 1080 بروكسل»، «دعني لوحدي» لجيرهارد تورينغ، أو «أغنية هندية» لمارجريت دوراس، وفي هذه الأفلام، فإنّ الفترة الزمنية هي التي تحظى بالدور الأكبر، ولا يشعر هؤلاء بالملل، أو الضيق، لأنّ هذه المرآة الفيلميّة تعكس أنفسهم، وفترتهم الزمنيّة الخاصّة بهم، وبالمُشاهدة العقلانيّة، فإنّها لا تبدو لهم شنيعةً، ومقيتة.
صحيحٌ أنّ هذه «السينما» (المقصود السينما التجريبية) تلسعنا في البداية بحروقها الأولى، ولكنها تمنحنا بعد ذلك الفطنة، الاعتدال، والعقلانية، وقد ذكر جوناس ميكاس يوماً بمناسبة عرض أحد أفلام أندي وارول:
ـ لو افترضنا أنّ كلّ الناس يستطيعون تحمّل الجلوس لثماني ساعاتٍ بشكلٍ متواصلٍ من أجل مشاهدة Empire State Building لوارول، وفكروا كثيراً بهذا العمل، سوف لن يكون هناك حروباً، كراهيةً، أو رعباً، ولسوف تعود السعادة إلى الأرض.
هذه الفرضيّة التنبؤيّة ليست بريئةً، أو ساذجةً كما يبدو للوهلة الأولى، فالسينما التجريبيّة هي امتحانٌ جيدٌ للتسامح، التحمّل، والصبر.
إنها تكشف بشكلٍ جيدٍ، عن طريق الصراخ، الضجيج، الهروب الذي تحدثه في بعض المرات، كراهية «الاختلاف»، استحالة تخيّل، وقبول «الآخر»، حيث يرى بارت بنباهةٍ، وذكاءٍ بأنّها من طبيعة «البورجوازيّ الصغير».
من كتاب «احتفاء بالسينما التجريبية»، دومينيك نوجيز.
التالي