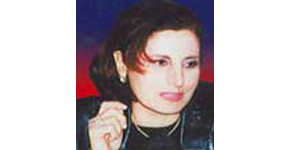(ثقي بأنني لا أعرف ماذا أقول لك؟)
هذا ما قالته إحدى الصديقات عندما سألتها (كيف الحال يا سلمى ؟)
سلمى معلمة ولديها شاب في الجيش مخطوف منذ خمس سنوات ولا تعرف عنه شيئاً، لكنها تبدو مستسلمة، مهادنة، من يراها يظن أنها غير مبالية، غير أن النار تحت الرماد كما يقال، كانت ترتدي معطفاً جميلاً.. قلت لها (معطفك حلو) رمقتني بنظرة مواربة وقالت بسخرية (من البالة).
ثم توقفت قليلاً وقالت وهي تشير إلى حذائها (وهذا من البالة.. وحقيبة يدي من البالة) قلت ولكن كيف تدخل هذه البالة؟ الجمارك في كل مكان، ابتسمت (الجواب ليس عندي، اسأليهم) قلت من أسأل الموضوع لا يخصني.؟
قالت (وأنا لا يخصني، وهم لا يخصهم.. وهن لا يخصهن، المهم ألّا يبرد الأطفال ولا الأجساد)، وتابعت ألا تلاحظين جائحة (الأنفلونزا)؟ التي لا يخلو بيت منها، بسبب البرد والجهل الصحي والأدوية الفاسدة والأغذية الفاسدة.. ثم تنهدت (كل شيء فاسد، حتى البشر)
قدرت وضع سلمى.. وقدرت كم هي حزينة ويائسة بعد اختطاف ابنها.. وفي الحقيقة لم تكن تقلّ يأساً وبؤساً عن أي أم لا تعرف مصير ابنها، إنها أسوأ حالاً من أم الشهيد التي تستطيع أن تزور ضريحه وتضع له البخور والورد، لكن سلمى فجأة قالت بصوت هامس وهي تشير إلى الفيلا المحاذية لبيتها، (انظري.. هل تصدقين أن هناك أزمة كهرباء ومازوت وغاز؟) لم أكن منتبهة إلى أن الفيلا مضاءة ومنورة من الداخل والخارج وأن المولدات التي تعمل لإضاءة الفيلا تكفي لتدفئة عشرين عائلة ترتجف الآن من البرد ويتقوقع أطفالها تحت الأغطية دون أن يكملوا وظائفهم ودروسهم، قلت بأسى (هذا صحيح) من يرى هذه الفيلات وتلك السيارات الحديثة والأسوار المحجرة لا يصدق أن البلد مرت وما تزال في حرب طاحنة وعدوان دولي يصب جام حقده على شعب آمن مستقل.. كنت أتأمل مدخل المنزل الفخم عندما ارتفع صوت صديقتي وهي تشير بيدها نحو المدخل المزين بالرخام وشمسيات القرميد والأسقف المستعارة والقناديل المتدلية الملونة (لماذا يحق لابن هذا البيت أن يتدفّأ وينعم بالضوء والسيارات والألبسة الفاخرة والطعام الشهي ولا يحق لابني؟ ماذا قدم صاحب هذا المنزل لم أقدمه أنا وزوجي؟
ماذا أعطوا الوطن وماذا أعطوا الناس ؟ ثم راحت سلمى تبكي وتهمهم بكلام متقطع.. أنا قدمت فلذة كبدي بينما فلذة أكبادهم خارج البلاد تتنعم بالأمان والرفاهية، علمت آلاف الطلاب ودافعت عن قيم الوطن وزرعت في ذاكرة التلاميذ حب التضجية والفداء والمثل العليا والأخلاق الطيبة والنزاهة، ماذا قدم أصحاب تلك الدور والقصور؟ ثم غلب صديقتي البكاء ولم تستطع أن تكمل.. كانت تذرف دموعها وكان المطر ينهمر ويظهر كسلاسل فضية لامعة انسكب عليها ضوء شرفة القصر.. كانت الشرفة تتلألأ وكانت حواس سلمى تنطفئ.. قلت أهدئها.. سلمى لا تقنطي من المستقبل.
التفتت نحوي بسرعة وكأن حشرة لدغتها وهي تسعل، المستقبل؟
ثم كررت كلمة المستقبل عدة مرات، أي مستقبل يا صديقتي؟ ماذا بقي لنا من هذا المستقبل؟ ماذا يأمل ابن الخمسين من المستقبل؟ أن يكمل دراسته، أن يبني مشروعاً؟ أن يسافر للسياحة؟ أن يرجع ابنه المخطوف سالماً معافى، أو ينسى ابنه الشهيد أو يسامح جاره الحرامي أو تعود البلد منورة كما كانت وقيمة الليرة كما كانت ولا نضطر نلبس من البالة؟ أو.. وبعد أن سكتت قليلاً همست (أنا لا أنتظر شيئاً، ثمانية سنوات اقتطعها (سفاحو الحرية، قاتلو الشعب وحرامية البلد من أعمارنا) وعندما ودعتها وقد أحزنني الحوار وأتعبني قالت وهي تبكي (اعذريني أرجوك لأن الوقت سبقنا والمستقبل لم يعد ينتظر أولادنا عند أبواب المدارس، ولا في صفحات ممزقة من كتاب الوطن).
أنيسة عبود
التاريخ: الأربعاء 6-3-2019
رقم العدد : 16925