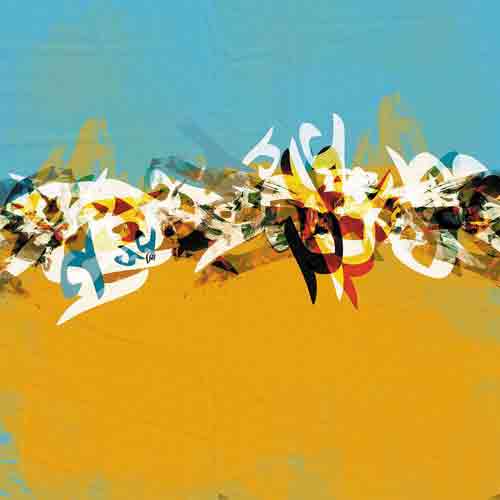الملحق الثقافي:د. ابتسام محمد فارس :
تعرض الشعب السوري خلال سنوات الحرب التي وقعت في سورية، لتبدّلاتٍ كثيرة طالت مختلف نواحي الحياة، الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والتربويّة والسياسيّة، ومما لا شكّ فيه، أن الحركة الديناميكيّة التي غيّرت مفاصل الحياة، بفعل عواملِ التهجير والتشرّد وتغيّر نمط الحياة، أثّرت على المفاهيم التي تربى عليها الأفراد في مجتمعنا، وتعدُّ قضية الهويّة الثقافيّة والوطنيّة، من الإشكاليات التي برزت على الساحة المجتمعية، فما حمله الأفراد من إرثٍ ثقافيّ وفكريّ واجتماعيّ، وشكّل هوية الإنسان السوري، تأثّر بمجرياتِ الأحداث من جهةٍ، وبأفكار الحداثة والعالم الرقميّ، من جهةٍ أخرى.
إن فكرة الهويّة الثقافيّة، هي المركب الذي يشتمل على المعرفة والمعتقدات والفن والقانون والعرف، ويدخل في ذلك، القدرات والسلوكيات التي يكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع، وربما تتنوّع الهويّة الثقافيّة داخل الوطن الواحد، فالهويّة هي ما يميّز مجتمعاً عن غيره، رغم وجود تنوّع واختلاف في بعض المكونات الثقافيّة المحليّة، لكن هناك ذاتية عامة، تشكّل الهويّة الوطنيّة لأي مجتمع، فالكلّ يختلفون في الجزئيات والوسائل، ولكنهم يتفقون على الأهداف العامة لوطنهم الموحد.. أما الثقافة، فلا يشترط فيها أنْ تكون واحدة؛ لأنها تشكل الرؤية الخاصة بكلّ فئة، فهناك ثقافة النخبة وثقافة العامة، الثقافة المحلية القديمة، وثقافة العشيرة والطائفة… الخ….، غير أن جميع هذه الثقافات، ينبغي أن تحدّد ما هو مشترك وكليّ، وتنسج هدفاً واحداً، ورؤية واحدة للمستقبل، وهذا ما يمكن أن يجتمع في ما نسميه “الهويّة الثقافيّة الوطنيّة أو القوميّة”. والهوية الثقافية قادرة على البقاء والصمود في وجه التغيرات إذا امتلكت عناصر الوعي والمرونة الفكرية والاستجابة النقدية البناءة، ولم تتأثر بمغريات النمط الغربي، في طريقة حياته وتفكيره، وكلّ ما يولّد التبعيّة الثقافيّة التي خلقت أزمة في الهويّة الثقافيّة، ومن ثم الثقافة الوطنيّة، وتفاقم الشعور بالاغتراب لدى الشباب بالذات، فالسعي لنقل حضارة العصر داخل البيوت والشوارع، والحلم المستمر بالهجرة، يولّد نوعاً من الصراع الفكري، ما بين الاحتفاظ بتراثِ الأجداد، أو اللحاق بعالم الحداثة والتطوير.
يرى “ماسلو” مؤسّس النظرية الإنسانيّة في علم النفس، من خلال طرحه لهرم الحاجات التي تلزم الإنسان، أن حاجة الانتماء تأتي في المرتبة الثالثة في ترتيب الحاجات، وأن غياب هذه الحاجة، يدفع للاكتئاب والعزلة الاجتماعية والقلق، لعدم وجود جماعة تحتوي الفرد وتمثّل أفكاره، فحاجة الفرد لتحديد من أنا ولمن أنتمي، تدفعه باستمرار للبحثِ عمن يمثلونه، وتعرّض الإنسان للصدمات والضغوط، يجعل هويته تتغيّر وتتعدّل، ويكتسب سمات جديدة، وهنا يمكننا القول، إن الهويّة شيءٌ ديناميكيّ، وهي سلسلة عمليات متتابعة تتغير مع الزمن، وإن أكثر ما نواجهه الآن، اندثار الهوية العربية، وتلاشيها في ضوءِ الاندماج بالحضارات الأخرى، وفرض ثقافات جديدة، على عكس المفاهيم التي تربّت عليها الأجيال السابقة، ويتوافق هذا الفكر مع مفاهيم العولمة التي تسعى إلى إلغاء السيادة على المكان وإضعافها، مستعينة بوسائلها وآلياتها، من الإنترنت والفضائيات التلفزيونية وغيرها، ما ساعد على تخطّي الحدود، وغزو ثقافة شعب وحضارته، وفرض ثقافةٍ أخرى عليه، وهذا يضعف الانتماء الوطني، ويفكّك عناصر الهوية، ويجعل الشعب بلا هوية، ويربط الناس بعالم اللاوطن واللا أمّة واللا دولة، ويفرقهم في صراعاتٍ طبقيّة أو طائفية.
نعم.. لقد باتت الشعوب العربية تسعى لتقليد ما تنادي به المؤسسات الغربية، ويؤدي إلى هدم وتهميش وإلغاء، ما يتعلّق بحضارة العرب، من لغة وتاريخ وإرثٍ ثقافي.. إضافة إلى ذلك، هناك الاستخدام السلبي لوسائل التقنية الحديثة، الذي يعدّ من العوامل التي تزيد من إعادة هذه الشعوب إلى الوراء، ولاسيما أن هناك من يعزّز ذلك، ويحرض على تبنّي ثقافة الغير، ويعرّي الهويّة الثقافيّة الوطنيّة، وهم العناصر الدخيلة على مجتمعنا، والتي تهدف إلى نشر أفكار ومفاهيم، تقوّض فكرة الانتماء والهويّة الوطنيّة.
كلّ هذا، يجعل الدعوة إلى تحصين الهويّة الثقافيّة، ودعم مقوماتها ومرتكزاتها، وترسيخ الانتماء إليها، في قلوب وعقول الناشئة والشباب، من أهم واجبات المؤسّسات الأكثر تأثيراً في توجّهات وانتماءات الشباب، والمتمثلة في الإعلام والمدرسة والأسرة..
ويعد التعليم بمراحله المختلفة والإعلام بوسائله المتعددة والأسرة بحضورها الدائم، من أهم الأوعية التي تزرع مبادئ الثقافة، ومن ثم الانتماء الذي يحدّد بدوره درجة الهويّة الثقافية ومدى عمقها وتبلورها.. وعليه فإن الاهتمام بتلك المؤسسات الثلاث، وتعميق التكامل بينها، يُعدّ أمراً في غاية الأهمية، لما تمثله فعالياتها من مرتكزاتٍ أساسية في بناء الهوية الثقافية والوطنية، وإن الاهتمام على سبيل المثال باللغة العربية، وجعلها اللغة الرسمية، (وهذا ما أكدت عليه السياسة التربوية)، يعزّز من الهويّة الثقافيّة، ويقلّل من آليات التأثر بالثقافة الدخيلة، والتي من صورها تبني الأسماء والمصطلحات الأجنبية بصورة لافتة للنظر، إلى درجة أن بعضاً منها أصبح يستخدم بديلاً للأصل في الإعلام والتحدث، وفي الإرشاد واللوحات الإعلامية والإعلانية.
أخيراً نقول: حتى نرسّخ الهوية الثقافية والوطنية للأجيال الصاعدة، لابدّ من الاعتماد على استراتيجيّة تربوية، وهذه الاستراتيجيّة تعتمد على مبدأين أساسيين هما:
1- أن تؤكد التربية ضرورة تعزيز التفاعل الإيجابي مع معطيات الثقافات الأخرى، بحيث يقوم هذا التفاعل على النديّة والتأثير المتبادل، والإفادة من عناصر التميز في ثقافة الآخر دون انبهار أو ذوبان.
2- تعزيز البناء القيميّ والأخلاقيّ للفرد، من خلال:
-إسهام الأسرة بدورٍ مهمٍّ، في التأكيد على القيم الداعمة للهويّة الثقافيّة، ومواجهة التداعيات السلبية للعولمة على أبنائهم.
– تحقيق الانسجام النفسي؛ للارتقاء بالنفس إلى الطمأنينة، لتجنب الباطل والابتعاد عن الوقوع في الأخطاء.
– الاهتمام بالتربية الخلقية للمعلمين والإداريين، لأنهم يعدون قدوة أمام الطلاب.
-إيجاد بعض المقررات التي يدرسها الطلاب؛ لتدعيم القيم والأخلاقيات وتعزيزها، وتكون مرتبطة بعقيدتهم الراسخة وثقافتهم الوطنية.
– اشتمال المقررات الدراسية على قيم بعينها مثل الديمقراطية، والالتزام بالقوانين، والتضحية في سبيل الوطن.
التاريخ: الثلاثاء27-7-2021
رقم العدد :1056