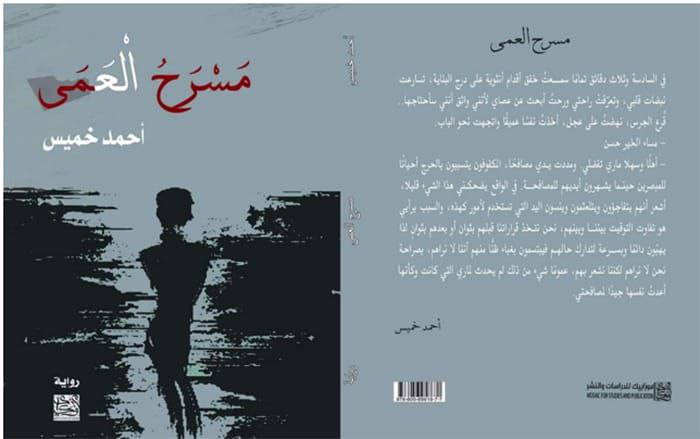الثورة – أحمد صلال – باريس:
راودتني جملة أسئلة في الفترة الأخيرة، ولاسيما أنّ الأعمال الأدبية التي شرعتُ بقراءتها منذ مدة كانت بمجملها ذات مضمون متشابه بعمومه مختلفاً بعض الشيء بإيقاعه وعاطفته وسرده، جلُّ هذه النصوص “رواية، قصة، شعر.. إلخ” جعلت من الثورات العربية، والسورية على وجه الخصوص ثيمة، وقيمة أساسية لمختلف الإصدارات التي عجّت بها مؤسسات النشر والطباعة، وذلك ينطبق على الكاتب السوري أحمد خميس الذي يكتب مدفوعاً بعاطفته، مكلوماً بمأساته ومأساة أهله، وهو كاتب وناقد سوري، يعيش حالياً في ألمانيا، صدرت له ثلاث روايات: “خنادق الحبّ”، “قيامة اليتامى”، و”مسرح العمى.
وفي حوار أجرته “الثورة” مع الروائي أحمد خميس، أوضح أن هناك انشغالاً بالعمى وأحواله على مدار صفحات الرواية في “مسرح العمى”، وهذا كفكرة للرواية كما لشخصيات فيها، متعدّد الأشكال، حدثني أكثر عن هذا العمى عن وجهي القوّة والضعف فيها؟

بداية أريد القول: إنني من المحظوظين الذين كانوا على اتصال مباشر من أناس نبلاء حقاً، أناس يمتلكون أكثر بكثير مما يفقدون، وأقصد المكفوفين سواء بحكم صداقتي لهم أو حتى بحكم عملي لمصلحتهم في فترة ما، من خلالهم تمكنت من رؤية العالم بشكل أوضح، وأكثر نقاءً.
قد تكمن القوة في مسرح العمى بكوني تجرأتُ وكتبتُ عن العمى، تلك البوابة السحريّة التي ما إن فتحتها حتى ولجتُ عالماً مليئاً بالسحر، والجمال والموسيقا، وأما عن الضعف فقد كان حتماً بعجزي عن فهم قدرتهم على الصمود، ومواجهة الحياة رغم محاولات أبطالُ روايتي المتكررة.
العناصر التي تتألف منها “مسرح العمى” تبدو غير مترابطة بالمعنى الروائي، إذ لا يكمل أحدها المعنى للعنصر الذي سبقه. الأرجح أن “المعنى” الذي تسعى الرواية إلى إيصاله كامن في تلك الانتباهات عن العمى، وعن سواه التي تتخلّل نصّها.. هل تتفق أو تختلف مع هذا التوجه؟
مسرح العمى لم يكن عملاً روائياً واحداً، نعم كانت ثلاث حكايات منفصلة للوهلة الأولى تولى أبطالها سردها..”عطا” وزملاؤه قصة تسبح في مدار مختلف عن عالم حسن، وبدوره يتناول حسن حكايته بمعزل عن يونس وخاطرة إلى أن تتقاطع طرقاتهم، وتنصهر مصائرهم بما يخدم الطرح والغرض الروائي الذي عملت عليه منذ البداية.
ربما كان عمى حسن، ويونس أهون ما في الحكايات كلها من عمىً، وكما قلت بمطلع روايتي: كلّنا منقوصون حتماً، نقصٌ يُرى، وآخر لا نراه، مكتملون بقدر ما نثق وليس بالقدر الذي نحن عليه حقّاً، عميان بطريقة أو أخرى.
– في روايتك “قيامة اليتامى” تتناول قضايا فردية واجتماعية وأمنية ونفسية، ترتبط تفاصيلها بغسل الأدمغة وتحويل البسطاء إلى قتلة غير مأجورين بيد الكبار، لتنتقل الشخصيات إلى سوريا عبر تقنيات الرواية، أرى الأسلوب الذي غير التقليدي بل وربما المبتكر في السرد الروائي، أراه قد نجح تماماً بإيصال أفكاره، وبالمحافظة بل والإمساك بالقارئ من دون أي تشتيت له، أضف أن النص جذاب حقيقة في لغته وسلاسة سرده، وتصوير الكاتب للمشاعر وكذلك باستعاراته الجميلة والمميزة حق، كيف تمكنت من ذلك؟
الكتابة بشكل عام هي ردّة فعل الكاتب على الواقع، ووجهة نظره حيال الأشياء، المواقف والأشخاص، والرواية أو كتابة الرواية هي الحشرجة الخانقة التي تسبق الانفجار البكائي العظيم.
بلحظة ما وجدتني أمام طرق مسدودة كلها، إلا واحدة انتهت بقيامة اليتامى، أستطيع القول هنا: إن فيها تجلت خوالجي، وتعاظم إحساسي باليتم الذي يعيشه الوجدان العربي من مائه إلى مائه، وعاينت عن كثب ذلك الانكسار المهيمن على الأنوات العربية، ورغم ذلك كانت تتزاحم في روحي رغبة في استئصال ورم الخذلان الذي تعاني منه قلوبنا بطريقة ما، ربما أدرك تماماً أن روايتي حالها كحال غيرها لن تجدي أي نفع لكنه جنون الروائي، وصوت صرير القلم الذي يتضخم في رأسه فيمنحه طاقات كاذبة وقوىً يعتقد أنها خارقة .
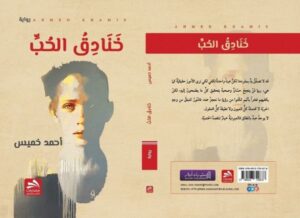
– كيف ارتكبت رغبة الأدب في عملك الأول “خنادق الحب”؟
27 حزيران 2014 كان صعباً، يوم وقفت على الحدود، وقد اتخذت قرار الفرار، ودعني هنا أقتبس عن نفسي لأقول واصفاً الموقف حينها:”جاثٍ على ركبتَيه، كمتعبّد يطالع دياره التي أيقن أنه لن يراها مجدداً، تجاوز الحدود، ولم يُدر لها ظهره، بل راح يمشي كمن أتمَّ مناسكه، وشرع يودع قِبلتَه، تبعثرت تلك الدور المحطّمة كعواطفه، كفتات روحه وأنفاسه، انتزعوه كشتلةِ آسٍ ليزرعوه ها هنا غريباً، وحيداً، محطماً، يتيم الأب، والوطن والذكريات”، خنادق الحب كانت عربوناً لأناس وهبوا أرواحهم لكي نحيا، ولمدينة عانت وما زالت تعاني، حاولت فيها تبرئة نفسي من مشاعر الذنب بمغادرة البلاد، حاولت أن أكتب المرحلة، أسطّرها، أدونها بكتاب ما، ولكوني قارئاً قبل أن أكون كاتباً وأعلم جيداً أنّ الروائي أكثر موثوقية في نفوس الناس من الساسة والصحفيين كتبت ..كتبت خنادق الحب.
– هل كانت القصة القصيرة تمارين أدبية على الرواية؟
لا أبداً لم تكن القصة كذلك، أنا كتبتُ أول ما كتبتُ الرواية، كان ذلك في مرحلة ما في نهاية مدرستي الثانوية وبدايات الجامعة.. القصة فضاء آخر، مكان ضيق ينبغي على كاتبها أن يؤثث أرجاءها بعناية، أن يمتلك القدرة على استغلال المساحات، وسرد حكايته على قدم واحدة، لم أنطلق من القصة إلى الرواية، لا بل إنني لم أجرؤ على كتابة القصة إلا بعد أن ركبتُ غمار الرواية مرتين.
– بعيداً وقريباً في نفس الوقت من الأدب استوقفتني مساعدتك للاجئين السوريين في اليونان كونك تحمل دبلوم علم اجتماع؟
في نهاية عام 2011 عملتُ لمصلحة منظمة أطباء بلا حدود كاختصاصي نفسي في مدينة تل أبيض، وحينما غادرت سوريا إلى تركيا عملت لمصلحة هيئة الإغاثة الطبية الدولية IMC بذات المنصب، كنتُ رافضاً فكرة الابتعاد كثيراً عن البلاد رغم الفرص التي أتيحت لي مدفوعاً بمثاليتي أحياناً، ورغبة مني في البقاء قريباً من الناس في مخيمات اللجوء سواء في ” أكشاكالا، نْزِب، الإصلاحية أو حتى في مركز العيادات الطبية السورية في مدينة أورفا”.
في اليونان وفي مخيم موريا تحديداً عشتُ تجربة لجوء حقيقة، سكنتُ خيمة برفقة أربع عائلات لا أعرفها، منهم أفارقة وأفغان.. كنا على الحدود الدنيا من كل شيء ” الأمان والطعام والشراب”.
موريا لا تبتعد كثيراً عن الجحيم، بل إنني واثق أنها تتاخمه، هناك حاولت أن أمارس عملي في الصحة النفسية لمصلحة عائلتي “أمي، زوجتي، أختي وأبنائي” رغم تعارض ذلك مع المعايير المهنية لكن في الأزمات تُعطّل المعايير حسبما أعتقد، بالتدريج تحسنتِ الأمور، وانتقلنا إلى البر في أثينا وهناك بدأت أكتب، مستغلاً ذاكرة المكان وقسوته.
– كنت من أوائل المنتفضين والثائرين على النظام المخلوع، حدثني عن ذكرياتك مع الثورة؟
ألا تكون ثائراً فذلك باختصار يتنافى وكونك إنساناً ذا إرادة وحرية واختيار.. الثورة ليست حالة غريبة، ولا شعوراً طارئاً، ولا تطوراً لنتاج بشري ما.
إنها كينونة بحد ذاتها، لا تُعرّف، ولا تُشرح، ولا تُدرّس، ولا تقارن بغيرها من مفاهيم أخرى.
أن تكون ثائراً، فذلك يعني أنك كائن طبيعي صحيح يشعر بالأسى والغضب والخذلان.
حتى العبيد يثورون، ويغضبون، ويحاولون على نحو ما خلق عالم، وفكرة مضادة لمفهوم العبودية، يسعون وإن في مناماتهم لرسم مكان يتسع وأمانيهم بعيداً عن حظائر السلطان وزرائبه.
كثيرة هي ذكريات الثورة، فقدتُ أناساً من أهلي وأصدقائي وجيراني، خرجتُ متظاهراً حالي حال السوريين أغلبهم في أحياء اللاذقية “قنينص وبستان الريحان والصليبة” وتظاهرت في الرقة برفقة أحرارها، وفي قريتي “علي باجلية” التي لم تتأخر عن الركب والتحقت بالقافلة منذ البداية.
لم أكن بطلاً ولا مؤثراً لكنني كنت أعلم رغم سوداوية المشهد بعد عام 2018 أن الهلاك مصير الطغاة حكماً، وأن قدر الشعوب الحياة حتماً.
– كيف أثرت تجربة الاغتراب على نتاجك الأدبي؟
يدرك المهتمون بالشأن الأدبي أن النشر هو القرار الأكثر خطأً في دورة الحياة الأدبية ومع ذلك يصرون على ارتكابه في كل مرة.
وأقصد هنا رغبتنا ككتاب في الوصول إلى حال الكمال والمثالية المطلقة في النص، لكن ما أن تحين لحظة الولادة حتى تخرج الأمور عن السيطرة، وإن كان الجنين مشوّهاً، معتلاً، وقد يكون ميتاً أحياناً.
الغربة ورغم قساوتها إلا أنها تقدم دروساً ذات أجر باهظ على صعيد الحياة ككل، ولأن الرواية حياة هي الأخرى تكون حصة الروائي من دروس غربته مضاعفة.
قيامة اليتامى مثلاً تدور أحداثها في باريس ، ومسرح العمى في النرويج الولايات المتحدة.
نعم اغتربنا واغتربت شخوصنا، وأصبح الوطن مُنولوجاً نهذي به، والقرائح مقابر جماعية دفنا فيها وطناً نأمل أن يبعث اليوم عزيزاً حراً معافى.