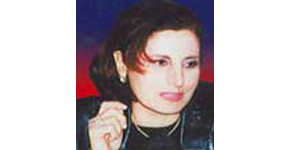لم تكن الشمس قد غرّبت بعد فوق قريتنا حين فكرت أنه يمكنني أن أمشي قليلاً باحثة عن نبتة (شمرا) العطرية لأضعها مع الزهورات البرية المفيدة.. مشيت نصف الطريق ولم أجد نبتة شمرا واحدة.. عادة كنت أقطفه عن كتف الطرقات الترابية.. وكان يتجاور مع نبات الطيون المعمر الذي يطلق أزهاراً صفراء ورائحة جميلة نفاذة.. كان الطريق معبداً وضيقاً فكان عليّ أن أقف كلما عبرت سيارة أو دراجة نارية وما أكثرها. لم أطل البحث عن النباتات البرية العطرية… يبدو أنها في طور الانقراض عن الطريق.. شعرت بالاختناق وأنا أراقب هذه البيوت (المزكوكة) على الجانبين.. وكل بيت يتقدم على الآخر باتجاه (الزفت) وكأن الأرض ليست لهم.. وليست منبسطة وواسعة ومزروعة بالتين والزيتون والعنب.. للأسف لم أجد تيناً ولا زيتوناً ولا عنباً قالوا أن الموسم رديء جداً.. غير أني وجدت أكوام (الزبالة) على ضفتي الطريق.. الروائح خانقة.. وأكياس النايلون مبقورة والقطط والفئران تلعب لعبة (الطميمة).. وعلى الطرف الثاني يقف فقراء يبحثون عن شيء مفيد في هذه الأكوام من النفايات التي نسيتها البلديات ونسيها الناس وصارت عادة طبيعية أن ترى الزبالة في كل مكان.. في الشوارع وفي القرى وعلى ضفاف الأتوستراد. وضعت يدي على أنفي، وسرت محاولة أن أجتاز كومة النفايات.. لكني لم أستطع.. فكانت النفايات متواصلة على طول الطريق الموازي لخط ري السن الذي تتحول النفايات بالنهاية إلى جوفه فيجرفها معه إلى الحقول والمزارع بعد أن تسد الأكياس الطافية بوابات الفروع.
…………………………….
قالت صديقتي ليلى – لقد كتبت عن ذلك المشهد المؤذي – قلت نعم.. كتبت.. وسأظل أكتب طالما أن دهشة المشهد لم تفارقني.. وطالما أني لم أعتد حتى الآن على رؤية الأطفال يبحثون في أكياس القمامة.. وطالما تحولت الأنهار والطرقات ومجاري الري إلى مكب للقاذورات.
أنا أظن أن البشر سيموتون جميعاً وستبقى أكوام الزبالة. لقد كثرت الأمراض الخطيرة.. وكثر التلوث البيئي والأخلاقي .. وربما سيؤدي ذلك إلى انقراض الحياة.. من يمشي في الريف صار يشتهى أن يلتقي بمرج أخضر يجلس على عشبه.. أو يلتقي بطريق ترابية ليست مكباً للنفايات. أريد أن أصرخ يا صديقتي.. أريد أن أبكي في نهاية المطاف لأن أحداً لا يرد على صراخنا.. ما يضطرنا للبكاء كي لا تنفجر قلوبنا.
…………………………….
في طريقي صادفت بشراً غرباء.. لم أعرف أحداً منهم.. لم يكن المارة من قريتي..عادة كانت القرية عبارة عن مجتمع مغلق صغير، يعرف بعضه ويتعاون مع بعضه.. وكان من البديهي أن يعاتب الجار جاره ويطلب إليه المساعدة والمعونة ويقطف من أشجاره التين والرمان والعنب.. لكن القرية اليوم صارت مجمعات سكنية وبنايات طابقية لغرباء لا يعرفون بعضهم ولا (يمونون) على بعضهم.. وصار من غير المقبول أن توجه نقداً لشخص لا تعرفه.. وحتى إذا ما تجرأت وقلت (يا جار رجاء لا تحرق البلاستيك والزبالة) قريباً من البيوت لأنه يضر الجميع ويضرك أولاً.. بالتأكيد سينظر إليك شذراً ويبرم – بوزه – ولن يرد.. ليعيد الكرة والنكاية في اليوم التالي.. وهكذا يتحول الريف الأخضر النقي الجميل، المتعاون إلى بؤرة للتلوث والإزعاج والصخب. ما يضطر الكثيرين إلى مغادرة هذا الريف الذي كان ملاذاً للمتعبين والمرهقين من ضجيج المدينة ومعاملها وسياراتها وتلوثها.
…………………………….
قالت صديقتي
وهذه كتبت عنها أيضاً فما الذي تغير..؟ قلت وأنا أرى قريتي القديمة التي كانت على ضفة نهر نشرب منه.. صحيح لم تسافر قريتي ولا تزال على ضفة النهر ولكن النهر صار ملتقى لمجارير القرى من الجبل حتى البحر، وصارت ضفافه مرصوفة بأكياس سوداء قد لا تذوب عبر مئات السنين.. قلت.. لا أقدر إلا أن اكتب.. فأنا أشم الآن رائحة حريق النفايات وهذا يؤلمني ويحرضني أن أعيد الموضوع ألف مرة.. لعل إحدى المرات تصادف مسؤولاً لم يفقد إيمانه بالإنسان ولا دهشته من الفساد والتلوث والإهمال.
…………………………….
إذا لم تغيرنا الكتابة؟ وإذا لم تدخل تعاريج دماغنا ثقافة الحياة والتطور فلماذا نهرق الحبر.. ولماذا نلون بياض الورق؟.
أنيسة عبود
التاريخ: الأربعاء 10-10-2018
رقم العدد : 16807
رقم العدد : 16807