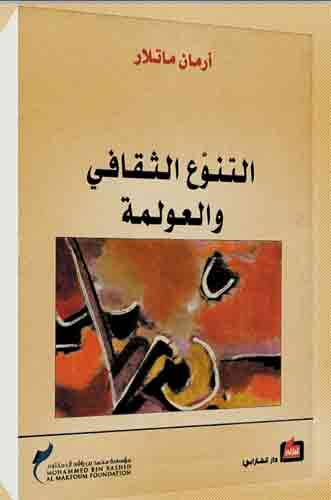الملحق الثقافي:هفاف ميهوب:
في كتابه «التنوّع الثقافيّ والعولمة»، يبدأ المفكّر الفرنسيّ «أرمان ماتلار» الباحث في علوم الإعلام والتواصل، بالحديث عن المجتمع والمتّحد «الأمّة»، ومنذ ظهور المفهوم القانوني للثقافة والعلم، في القرن التاسع عشر، حيث كان موضوعه «الأنثروبولوجيا الثقافيّة» أو «الأناسة»، وهو مصطلح ثقافيّ يدلّ بمعناه الأوسع، على هذا الكلّ المكثّف الذي ينطوي أيضاً، على المعرفة، الاعتقادات، الفنون، القوانين، العادات، وكلّ مَلكة أو عادة يكتشفها الكائن البشريّ..
هو تعريفٌ أشار «ماتلار»، إلى أن من أطلقه هو الأنثروبولوجي البريطاني «إدوارد تايلور» في كتابه «ثقافة بدائيّة»، معتبراً أن ما يميّز مجتمع عن آخر، هو التقدّم في المعرفة، وبأنّ التطوّر هو الخطّ الموحّد لثقافة الإنسان، متراوحة بين البدائية والمدنية.
هنا، تُسارع العقلية الاستعماريّة إلى تشويش مفهوم المبادلات، وانتشار الثقافات، بإسهامٍ أحاديّ الجانب، ما يؤدي إلى التأسيس للعجزِ الإبداعيّ المصنّف في أسفل سلّم المسار الحضاريّ. ذلك أن «كلّ ما يبتعد عن الرحم الحديثة أو الغربيّة، وعن العرق الأبيض، يجري ترتيبه بالأدنى..
إنه ما جعل «ماتلار» يرى، بأن غزوات العالم الجديد، والرحلات الاستكشافيّة الكبرى، وإن حَدّدت الأنثروبولوجيا الثقافيّة، إلا أنها جعلت الأنثروبولوجيا العدائيّة – الجرميّة، تطاردها وتشهد استمرار الحضارة السالفة، من البرابرة والهمجيّين الجُدد، الخارجين عن القانون، المنحرفون، الطبقات الخطيرة..
إذاً، بدأت الأنسنة الثقافيّة، بطغيان الأكثريّة، وبرؤى متنوّعة لكتّابٍ القرن التاسع عشر، ممن لم تمنع رؤاهم هذه رغم اختلافها، من تبلور فكرة طغيان «الجمهور موحّد الزيّ».. الجماعات غير المسؤولة، غير العاقلة، المشغولة بـ «النزوات الغربيّة» التي يقودها عن بُعد، سائق السياسة والاقتصاد والصحافة والثقافة، وبطريقةٍ يفقد المنقاد فيها، كلّ استقلاليّته..
ابتكارُ العولمة.. وسيطرة الاحتكارات العالميّة
«وصل الأشخاص والمنتوجات والأفكار، إلى درجة خارقة في الحضارة العالميّة، وقد تكوّنت هذه الفكرة، من كلّ الأفكار القوميّة والأثنيّة، وبفضل الرحلات والمؤتمرات والمعارض والمنشورات..».
بهذا يقدّم «ماتلار»ّ لهذا العنوان، وبهذه الكلمات التي ذكّر بأنها كُتبت عام 1912 في العدد الأول من مجلّة الحياة الدوليّة… المجلة التي كان قد أنشأها محاميان بلجيكيّان، أحدهما من الأدمغة المفكّرة، والثاني رائد علم الإعلام والتوثيق، وبأنهما معاً، من فكّر بضرورة إيجاد الكتاب العالمي للمعرفة، الذي اعتبراه «الحاضنة العالميّة»..
شيئاً فشيئاً، أكملت القنوات بين المحيطات، الشبكة الكثيفة من أسلاك وكابلات تحت البحار، لتكون بذلك قد حاصرت العالم، وليس شبكات التواصل فيه فحسب، بل أيضاً الاقتصاد، الحق، الأعراف، الأموال، التأمينات، الصحافة، العلوم، الآداب والفنون، وسوى ذلك مما بات واقعاً، تحت سيطرة الاحتكارات العالمية…
ينوّه الكاتب هنا، إلى أن عصبة الأمم التي دبّرتها القوى العظمى عند نهاية الحرب، والتي يُفترض بها أن تجسّد مثال السلم الدائم، الذي طوّره «كانط»، قد أساءت تدبير مثال التنوّع، على ثلاثة صعد على الأقل، وقد كان أخطرها، عدم وجود أيّ أثر لتفكير الإنسانويّين الآتي من العالم المُستَعْمر، مثل مفكريّ النهضة الهنديّة، كـ «أوروبيندو» الذي نادى في كتاب نُشر ووزّع على المدارس، في عزّ الحرب، بالوحدة البشريّة واستعادة روحها، و»طاغور» الذي خلق وعياً اجتماعيّاً واقتصاديّاً وسياسيّاً ولغويّاً، شكّل خطراً على الاستعمار وسياسته اللاإنسانيّة.
مسارات الاستعمار الثقافيّ.. وغربنة الشعوب
ينتقل «ماتلار» إلى ما سماه «تصفية التورخة»، وهي «إحدى سمات كلّ ميثولوجيا، وقد عرّفها «رولان بارت» بأنها العجز عن تخيّل الآخر، فلا يعرف النظام المسيطر سوى سبيلين للمواجهة، وكلاهما يؤدّي إلى الشرّ.. إما الاعتراف بالآخر كمهرّج، وإما تحييده. المهم نزع تاريخه منه»..
إذاً.. الهدف الأساسي من التحديث، المصرح به دون تحفّظ، هو «غربنة الآخر» ..أي «غربنة الشعوب التي تُعامل على أنها بلا تاريخ، بلا ثقافة، فلا يمكن للتجديد إلا الانتشار، من فوق إلى تحت، من الأقطاب المتطوّرة، إلى الأمم المتأخرة».
إنه التصريح الذي اضطرّ «ماتلار» للسؤال: أي نظامٍ ما بعد استعماريّ للتواصل؟..
سؤالٌ، لم يجد بدّاً من طرحه، أمام ما رآه من السياسة الإمبريالية الثقافيّة، هادفاً إلى القول بأن «الدخول في العصر ما بعد الاستعماريّ، جعل أميركا تتمسك برؤيتها الصارمة للتدفّق الحر للإعلام، عبر «نظام اقتصاديّ عالميّ» أدى إلى «الترابط الإكراهي بين الثقافات»، وهو ما ترافق مع «التبادل الإكراهيّ، في علاقة الثقافيّ بالدوليّ التنافسيّ».
على هذا الأساس، فإن الفكرة العالميّة للحقوق الإنسانيّة، والتوحّد مع الآخرين، تعطي معنى حقيقياً لمفهوم التنوع الثقافيّ، الهويّة الثقافيّة، الروابط ما ببن الثقافات، ولكن حسب المشروع النيوليبرالي للعولمة، وهي الظاهرة التي وجدها «ماتلار»:
«تَصوّر مبتكر للاعبين، لتحويل الثقافة إلى أداةٍ حقوقيّة، قادرة على تخليص مجمل التعابير الثقافيّة، من قاعدة السلعة الوحيدة»..
سوق الديمقراطيّة العالميّة… مصائدٌ للثقافة
إنه السوق الذي سعى، لبناءِ شركاتٍ دوليّة باسم «المتعددة الجنسيّة»، موحياً بأن هذه الشركات، تقترن بمصالح كلّ أمة، حيث تستوطن.
شيئاً فشيئاً، تطوّر هذا المفهوم، فتحوّل اسم هذه الشركات، إلى «عابرة للقوميات»، ويراد من هذه التسمية، الدلالة على أن نشاطات هذه الشركة، مرتبطة باستراتيجيّة ذات بعد عالميّ.. لكن «النزعات كانت، رأسماليّة بحتة وفظّة.. نقلت مصطلحها نحو كلّ لغات الكوكب، دون أن يكون لدى المواطنين الوقت للتساؤل، عن ظروف ومكان إنتاجه».
يدلُّ هذا، وبالمعنى الدقيق، بأن «الهدف من التعولم، بناء مكان لتقويمِ وتوحيد معايير التنافسيّة والربحيّة، على الصعيد العالميّ، لكنه يتعدّى ذلك، لينتشر في المجتمعات تدريجيّاً، وبمفهوم المنافسة المنحدر من المدرسة النيوليبراليّة، محوّلاً مصطلح الاقتصاد الشامل، إلى موجّه يتحكم بقول وفعل ومصير العالم..».
تنافر اللاعبين… شموليّة الرهانات
لاشك أن تكنولوجيا الاتصال الضخمة، التي ساعدت على هذا التحكم، أدّت إلى تنافر اللاعبين، وبالتالي المجابهة حول سيناريوهات استحداث تكنولوجيّات جديدة للإعلام والتواصل، فرؤساء المنظمات والمنشآت غير الحكوميّة، لابدّ من أن يرفعوا أصواتهم، وهم وإن أعلنوا احترامهم للتنوّع الثقافيّ واللغويّ، إلا أنهم يرون بأن هذا التنوّع يجب ألا يولّد حواجز غير مقبولة في وجه التجارة، فالسوق يخلق تنوّعاً في العرض أيضاً..».
هي رؤية، مثلما أدّت إلى جعل سوق الثقافة مضطرب، حسب سياسات التواصل والتنصّل، جعلت التفكير في بناء مجتمع المعرفة، مؤطّر بما يتمّ تصنيعه، في «ورشة تقدّم الرأسماليّة المعرفيّة، التي تتآمر على الفكر والفعل، اللذين يخرجا من دروب مبتكرة وحرّة، ومواجِهة لهيمنتها»..
باختصار.. إن ما يريد الكاتب قوله، وبعد هذه التفاصيل وغيرها، مما لامجال هنا لتناولها كلّها:
«عبادة الحاضر، الإعلام، الثقافة، محاطة كلّها بهالةٍ، فهمْ الرباط الذي تقيّمه إشكاليّة التنوّع الثقافي، مع الديمقراطيّة، في سياق العولمة…
عبادة الإعلام، تهزأ من الثقافة، ومن الذاكرة. وحده مصنع الاتّصالات يُحسب حسابه…
عبادة الثقافة، عَلّقت على شماعة النمط الثقافيّ، مشكلاتٌ لا يرادُ معالجتها بحدودٍ سياسيّة، تغدو محايدة، وتحمل مشكلات تفيض على المجتمع، ولا يُعرف سبيلاً لمعالجتها.. وحده العقل التجاري، يغوي..»..
أهو صدام حضارات؟.. أم حوار ثقافات؟.. ثقافة واحدة، أم ثقافة بصيغة الجمع؟!!ّ.
مُجدّداً، تغطي فكرة التنوع الثقافي ذاتها، وقائع ومواقف متناقضة، فهي كمحور اقتصاديّ للنظام العالميّ الجديد، تقف وراء فكرة الديمقراطيّة العالميّة، لكنها أيضاً، نمطٌ جديد، لتسيير الشوق الشاملة…
هذا ما تناوله الكتاب، وأدان فيه ما نراه ونتلمّسه، من هيمنة سوق الاتصال والعولمة، والثقافة العالميّة…
التاريخ: الثلاثاء31-8-2021
رقم العدد :1061