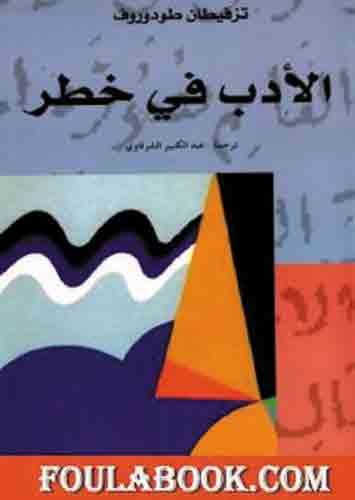الملحق الثقافي:حامد العبد:
يرى الكثير من مؤرخي الأدب أن الناقد الفرنسي ذو الأصل البلغاري (تزفيتان تودوروف) هو أحد أعظم منظري الأدب في القرن العشرين، وكان أعظم إسهام له هو إنشاؤه لنظرية أدبية جديدة عرضها في العديد من كتبه، مثل (مفهوم الأدب) الذي نشره عام 1965 و(مدخل إلى الأدب العجائبي)، كما أسهم مع الناقدين الكبيرين الفرنسيين رولان بارت و جيرار جينيت، في إطلاق حركة نقدية أدبية هي من أقوى الحركات التي عرفتها فرنسا، وكان لها عظيم الأثر في حركة النقد العالمي.
رحل تودوروف عن عالمنا عام 2017 بباريس، ولكن قبل رحيله بسنوات قليلة، لم ينسَ أن يترك لنا تحذيراً (إن جاز التعبير) من المنحى الخطير الذي ينحوه دارسو الأدب المعاصرون، وتراجع مكانة الأدب بين العلوم الأخرى، وجعل هذا التحذير في كتاب سمّاه (الأدب في خطر) نقله إلى العربية عبد الكريم الشرقاوي وصدر عن دار توبقال للنشر في العام 2007، وهذا الكتاب على الرغم من صغر حجمه، إلا أنه مليء بالمعلومات والاستنتاجات التي لا يمكن أن تخطر ببال أحد إلا إذا كان ذا نظرة ثاقبة كتودوروف. وقد جعله أشبه بحوار بينه وبين القارئ مستخدماً لغة سلسة وبسيطة ومستشهداً بآراء العديد من الكتاب والنقاد على مر التاريخ الأدبي الأوروبي.
بدأ تودوروف فصول كتابه بتمهيد أشبه ما يكون بالسيرة الذاتية الفكرية له، بيّن فيه حجم تعلقه بالأدب والكتب منذ نعومة أظفاره، وهو الذي ولد في بيت يمتلئ بالكتب، ذلك لأن والده كان قيّماً لمكتبة عامة، ووصف محاولاته المتكررة في كتابة الشعر والقصة والمسرح والتي لم يرضَ هو نفسه عنها، فقرر أن تكون مهنته هي (الكلام عن الكتب) حسب تعبيره.
في الفصل الثاني المعنون (اختزال عبثي للأدب)، يدخل تودوروف في صلب موضوع البحث، ويبدأ التعبير فيه عن اندهاشه من أن الدور الرفيع الذي كان يسنده للأدب لم يكن الجميع يعترف به.. ومن ثمّ وجه لومه في هذا إلى نظام التعليم المدرسي الذي يقدم فكرة مغايرة للأدب، بسبب نظرة التعليمات الرسمية المؤطّرة له، حيث يقوم مجموع هذه التعليمات على فكرة أن الهدف الأول للدراسات الأدبية هو تعريفنا بالأدوات التي تستخدمها تلك الدراسات، فقراءة القصائد والروايات لا تؤدي إلى التفكير بالوضع الإنساني، بل للتفكير في مفاهيم نقدية تقليدية كانت أم حديثة (في المدرسة لا نتعلم عن ماذا تتحدث الأعمال الأدبية وإنما عن ماذا يتحدث النقاد).
ويتابع تودوروف في الحديث عن دور التعليم في الفصل الثاني الذي عنوانه (ما وراء المدرسة)، وقد ابتدأه بسؤال هو كيف حدث أن صار التعليم المدرسي للأدب على ما هو عليه؟.. وهو سؤال يعكس تحولاً في التعليم العالي، حدث حسب رأيه في الستينات والسبعينات من القرن العشرين تحت راية (البنيوية) التي شارك هو نفسه فيها، وإن كانت ليست وحدها المسؤولة عن هذا التحول، فأثناء الحقبة السابقة التي دامت أزيد من قرن هيمن التاريخ الأدبي على التعليم الجامعي، أي دراسة الأسباب التي أفضت إلى ظهور العمل الأدبي وتأثيرات هذا العمل ووقعه على الجمهور وأثره على مؤلفين آخرين، وبالمقابل ينظر بارتياب إلى دراسة المعنى له فيُعاب هذا العمل عن بلوغ مرتبة العلم. ولم يكن التقليد الجامعي يرى في الأدب تجسيداً لفكر أو تأويلاً للعالم. بعبارة أخرى، العمل الأدبي معروض باعتباره موضوعاً لغوياً مغلقاً ومكتفياً بذاته، وذلك بإقصاء علاقته مع عالم التجربة أو مع الواقع، ويستشهد تودوروف في الدلالة على ذلك أنه خلال بضعة قرون انخفض عدد الطلاب المسجلين في الثانوية العامة الفرنسية بالشعبة الأدبية من 33% إلى 10% حيث شاعت فكرة أن مستقبل خريجي الآداب إما عاطلين عن العمل أو مجرد مدرسي أدب.
أما الفصول الثلاثة اللاحقة فقد حاول فيها تودوروف تتبع أصل و سيرورة الأطروحة الشهيرة التي مفادها:(أن الأدب ليس مرتبطاً بعلاقات ذات دلالة مع العالم، وبالتالي فالحكم عليه ليس له أن يأخذ بالحسبان ما يقوله لنا عن ذلك العالم)، فقديماً كان يُعتبر حسب أرسطو أنه مجرد محاكاة للطبيعة، وأن وظيفته حسب هوراتيوس هي المتعة والفائدة، وسيطلب من الأدب انطلاقاً من عصر النهضة أن يكون جميلاً، ولكن جماله نفسه يتحدد بمقدار إسهامه في الخير، حيث كان المفهوم الأفلاطوني عن الخير هو السائد والقائل بأن الخير المطلق «مكتفياً بذاته».
ولكن مع قدوم عصر الأنوار صار الجمهور هو المالك لمفاتيح نجاح الفن والأدب، وما كان محصورًا بقلّة معدودة، صار في متناول الجميع، وما كان خاضعاً لتراتبية صارمة هي تراتبية الكنيسة والسلطة، صار كل مستهلكيه على قدم المساواة. فروح عصر الأنوار هي روح استقلال الفرد، والفنان صار تجسيداً للفرد الحر وصار عمله الفني أكثر تحرراً، وبات ينظر إلى الأعمال الأدبية كخطاب عن العالم، ولكن كان هناك طريقتان لهذا، طريقة الشعراء وطريقة العلماء أو الفلاسفة ولكل طريقة مزاياها، دون أن تكون إحداها شكلاً أدنى من الأخرى..
طريقتان غايتهما الفهم الأفضل للإنسان والعالم، وصرنا حسب الفيلسوف (جامبتستا فيكو) أمام لغتين، لغة عقلية ولغة شعرية.
مع هيمنة الحركة الرومانسية على الساحة الأدبية، فرض علم الجمال الرومانسي نفسه انطلاقاً من القرن التاسع عشر، حيث كان الفن في رأي الرومانسيين الأوائل هو معرفة للعالم، والمعرفة التي يمكن بلوغها عن طريق الفن تبدو لهم متفوقة على صيغ المعرفة العلمية، فهي بتخليها عن طرائق العقل المشتركة وباتخاذها سبيل الانجذاب، تمنح بذلك منفذاً لواقع ثانٍ، محظور على الحواس والعقل، واقع أشد جوهرية أو أعمق من الواقع الأول، وجملة بودلير الشهيرة تجسد هذا الاتجاه حين قال: «الخيال أكثر الملكات علمية، لأنه وحده يدرك التماثل الكوني.. الخيال سلطان على الحق».
وحسب تودوروف لم تحصل (القطيعة الحاسمة) إّلا في مطلع القرن العشرين، حيث وقعت قطيعة غير معهودة حتى ذلك الحين، ومنذئذ ستُحفر هوّة بين الأدب الجماهيري وهو إنتاج شعبي على اتصال مباشرة بالحاجة اليومية لقرائه، وأدب النخبة الذي يقرأه المحترفون الذين لا يهتمون إلا بالإنجازات التقنية لمبدعيه وحدها، ويبدو أن العهد الذي كان فيه الأدب يعرف كيف يجسد توازناً حاذقاً بين تمثيل العالم المشترك وكمال البناء الروائي قد ولّى وانقضى. هذا التصور الجديد سيظهر لدى الحركات المسمّاة (طليعية)، والتي تجلت للمرة الأولى في روسيا عام 1910، وكانت تلك بدايات التجريد في الرسم والابتكارات المستقبلية في الشعر. وفي الأنظمة الشمولية التي نشأت عقب الحرب مثل روسيا وإيطاليا وألمانيا، وبصورة أقل في بلدان أوروبية أخرى، ستنشأ إرادة لتسخير الفن في خدمة مشروع يوتوبي من أجل خلق مجتمع جديد وإنسان جديد، وتطلب مفهوم الواقعية الاشتراكية وفن الشعب الحفاظ على صلة قوية بالواقع وبالتحديد الخضوع للأهداف السياسية المهيمنة والمناقضة لكل إعلان عن الاستقلال الفني، حيث صار مطلوب من الأدب (الإمتاع قليلاً والتعليم كثيراً)، وسينجرف وراء ذلك عدد مرموق من الفنانين الذين كانت كل أمانيهم معقودة على الثورة. وفي المقابل في البلدان التي يسود فيها حرية التعبير، سيتم خوض معركة ضد هذه التطاولات على استقلالية الأدب. وستكون ردة الفعل أقوى من الفعل ذاته، حيث سيتم التأكيد على أن الفن والأدب لا يقيمان أي علاقة ذات معنى مع العالم، وهذه هي المسلمة المشتركة عند الشكلانيين الروس الذين حاربهم النظام البلشفي، و كذلك الأمر عند المختصين في الدراسات الأسلوبية (المورفولوجية) في ألمانيا، وأنصار النقد الجديد في الولايات المتحدة.
لقد بدا الأمر وكأن رفض تسخير الفن والأدب للإيديولوجيات، يعني القطيعة النهائية بين الأدب والفكر، أو تلاشي كل صلة بين العمل الفني والعالم، وكل طرف يود تقديم خصومه باعتبارهم البديل الوحيد لوجهة نظره، فكان الأدب هو الضحية بينهم، على الرغم من وجود بعض المؤلفين الذين استطاعوا أن يقيموا علاقة بين أعمالهم والعالم دون مخافة أن تُنسب أعمالهم إلى الأدب الشعبي الذي يصنع صيته قرّاءه أكثر من النقاد.
التاريخ: الثلاثاء7-12-2021
رقم العدد :1075