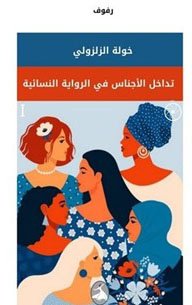الملحق الثقافي- دلال إبراهيم:
الباحثة الأردنية صبحة أحمد علقم تقول في كتابها بعنوان (تداخل الأجناس الأدبية في الرواية العربيةِ، الرواية الدرامية نموذجا ) «منطلق علم تداخل الأجناس قد تكون نظرية أرسطو التي فرقت الأجناس الأدبية إلى قسمين رئيسيين هما: الفن الدرامي والفن السردي، والمقصود بالفن الدرامي أو التراجيدي هو المسرحية، أما الفن السردي فهو إشارة إلى الملحمة.» وتضيف إن الإشكالية التي اعترضت نظرية أرسطو هو ظهور أجناس أدبية عصية على التصنيف كونها لا تنتمي بصورة قاطعة إلى أي من الأجناس الأدبية القديمة، وأبرز تلك الأجناس الرواية التي عدت جنساً أدبياً عابراً للأجناس بما انضوى عليه شكلها الفني من قدرة فائقة على الاحتواء والتبدل، فلقد نهلت الرواية من الأساطير الأقدم وجوداً من التراجيديا والملحمة واستعارت من الملحمة سرديتها القائمة على وجود راو ومن الدراما حوارها الذي يشكل أبرز ملمح نوعي فيها. فلم تعد هناك حدود فاصلة بين الشعري والنثري والروائي والمسرحي والميلودرامي. وفي رحاب ذلك تشكل خطاب أدبي متعدد متنوع، ومنفتح. ولا شك أن التفاعل بين الكتابة والأجناس جعل شعرية الانفتاح أكثر عمقاً. ما يثبت أن الاختصاص جاء لاحقاً مع تقدم البشرية، ورغم ذلك لم تلغ تداخل الأجناس.
ولو عدنا إلى البدايات الأولية للبشرية، لوجدنا أن الانسان كان ينظر إلى الحالة الإبداعية باعتبارها كياناً واحداً، فلو دققنا النظر في النقوش الأولى الموجودة في الكهوف والمعابد، نلاحظ أن ثمة تداخلاً، ولا سيما في النقوش الفرعونية والكتابات الأشورية، فنجد الرسم والنحت وكتابة نص جنباً إلى جنب مع بعضهم. وفيما بعد ومع تطور الإنسان وبدايات تبلور إبداعه كانت رؤيته للعالم هي الرؤية الشعرية. ويرى الشاعر الفلسطيني عبد الرحمن بسيسو أن (الشعرية هي التي تخترق كل الآداب والفنون) بعدها جاءت الأساطير على اختلافها، ولا سيما اليونانية، مثل الإلياذة والأوديسة، حيث نلاحظ في النص نفسه الشعري والسردي والطقسي والمسرحي والحكائي. وحتى الأدب الجاهلي لدى العرب ارتبط الشعر فيه بحكاية وقصة. ولاسيما على يد الشعراء الصعاليك، إذ اتخذوا السرد بنيةً لشعرهم رغم كون السرد خصوصية نثرية، حتى أطلقوا عليهم اسم «روّاد القصة الشعرية في الأدب العربي» ومن شعراء عصرنا ممن سرد في الشعر الشاعر نزار قباني في قصيدة «المجد للضفائر الطويلة» وقصيدة «البنت الصرخة» لمحمود درويش.
بينما يستهل المؤلف حسن عليان كتابه (تداخل الأجناس البشرية) بمقدمة يشير فيها إلى أن منجز الثقافة العربية عبر تاريخها الطويل تشتمل على تداخل أنواع أدبية وأشكال من السردية والشعر القريب من القصة بشكل أو بآخر في تداخل مع غيرها من الحكايات الشعبية والأمثال والحكم والأساطير إضافة إلى موروث القصص والأحداث التاريخية التي بات من الصعوبة بمكان تحديد طبيعة الأدب في كل منها.
ويوضح أن التداخل في الأجناس الأدبية نتج عنه المزيد من الوعي والمعرفة بالشعر والدراما وأيضاً في توظيف بنية المسرحية في القصيدة الشعرية، وصولاً إلى تداخل كتابة السيرة بالقصيدة في حقل إبداعي آخر هو الدراما الشعرية، لافتاً إلى أن تجليات وظائف الدراما في الشعر والقصة والرواية تنهض على أصالة الموقف الدرامي في الإدراك والإحساس الجمالي.
من جانبها، الكاتبة لينا حشنة في مداخلة بعنوان «عبر النوعية تجاوز للواقع وتمرد على أشكال السلطة»، تطرقت إلى موضوع الحداثة وإنه- من وجهة نظرها- من ملامح الحداثة وما بعدها رفض الضوابط، فالحداثة رفض لكل أشكال السلطة بما فيها سلطة الأدب، وهي مناخ الحرية والتساؤل، وخلخلة الأجناس الأدبية، حيث تحول النص الأدبي إلى أفق مفتوح يهدم الحدود الفاصلة بين الأنواع ويرفض قالب النموذج الأبوي الصارم ونظرية الجنس الواحد، متمرداً على شكله الكلاسيكي.
وتابعت: صارت الأجناس الأدبية تستلهم من بعضها وتندمج وتتداخل فتخلت عن نقائها النوعي، وماعت حدودها وتزعزعت حتى بتنا نتحدث عن اصطلاح أدبي أطلقه «أدوار الخراط» يسمى الكتابة عبر النوعية وهو يعني الكتابة التي تسقط الحدود بين الأنواع، مشيراً إلى أن المواصفات التقليدية والحدود القاطعة بين كل فن وفن قد تهاوت وبات كل فن يستفيد من منجزات الفنون الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تلاقح الأجناس كالشعر مع النثر، فظهرت القصة القصيرة، والرواية الشعرية وتلاقحت الرواية بالمسرحية فظهرت «المسرواية» واندمجت الرواية بالسيرة الذاتية فظهرت رواية السيرة الذاتية، واندمجت الرواية كذلك بالفنون التشكيلية والسينمائية والحكاية الشعبية وغيرها.
أي بمعنى أن مفهوم التداخل هذا نقلنا إلى شكل أدبي واحد فيه مجموعة أشكال، ومع ذلك فإن هذا النوع من الكتابة (المركبة) إن جازت العبارة لم يتموضع بوصفه جنساً أدبياً مستقلاً، ولم يشكل حتى الآن (ظاهرة) كتابية في حد ذاتها. صحيح هناك «نثريات» شعرية سردية حوارية، ولكنها مجرد «متفرقات» مكتوبة بلا هاجس مهم في الكتابة وهو «المشروع».. إنها محاولات، ولكنها ليست مشاريع.. ولكن السؤال المهم هنا.. هل يمكن إدراج هذا النوع من الكتابة في إطار التجريب؟
لا شك أن كل تجريب هو انتقال من حالة أدبية أو فنية أو إبداعية ثابتة أو راكدة أو جامدة إلى حالة متحركة، متنقلة، متحولة.
يعكس التجريب في الأدب والفن، أيضاً، حالة من التشبع وصل إليها جنس أدبي معين، بحيث يتطلب من الكاتب أن يتخلص من هذا التشبع، وينتقل إلى حالة إبداعية حيوية وجديدة.
والواقع أن أكثر من سبب يدفع الشاعر أو الروائي أو المسرحي أو الفنان التشكيلي إلى التجريب، وأكثر من بيئة له، لكن الأغلب أن وراء كل تجريب حتى في العلوم وليس في الآداب فقط، ثمة ثقافة عميقة يمتلكها «مغامر» التجريب، مع أن التجريب ليس مغامرة، بل هو فكر متدرج، واستجابة موضوعية للبيئة الثقافية المحيطة بالأجناس الأدبية والمكونة لها من مرحلة ثقافية إلى مرحلة أخرى.
ربما أن التحرر من كافة القواعد والقيود جعل الكثيرين يستسهلون الكتابة، الأمر الذي نتج عنه كتابات خاوية وساذجة فكرياً وفلسفياً وفقيرة إبداعياً وفنياً. كتبات نابعة عن جهل بالموروثات الأدبية والثقافية، بالتأكيد سوف تنتج الوهم والخواء والكتابات الساذجة.
وبالتالي فإننا نقول: ليكن هنالك تداخل أجناس، ولتكن هنالك قصة من سطر أو سطرين، ولتكن هنالك قصيدة تقوم على الحكاية كما هي القصة نفسها. ولكني فقط نأمل أن كل ما يمكن أن يكون جديداً بحق، هو ما يحمل في طياته تطوراً فنياً وإضافة جمالية ومعرفية في آن واحد.
العدد 1127 – 10-1-2023