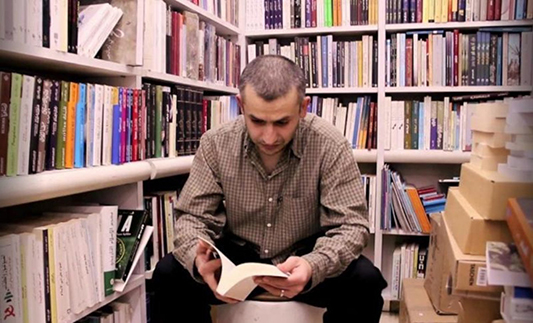الملحق الثقافي- دلال ابراهيم:
حينما نزلت الشابة الريفية مرتا حداد من الباخرة قادمة من جبل لبنان (سورية الكبرى) ولمحت تمثال الحرية على الأطلسي في مدينة نيويورك ظنته أنه تمثال للعذراء ( فدمدمت صلواتها وهي تنزل من الباخرة إلى «إليس أيلاند» المهاجرون تدافعوا على «السقالة» الخشب وهي تمسّكت بحبال الدرابزين ورأت جرذان الماء تقفز من الصناديق إلى الأرصفة.. المبنى الضخم المتربع على الجزيرة ابتلع البشر المتدفقين كالأنهار من البواخر: أين يختفون؟ لا يغرقون في الضباب، لكنهم يغيبون).. ومن هنا يبدأ الروائي ربيع جابر سرده لأحداث الهجرة الكبرى للسوريين من بلاد الشام إلى أميركا منذ نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، حينما صارت تقاليد تلك الهجرة راسخة لعقود ممتدة.. في روايته تلك (أميركا) يحكي الكاتب بصورة تفصيلية وقائع تلك الهجرة ورحلة العمالة السورية التي استقر بها الحال في مصانع النسيج، ومنهم من عمل باسم الكشاشين ( الباعة المتجولين ) ويحكي كيف استطاع المهاجرون نقل بلادهم وإرثهم الثقافي إلى ( الحي السوري ) في قلب نيويورك. غادرت مرتا حداد منزلها الريفي في جبل لبنان إلى المجهول ..تحمل ذكرياتها وحياتها في كيس في عام 1913.بحثاً عن زوجها الذي هاجر إلى أميركا وانقطعت أخباره عنها فجأة وبعد عام قررت أن تهاجر ( قلبها سيفقع ) بينما جموع المهاجرين الذين رافقتهم في الرحلة فقد كانت وجهتهم البحث عن الرزق بعدما انهكتهم الفاقة والعوز والجوع في بلادهم.. يدعي جابر أن أحداث روايته وشخوصها هي ( محض خيال ) إلا أنه استشهد بأحداث تاريخية حقيقية.. وشخصية مرتا حداد وعلي جابر موجودة في سجلات « إليس أيلاند « وبالتالي فقد صنع ربيع جابر من شخصيات تاريخية عالمه الروائي المتخيل.. ويصف بدقة البضائع التي كان يبيعها الكشاشون وأسعارها وماذا كان يحمل المهاجرون في حقائبهم أثناء رحلة الهجرة، وكل تلك التفاصيل نشرت عنها الصحف حينها تقارير بالرجوع إلى أرشيفها.
وفي روايته (الحي اللاتيني) يروي سهيل ادريس سفر مجموعة من الشبان من لبنان إلى فرنسا بنية الدراسة، ولكن وبمجرد وصولهم إليها رموا أنفسهم في أحضان العهر والخمر والمجون، وتخلوا عن الثقافة التي تربوا عليها باستثناء بطل الرواية الذي خرج من حياة الشوارع وفتيات الليل، بعد أن عثر على فتاته الشقراء المنشودة وعاش معها قصة حب متبادلة ولما جاء بزيارة لأمه في بيروت وأخبرته صديقته أنها حامل منه، استنكر الأمر وطالبها بالتخلص من الجنين، ولدى عودته باريس وإبداء رغبته بالاعتذار وعودة العلاقات بالزواج رسمياً رفضت عرضه وقالت مقولتها « عد أنت إلى شرقيتك واتركني أنا هنا أكمل طريقي في موطني».
أما يحيى حقي وفي روايته « قنديل أم هاشم « التي ارتبط اسمه باسمها وغطت عن كل أعماله يقول عنها « إننا إذا عدنا إلى الخلف سنجدها في كتابات عبد الله النديم الذي يتحدث في أحد النصوص عن شاب مصري يسافر إلى أوروبا لينقلب كل شيء في حياته وهذا ما حدث في « قنديل أم هاشم « فعندما عينت في السلك الديبلوماسي وجدت فرقاً شاسعاً بين هنا وهناك، فكتبت أصور شاباً مصرياً يتغير ويتبدل وتعيد الغربة تشكيله ليعود إلى وطنه وقد فقد هويته، فيحاول أن يشق طريقه وهو غريب عن مصر لم يعد مرة أخرى إلى الانتماء فيفتح الله عليه».
ويتناول علي مصباح في روايته « سان دني « مشكلة الهوية والانتماء لجيل عريض من دول شمال أفريقيا، أولئك الذين كانوا يلقون بأحذيتهم في البحر ( إشارة اللاعودة ) يخوضون من خلالها معركة الهوية والانسجام وفرض الذات من جهة، والانتقام من الآخر ( الفرنسيين/ المرأة / المجتمع ) من جهة أخرى..يحكي «عن التخبط والضياع الذي تعيشه النخب ممزقة بين وطن يمد يده مستجدياً وبلاد ظنوها جنة فإذا بها تشقبلهم في حاناتها أعواماً دون أن ينالوا منها شيئاً «.
فاروق يوسف، الكاتب العراقي، من جانبه جمع أنواعاً أدبية في كتابه ( أصوات الغابة ) يسرد فيها حياة لاجىء عراقي عاش في الغابات الأسوجية أو الغابات السويدية.. ولكن تناغم البطل مع الطبيعة الأم واستغراقه فيها لم يحل دون العودة إلى أمه الطبيعية في بغداد فيرسل لها رسالة طويلة من الغابة تشكل إطاراً للتذكر والحنين والبوح وتتكشف عن مركزية موقع الأم في حياته وتأرجحه بين شوقه إليها وعجزه عن العودة لأن العراق لم يعد العراق وهو لم يعد نفسه.. وتجاذبه بين أم بيولوجية لا يستطيع العودة إليها وأم طبيعية لا يقوى على مغادرتها.. يدفن في الغابة اغترابه، ويتناغم معها إلى حد التوحد.
وأيضاً مع العراق ومع الكاتب صموئيل شمعون وروايته (عراقي في باريس ) التي بناها وفق إطار من الفطنة والفكاهة والسخرية، تشبه إلى حد ما حكايات شهرزاد.. يحكي فيها قصة جيل كامل من الشباب الذين دمرت حياتهم الإيديولوجيات التي هيمنت عليه.. وضمن سرد أشبه بالسيرة الذاتية يحكي عن رحلة التشرد وتعدد الثقافات التي تنشأ للأقليات العرقية والمهاجرين والمشقة والعناء التي يلقاها المهاجر مع الثقافة الجديدة.. أي أيضاً الطرق على مشكلة الهوية والانتماء ومشكلة الاختلاف التي تصل أحياناً حد التناقض.. وتتطابق أحوال المهاجر لديه مع ما أشار إليه كل من إدوارد سعيد وحسين البرغوثي في كتبهم عن الإقامة القسرية والسفر القسري، حيث أظهر أدب المنفى إنساناً عربياً جديداً يشمئز من كل ثبات واستقرار وانصهار في انتماء واحد ليكون الإنسان العربي شديد الحرص على الاهتمام بصراعه مع الهوية.. وهذا ما أشار إليه الكاتب حسين البرغوثي في روايته « سأعيش بين اللوز « عندما يفقد أحد ماضيه تماماً، تستطيع أن تصنع بمستقبله ما تشاء، لأنه قد فقد « ظله» الممتد في التاريخ .»
ولا بد هنا وفي حديثنا عن الهجرات والتوق إلى حياة جديدة في عالم ينشد فيه الشباب حياة الحرية والعيش الكريم.. أن نتطرق إلى رواية الطيب الصالح « موسم الهجرة إلى الشمال « يتحدث فيها عن التقاء الغرب والشرق في شخص واحد ينتقل من القرية إلى الغرب.. يقول وهو يصب جام غضبه على هذا الغرب اللعين، الذي خابت آماله فيه «» إنني أسمع في هذه المحكمة صليل سيوف الرومان فى قرطاجة، وقعقعة سنابك خيل اللنبي و هي تطأ أرض القدس، البواخر مخرت أول مرة تحمل المدافع لا الخبز، وسكك الحديد أنشئت أصلاً لنقل الجنود.. و قد أنشأوا المدارس ليعلمونا كيف نقول «نعم» بلغتهم.. إنهم جلبوا إلينا جرثومة العنف الأوروبي الأكبر الذي لم يشهد العالم مثيله من قبل في السوم وفي فردان، جرثومة مرض فتاك أصابهم منذ أكثر من ألف عام.. نعم يا سادتي، إنني جئتكم غازياً فى عقر داركم.. قطرة من السم الذي حقنتم به شرايين التاريخ.. أنا لست عطيلاً.. عطيل كان أكذوبة».
ونعود إلى المشهد الأول من الرواية التي بدأنا بها» أميركا « حينما وقفت بطلة الرواية « مرتا حداد « تقول من على ميناء « إليس أيلاند « وهي تصلي كي لا تضع عليها المرأة التي ترتدي زي الشرطة علامة ( X ) وتَعيدها إلى المركب من حيث أتت « لا شك أنها تريد أن تسألني : ما الذي أتى بك أيتها المسكينة من آخر الدنيا إلى آخرها الآخر الذي لا تعرفين فيه أحد ولا تتحدثين حتى لغته؟!»
لا أظن في الوقت الحالي سيطرح أي أحد هذا السؤال على أعداد المتدفقين في سفر الشتات صوب الشمال الغني قادمين من جنوب فقير منهك جوعاً وقهراً وخوفاً..
العدد 1154 – 8-8-2023