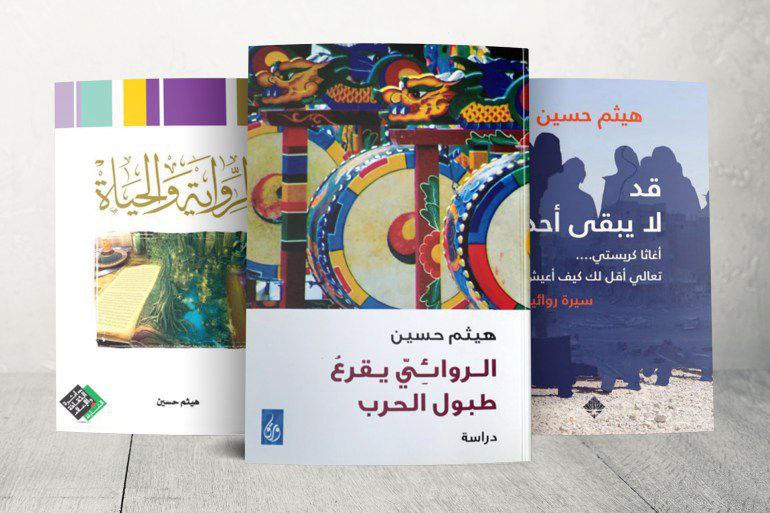الثورة – أحمد صلال – باريس:
حين تُطرَح أسئلة الرواية في السياق السوري، يصعب تجاهل التجربة التي خاضها الروائيّ السوريّ هيثم حسين، بما فيها من مكابدة شخصية، وتأمّل نقدي، وإصرار على مساءلة اللغة والواقع معاً.. رواياته وسِيَره لا تكتفي بالحكي، إنما تنقّب في طبقات الخسارة، وتُراكم معارفها من الألم والقراءة والعبور بين الأمكنة التي تهدّمت، والأزمنة التي لم تعد تُستعاد.
في هذا الحوار، يتوقّف الروائي حسين المقيم في لندن، عند ما يُتداول تحت عنوان “الرواية الجديدة”، ويتناول علاقتها بالشكل والمعنى، كما يتأمّل موقع الرواية السورية في زمن تضاعفت فيه الإصدارات وتراجعت فيه المساءلة.
– دعنا نبدأ هكذا، لماذا ترى أن الروائيين السوريين لم يستوعبوا جيداً مفهوم الرواية الجديدة؟
لا أتبنّى هذا الطرح، ولا أرى في التعميم مدخلاً لفهم الحالة الروائية السورية، كثير من التجارب وقفت عند حدود الشكل، من دون أن تخوض مغامرة المعنى، أو تُراجع البنية الروائية بما يتّسق مع التحوّلات المعرفية والوجودية واللغوية التي يفترض أن تواكب كلّ مشروع كتابة.
وبعض الكتّاب تعاملوا مع مفهوم التجديد كسلعة، وراحوا يرفعون لافتات الخلخلة، والابتكار، وكأنّها بطاقات عبور إلى نادي الحداثة، تُرفع هذه الشعارات من دون جهد حقيقي في مساءلة الموروث، ومن دون غوص فعلي في تجربة اللغة، ولا احتكاك صادق مع التقاليد السردية التي تشكّلت داخل السياقات الثقافية والاجتماعية والسياسية، لا يمكن للكاتب أن يتوهّم القطيعة التامة مع الإرث الروائي، تماماً كما لا يمكنه أن يغرق في التكرار المطابق، العلاقة مع الموروث الروائي تظل علاقة توتر دائم، اشتباك، حوار داخلي، إعادة تأويل، وما لم يكن هذا الاشتباك حقيقياً، يتحوّل التجديد إلى قناع، والخلخلة إلى ادّعاء.
– أحياناً يحسّ القارئ أن الروائيّ السوريّ الجديد صار مشغولاً ببعض الألاعيب السرديّة على حساب الكتابة، هل يدخل هذا الأمر في سياق سوء فهم للرواية الجديدة؟
ما يُسمّى بالألاعيب السردية لا يكون مشكلة في ذاته، إنّما في التوظيف السطحي لها، حين تُستخدم تقنيات الرواية كزينة لغويّة أو تورية شكلية، يصبح النص مجرّد استعراض للقدرة على التلاعب لا أكثر، في العمق، الرواية لا تُقاس بقدرتها على المراوغة، إنما بصدق التجربة، وعمق الغور، وتماسك البناء الداخلي، في بعض التجارب السورية، حصل افتتان بالتقنية على حساب الفكرة، أو بتمزيق الزمن على حساب وحدة الإحساس، الكاتب يريد أن يُثبت حداثته من أول نصّ، من دون المرور بمخاض التجربة، ومساءلة اللغة، والانكسار الداخلي الذي تنتجه الكتابة الحقيقية.
التجديد لا يُطلب كبرهان، إنما يتحقق حين يُحسّ الكاتب أنّ الشكل القديم لم يعد يستوعب ما يريد أن يعبّر عنه.
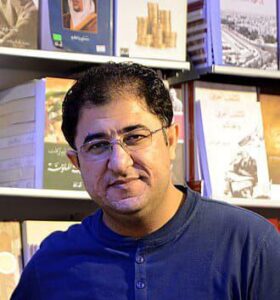
– تاريخ الرواية السوريّة قصير جداً قياساً مع أوروبا مثلاً. هل ساهم هذا العامل سلباً في مستوى نضج الرواية العربية؟
الفارق الزمني موجود، لكنه لا يصلح أن يكون مبرّراً للقصور أو ذريعة للتقليل من المنجز، الرواية الأوروبية نشأت في سياق طبقي ومعرفي مختلف تماماً، ومرّت بتحوّلات كبرى تراكمت عبر قرون من التمدّن، والصناعة، والثورات الفلسفيّة.
في المقابل، الرواية العربية، ومنها السوريّة، جاءت غالباً من همّ فردي، ومن استجابة لمآزق سياسية واجتماعية خانقة، الزمن وحده لا يصنع نضجاً، ما يصنعه هو تراكم التجارب، وتوفّر مناخ حرّ للنشر، وتقاليد قرائية ناقدة، ومؤسسات تحتضن المشروع السردي بصفته ضرورة لا ترفاً، غياب هذه العناصر يخلق فجوة ليست في عدد السنين، إنّما في الوعي المتاح حول وظيفة الرواية، ودورها في مساءلة الواقع، لا تجميله أو تهذيبه، النضج يقاس بالقدرة على فتح مغاليق التجربة، والاشتغال الصبور على التفاصيل.
– كيف تقرأ الرواية الراهنة في النتاج السوري؟ هل نحن فعلاً أمام تحوّل أدبي، أم إن ما نعيشه هو فقط وفرة في الكتابة؟
أعتقد أنّ ما نشهده أقرب إلى وفرة منه إلى تحوّل، هناك زخم في عدد الروايات، وتعدد في الأصوات، لكنّ التحوّل يتطلّب أكثر من الكمّ، لا يكفي أن تتراكم الإصدارات، ولا أن تتنوّع المواضيع، حتى نقول إنّنا في لحظة انعطاف سردي، التحوّل يحصل حين تتغيّر النظرة إلى الكتابة، حين تُهدم الأسس المتكلّسة، ويُعاد التفكير في اللغة، وفي حدود الحكاية، وفي تمثيل الذات والجماعة، كنا في مرحلة الرواية التي تصف وتؤرّخ، ثم صرنا في طور الرواية التي تندّد وتدين، ما نفتقده الآن هو الرواية التي تُفكّك وتُشكّك وتعيد تركيب وعي مغاير، هناك محاولات فردية ناضجة، وهناك أصوات تستحق التوقّف عندها، لكنها لم تتحوّل إلى تيار، ولم تحظَ بدعم نقدي أو مؤسساتي يجعلها تُثمر على المدى الطويل، نحن في مرحلة انتقال، ولسنا بعدُ في تحوّل مكتمل.
– هل فعلاً أثرت الجوائز العربية الجديدة في مضامين الرواية السورية وساهمت بالتالي في توجيهها؟
الجوائز حاضرة في الوعي الكتابي، وأثرها لا يمكن إنكاره، هناك كتّاب يكتبون وعيونهم على قوائم التصفية، وآخرون يكيّفون مواضيعهم وأصواتهم وفقاً لما يتوقّعون أنه سيلقى القبول، الجوائز منحت بعض الكتّاب فرصاً، وفتحت أبواباً للنشر والقراءة، لكنها أيضاً أرست ذائقة محدّدة، وشجّعت في جوانب منها نمطاً من الكتابة السريعة القابلة للتداول، لا للتأمّل الطويل، والرواية التي تُكتب من أجل الجائزة تميل إلى المسالمة، إلى المسايرة، إلى محو التوتر الحقيقي بين الكاتب ونصّه، أما الرواية التي تُكتب من قعر المعاناة، فغالباً ما تُقصى، أو تُتهم بالتعقيد، أو تُقرأ بعين خائفة، الجوائز ليست المشكلة، إنما آلية التلقي المرتبطة بها، والثقافة التي تجعل الكاتب يقيس أثره من خلالها فقط، وهي، من المفترض، أن تكون حافزاً، لا معياراً.
– ما أثر النقد في الوسط الأدبي والثقافي السوري بعامّة؛ برأيك؟
النقد تراجع كثيراً، سواء في المنابر أو في التأثير، أصبح ملحقاً تابعاً لا رافعة، كثير ممّا يُكتب الآن أقرب إلى ملخّصات مديح، أو تلخيصات مبسّطة للنصوص، لا وجود لحوار نقدي متماسك، ولا لمؤسسات نقدية تستقطب التفكير المستقل، غابت المدرسة، وغاب الامتداد، وظهر عوضاً عن ذلك التباهي المعزول بالرأي، لكن في المقابل، لا يمكن اعتبار النقد انتهى، هناك أصوات، في الصحافة الثقافية وفي الجامعات، تحاول إعادة الاعتبار للقراءة العميقة، ولبناء أدوات مناسبة لهذا الكم الهائل من الإنتاج الروائيّ، ما يحتاجه النقد اليوم هو أن يتحرّر من التبعية، ومن المجاملة، وأن يستعيد موقعه بوصفه فعلاً معرفياً، لا ملحقاً تجارياً أو أخلاقياً.
– ما مصادر إلهامك لكتابة الرواية؟
المكان مصدر دائم للإلهام، وخصوصاً المكان المهدّد، المنسيّ، المشوّه، كل كتابةٍ عندي تبدأ من خسارة وفقد، من محوٍ لا يزال يحدث حتى اللحظة، بيتي الذي كنت أظنّه حصناً لي في الغوطة الشرقية، دُمّر بالكامل على يد النظام المخلوع، كأنّه لم يكن.. الأمكنة التي نشأت فيها تمّ نفيها من الجغرافيا، وأصبحت أنا نفسي مهدّداً بالتحوّل إلى ذكرى، لم أغادر سوريا إلى منفى، إنّما طُردتُ من العالم الذي كنت أكتبه، من التفاصيل التي كنت أحتفظ بها ككنز شخصي، وكلّ نصّ أكتبه هو محاولة لاستعادة هذه الأمكنة، لا كما كانت، إنّما كما بقيت في الذاكرة، وكما تتشوّه بفعل المسافة والخراب، الأمكنة بأناسها وحراكها وما يمور فيها ترسم ملامح أعمالي بتحوّلاتها، بكونها دائماً مهدّدة أو معلّقة أو منقوصة، واللغة وحدها تبقى الملاذ، لكنها أيضاً لا تخلو من الخيانة، لأنها لا تُعيد ما فُقد، إنما تُحوّله إلى أثر، إلى مجازٍ هشّ، أكتب كي لا أنسى، وكي لا يتحوّل الفقد إلى عادة، وكلّ جملة أكتبها أشعر كأنني أستعيد بها زاوية من بيت مدمّر، نافذة منسيّة، أو ظلّ شجرة كانت تنمو خلف ظهري ولم أنتبه إليها.