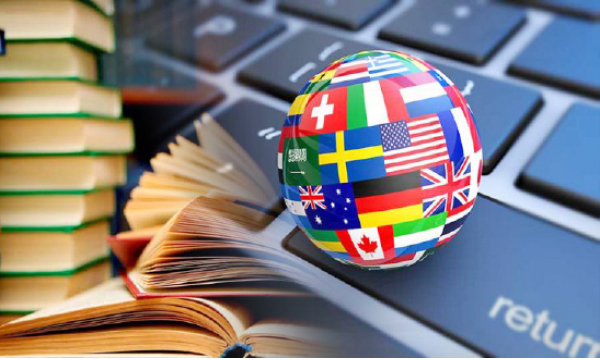الثورة _ رنا بدري سلوم:
الترجمة وجه آخر للنص، تكشفه وتجمّله، فماذا عن إحياء روحه؟ وهل المترجم وسيطاً للأفكار؟ هل يجوز له أن ينقل ما يتنافى مع قناعته؟ يقول المثل الإيطالي “المترجمون خائنون” ما رأي المترجمين وما هي المبادئ الأساسية التي يتّبعونها في اختيارهم الكتاب الذين يريدون ترجمته؟ وماذا تحتاج الترجمة اليوم؟.
“الترجمة شبيهة ببناء الطرق، كإنشاء جسور بين الثقافات المتنوعة” بحسب الدكتورة زبيدة القاضي أستاذة النقد الأدبي والأدب المقارن والترجمة، والتي طرحت عدّة أسئلة: هل الترجمة نقل أم إبداع؟ وبتعبير آخر هل الترجمة نقل للأفكار من لغة إلى أخرى؟ أم إبداع يقوم به الكاتب في الترجمة للنص الذي ينقله من لغة إلى أخرى؟ وهنا تطرح عضو اتحاد الكتاب العرب جمعية الترجمة، مسألة الأمانة والخيانة في الترجمة، وهو ما يجعلنا نبحث في مفهوم الترجمة عبر العصور.
أيها المترجم بكلّ اللغات
يقول المثل الإيطالي: (أيها المترجم.. أيها الخائن) والمقصود هنا المترجم الذي كان يترجم للجيوش التي احتلت إيطاليا وليس جميع المترجمين حول العالم، وفقاً لعضو اتحاد الكتاب العرب جمعية الترجمة حامد العبد.
” كلام أرستقراطي” لا يعرف المهنة وآليات عملها وإن مقولة المترجم خائن، هو كلام من الماضي وفقاً لعضو اتحاد الكتاب العرب، مقرر جمعية الترجمة حسام الدين خضور فبرأيه لقد تطورت الترجمة كثيراً في السنوات الخمسين الأخيرة، وصار بمقدورها أن تتجنب كثيراً من أخطاء الماضي.
أما الترجمة في النموذج الفرنسي فقد اعتبرت ولسنين طويلة نوعاً ثانوياً إذ لم تكن الترجمة إعادة إنتاج، بل تقليداً، ونقلاً من لغة إلى أخرى، ومن ثقافة إلى أخرى، بكل التحولات اللازمة لهذا الانتقال إذ لم يكن المقصود استقبال الآخر و احترام شخصيته، بل إدماجه في ذوق الآخرين وثقافتهم لذلك فإن الأمانة للنص الأصلي لم تكن مطلوبة في الترجمة بحسب رئيسة قسم اللغة الفرنسية الدكتورة زبيدة القاضي بل كان من المناسب تقديم نص ينسينا الأصل ،لاسيما إذا احتوى على خصوصيات صادمة أو مخالفة لقواعد اللياقة، ولا تتفق مع القيم الجمالية المنتظرة، كان على المترجم أن يحسّن النص الأصلي، ويجمّله وأن يمنحه جنسية البلد المستقبل وهنا يمكننا أن نتحدث عن خيانة النص الأصلي وبذلك لا يعد المترجم ذاته مترجماّ بل كاتباً مشاركاً يعيد كتابة العمل أكثر مما يترجم ويسعى إلى إثارة الإعجاب في لغته الأم. لكن الوضع تغيّر في العصر الحديث، وفقاً للدكتورة القاضي وأصبح المترجمون أكثر اهتماماً بأمانة النص وعبقريّة الآخر، وبدأ المترجم يهتم بالغريب والعادات والأسلوب المميز بعيداً عن ذوق المتلقي وسعياً في الحفاظ على خصوصيّة النص الأصلي وغرابته، وهذه هي الأمانة في الترجمة التي تجعل المترجم قادراً على تقديم معادل للنص الأصلي، فتصبح الترجمة طريقة تبني ثقافة أخرى، يمكننا اليوم أن نسميها بالطريقة الاكتشافية، إذ اتجهت البحوث إلى السعي لاكتشاف الآخر، بكلّ ما هو وما يحمل من تشابه واختلاف مع المكتشف وهذا النهج التثاقفي ضروري لأنه قادرعلى امتصاص ” الهوية الثقافية” وتحويلها إلى اكتشاف هادىء لثقافة الآخر واحترام ما يمثله من عادات وقيم مختلفة.
روح النص وهيكله
“إذا لم تنقل الترجمة روح النص فإنها لن تكون ترجمة”، بحسب مقرر جمعية الترجمة في اتحاد الكتاب العرب حسام الدين خضور فبرأيه الترجمة تنقل النص المصدر إلى نص هدف شكلاً ومضموناً. النصان لا يتطابقان لأنهما في لغتين مختلفتين، لكن النص -شكلاً ومضموناً- هو نفسه في لغتين. إذا كان نثراً فسيكون نثراً في النصين، وإذا كان موزعاً إلى أجزاء وفصول، فسيكون التوزيع نفسه في النصين، وإذا كانت ثمة أسئلة في النص الأصل فستظهر في النص الهدف في المكان نفسه تماماً، مضيفاً أن هوية النص الأصل ستكون هي نفسها في النص الهدف، هذه ألف باء الترجمة. المترجم ناقل ذكي يعرف اللغتين ويعرف كيف تعبران عن الشيء نفسه كلّ بمفرداتها من دون زيادة أو نقصان.
فيما تشير أستاذة النقد الأدبي والأدب المقارن والترجمة الدكتورة زبيدة القاضي إلى أن الترجمة تكون إبداعية، عندما يتمكن المترجم في الحفاظ على روح النص، وإعادة إنتاجه بلغة أخرى، فيصبح نصاً جديداً بأسلوب جديد مع الحفاظ على ثقافة الآخر وخصوصيته.
من جهته بين عضو اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينين جمعية الدراسات والبحوث والنقد حامد العبد أنه بقدر ما يبتعد المترجم عن الترجمة الحرفية والآلية، بقدر ما يستطيع أن ينقل روح النص. كما ويفترض بالمترجم أن يكون على قدر معقول من الثقافة والموضوعية حتى يتمكن من استيعاب، أو حتى الوصول إلى روح النص.
المترجم وسيط
برأي رئيس تحرير مجلة جسور ثقافية الأديب خضور، ليس دور المترجم أن ينقل الأفكار وحسب، دوره أن ينقل النص، شكلاً ومضموناً، بكلّ ما يحمله من أفكار، وصور، ومواقف، وعواطف. ويشبّه خضور المترجم بالرسام الذي يعيد رسم لوحة، فينقلها بأبعادها وألوانها وظلالها وخطوطها. طبيعي الكتابة ليست رسماً. وإذا جاز القول :إنها ترسم بالكلمات، فإنها ترسم بكلمات لغتين مختلفتين، والنتيجة واحدة تولد لدى المتلقين في اللغتين التأثير نفسه، وإذا لم تفعل ذلك فهذا يعني أنه يوجد خلل ما في الترجمة يتحمّل المترجم مسؤوليته.
فيما يعتقد العبد أن المترجم لا يستطيع إلا أن يكون وسيطاً للأفكار، فالقارئ حين يقرأ عملاً مترجماً، فهو علم بذلك أم لا يقرأ أفكار المؤلف والمترجم معاً، والدليل على ذلك أنه حين نقرأ عملاً له عدّة ترجمات، فإننا نصل إلى استنتاجات متعددة.
أخلاقيّات الترجمة
هل يجوز للمترجم أن ينقل ما يتنافى مع عقيدته وقناعاته؟
برأي الأديب حسام الدين خضور ليس للمهنة عقيدة أو قناعات، لكن من الطبيعي أن يكون للمترجم عقيدة وقناعات كأحد البشر. وثمة منظومة أخلاقية لكلّ مهنة نابعة مما توافق الناس عليه، تحميها الأنظمة والقوانين، مثل الكراهية والتعصّب والقتل وغيرها من أشياء هي واحدة في القانون الأخلاقي للمهنة، لا يمارسها المترجم، ولا يجوز له أن يمارسها، بل يحاسبه القانون إذا فعل ذلك.
بينما يرى العبد أن المترجم ليس مسؤولاً عن الأفكار التي يترجمها حتى لو كانت تتنافى مع عقيدته، و يفترض به التزام الحيادية قدر الإمكان.
أما عن المبادئ التي يتّبعها المترجمون في اختيار الكتاب للترجمة، يختار خضور الكتاب الذي يوفّر للقارئ المتعة المعرفية والفنية. وهذه مسؤولية مشتركة بين المترجم والناشر سواء كان عاماً أو خاصاً. والطرف الضعيف في هذه المعادلة هو المترجم. المترجم يعمل في مهنة لا يستطيع أن يفرض المادة التي يرى أنها جيدة، وترفع مستوى القارئ معرفياً وتنمي ذوقه الجمالي وتعزز التزامه الأخلاقي يمثل الخير والحبّ والجمال والسلام وفقاً لخضور، الذي ترجم عشرات الكتب في الأدب والعلوم الإنسانية. بينما يترجم الباحث حامد العبد الكتب التي لم تترجم سابقاً، وهو الحاصل على جائزة سامي الدروبي للترجمة عام ٢٠٢٢، فهو يجد في تلك الكتب قيمة فكريّة دسمة، التي تشكّل إضافة وإغناء للمكتبة العربية، وهو لا يولي أهمية كبيرة لمتطلبات “السوق” التي غالباً ما تكون سطحية برأيه.
ماذا تحتاج الترجمة ؟
الترجمة عند مقرر جمعيتها حسام الدين خضور عامل حاسم في نهوضنا الوطني، وفي أي عملية تنمية حقيقية، وبالتالي لننهض لا بد من وضع خطّة وطنيّة شاملة يكون للكتاب العلمي والتفكير النقدي حصّة وازنة فيها، يضعها ويديرها مركز وطني للترجمة.