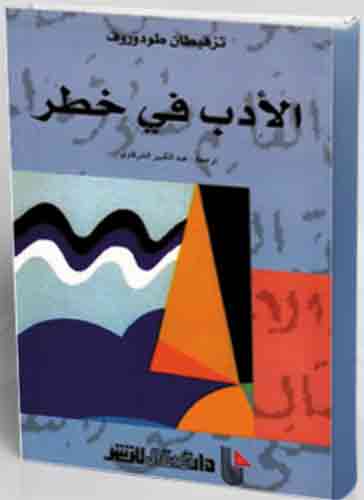الملحق الثقافي:هفاف ميهوب:
«لو ساءلتُ نفسي اليوم، لماذا أحبُّ الأدب، فالجواب الذي يتبادر عفوياً إلى ذهني هو، لأنه يعينني على أن أحيا… لم أعد أطلبُ منه، كما في الصِبا، تجنيبي الجراح التي قد تصيبني، من لقائي بأشخاصٍ حقيقيين.. إنه عِوَض استبعادِ التجارب المعيشة، ويجعلني اكتشف عوالم على اتصالٍ بتلك التجارب، ويتيح فهماً أفضل لها، ولا أعتقد أنني وحدي أنظر له بهذه النظرة، فالأدب الأكثر كثافةً وإفصاحاً من الحياة اليومية، يوسّع من عالمنا ويحثّنا على تخيّل طرائق أخرى لتصوّره وتنظيمه.. نحن مجبولون من كلِّ ما تمنحّنا إياه الكائنات البشرية الأخرى، والِدانا أولاً، ثمّ أولئك الذين حولنا: الأدب يفتح إلى اللانهاية، إمكانية هذا التفاعل مع الآخرين، وهو يُثرينا أبداً، ويزوّدنا بأحاسيسٍ تجعل العالم الحقيقي أجمل.. ما أبعده عن أن يكون مجرّد متعة، وتلهية محجوزة للأشخاص المتعلّمين..»..
بهذه الكلمات، نختصر ما أراد الكاتب والفيلسوف البلغاري «تزفيتان تودوروف» أن يقوله، في كتابه «الأدب في خطر».. بالأحرى، ما أراد أن ينبّه إليه، بعد أن اعتكف في ذاكرته، ونبش أعمق وأقدم ذكرياته.. حيث كانت الكتب تحيط به، ووالِداهُ يمارسان مهنة القيمِ المكتبيّة، ويعملا باستمرارٍ، حتى في البيت، على وضع تصاميمٍ لرفوفٍ جديدة، تستوعب كمية الكتب التي كان يراها: «تتراكم في الغرف والممرّات، مشكّلة أكواماً، يلزمني أن أحبو وسطها»..
في هكذا أجواء، كان من الطبيعي أن يتعلّم القراءة، بل أن يعشق القصص، التي كان يُقبل على قراءتها، بشغفٍ ترعرع معه فوصفه:
«تعلمت سريعاً القراءة، وأخذت في التهام القصص الكلاسيكيّة، المعدّة للأطفال.. ألف ليلة وليلة، وتوم سوير، وأوليفر تويست، والبؤساء.. الخ..
في سنّ الثامنة، قرأت رواية بأكملها، كنت شديد الفخر بذلك، لأنني كتبت في يومياتي الخاصة: اليوم قرأت وأنا جالس على ركبتيّ جدي، كتاباً من 323 صفحة، في ساعة ونصف..»..
إذاً، لهذا الفيلسوف كلّ الحق في التنبيه إلى خطورة ما يتهدّد الأدب، لطالما عاش في عوالمٍ ورقيّة، جعلته رائحة كتبها التي عشقها وفضلّها، يستمر معتكفاً في قراءاتٍ مختلفة، دون أن يفكر بما سيكون عليه مستقبلاً، لطالما كان كلّ ما يشغل تفكيره، الكتب التي جعلته على يقين، بأن مستقبله سيكون حتماً، ذا صلةٍ كبيرة بالأدب.. لا يعرف إن كان سيدرسه، أم سيكتبه، لكنه حتماً يعرف، أنه سيكون مهنته…
في فرنسا، التي لا يعنينا الآن الحديث عن سبب وكيفية وصوله إليها، بدأت حياته الدراسيّة والمهنيّة، ولم يكن بحثه عما سعى إليه سهلاً، لكنه واصل هذا البحث، إلى أن تمكّن من نيلِ دكتوراه أولى في البحثِ العلمي، الذي قضى كلّ مساره المهني متعمّقاً فيه، إلى أن فقد الميل لمناهجِ التحليل الأدبي، واعتمد عليه.. وهنا بدأ يشعر بأن عشقه للأدب، لم يعد محدوداً بالتربية التي تلقّاها في بلده، وفي بيته ومع أسرته، فقد وجد أن عليه اكتشاف أدوات جديدة، معطيات ومفاهيم، علم النفس والأنثروبولوجيا والتاريخ.. ولأنه وجد أن أفكار المؤلّفين قد استعادت كلّ قوّتها، من أجلٍ فهمٍ أفضل لهم، سعى إلى الغوص في تاريخ الفكر المتّصل بالإنسان ومجتمعه، في الفلسفة الأخلاقية والسياسية..
كلّ هذا، وسّع معارفه وجعله يدرك أن الأدب لا يأتي من الفراغ، وإنما من مجموعةِ دراساتٍ وخطابات حيّة، تتشارك فيها الثقافات شديدة الاختلاف، ويسخّر الإنسان نفسه، في خدمة الرؤى الكونيّة.. تلك التي جعلته يرى بأن علينا:
«علينا الذهاب أبعد، لا أن ندرس النصوص والأبحاث الأدبية فقط، بل أن نحيا فيها ونحاورها، ومن ثمّ نتساءل، عن الهدف أو القصد النهائي، من الأعمال التي نراها جديرة بالدراسة.. ذلك أن ما يهمّ، أن نجد في النهاية، المعنى الذي يتيح لنا فهماً أفضل للإنسان والعالم، واكتشافاً للجمال الذي يثري الوجود، ويقود إلى اكتمال كلّ إنسان فيه»…
بيد أن كلّ هذا، ذهب أدراج الحرائق والمذابح التي توالت منذ الحرب العالمية الأولى، والتي كان لعواقبها السياسيّة، أكبر التأثير في الممارسات الفنيّة، مثلما الخطابات الأدبية والثقافية..
نعم، للحروب عواقبها، فهناك من يسخّر قلمه وفكره وأدبه وفنّه، في خدمة مشروعها.. أيضاً، و «في ذات الوقت، وحيث تسود حريّة التعبير، سيتمّ خوض معركة ضد تطاولات أو انحيازات هذا المشروع، وسيتمّ التأكيد على أن الفن والأدب، لا يخوضا أي علاقة ذات معنى مع العالم، بل يعتمدا على رفض تسخير الأدب والفن للإيديولوجيا، بما يؤدي في النهاية إلى العدميّة التي تغذّيها معاينة الكوارث، وهو ما تميّز به التاريخ الأوروبي، في القرن الماضي..»..
إذاً، فعلاً «الأدب في خطر»… فماذا يستطيع أن يفعل ضمن إيديولوجيات مختلفة، وتوجّهات متنافسة، ما بين النزعة اليوتيوبيّة، والجماليّة التنويريّة، والشكلانيّة العدميّة؟!..
سؤالٌ، أقلق «تودوروف» المعروف بتبنّيه دعوة الانفتاح على الحضارات الأخرى، وتجنب الانغلاق على الذات، وللخلاصِ من البربرية التي رآها تحدث، عندما تعتقد مجموعة بشرية ما، أنها تجسد الحضارة والتقدم والحرية، ما يؤدي بها في نهاية المطاف، إلى الانغلاق على الذات ورفض الآخر..
نعم، هو سؤالٌ أقلقه، وهو لم يطرحه، إلا ليؤكّد وبكلّ ما امتلكه من عشقٍ وإغراقٍ بالأدب:
«الأدب يستطيع الكثير.. يستطيع أن يمدّ لنا اليد، حين نكون في أعماق الاكتئاب، ويقودنا نحو الكائنات البشريّة التي حولنا، ويجعلنا أكثر فهماً للعالم، ويعيننا على أن نحيا.. ليس ذلك لكونه، قبل كلّ شيء، تقنيّة لعلاجات الروح، غير أنه، وهو كشفٌ للعالم، يستطيع أيضاً، وفي نفسِ المسار، أن يحوّل كلّ واحد منّا، من الداخل..
الأدب مثلما الفلسفة والعلوم الإنسانيّة، فكرٌ ومعرفة للعالم النفسيّ والاجتماعيّ الذي نسكنه، والتجربة الإنسانيّة هي الواقع الذي يطمح الأدب إلى فهمه، لذا يمكن القول: إن دانتي وسرفانتس، يعلّماننا عن الوضع البشريّ على الأقل، مثلما يعلّمنا أكبر علماء الاجتماع، وعلم النفس، وأنه لا تعارض بين المعرفة الأولى والمعرفة الثانية، ذلك هو الجنس المشترك للأدب»..
باختصار: يدعو «تودوروف» في كتابه هذا، إلى أهمية وضع المناهج النقديّة في مكانها الصحيح، وكأدواتٍ ووسائلٍ لا غاية، وإلى ضرورة أن يكون الأدب نقيّاً، ومخلّصاً من شوائب المعتقدات والايديولوجيات والصراعات والمفاهيم اليوتيوبيّة، وأن يكون هو عالمنا الجميل والإنساني، بل والفضاء الشّاسع والعميق، الذي يتمّ ضمنه «حوارنا البشريّ – الكونيّ»..
إنه ميراثٌ للأجيال القادمة، وهو إن لم يُرض أغلبيتّها، إلا أنه لابدّ أن يُسعفها، ولو بالقليل مما يجعلها أقلّ عداءً، وأكثر تسامحاً وإنسانيّة»..
التاريخ: الثلاثاء3-8-2021
رقم العدد :1057