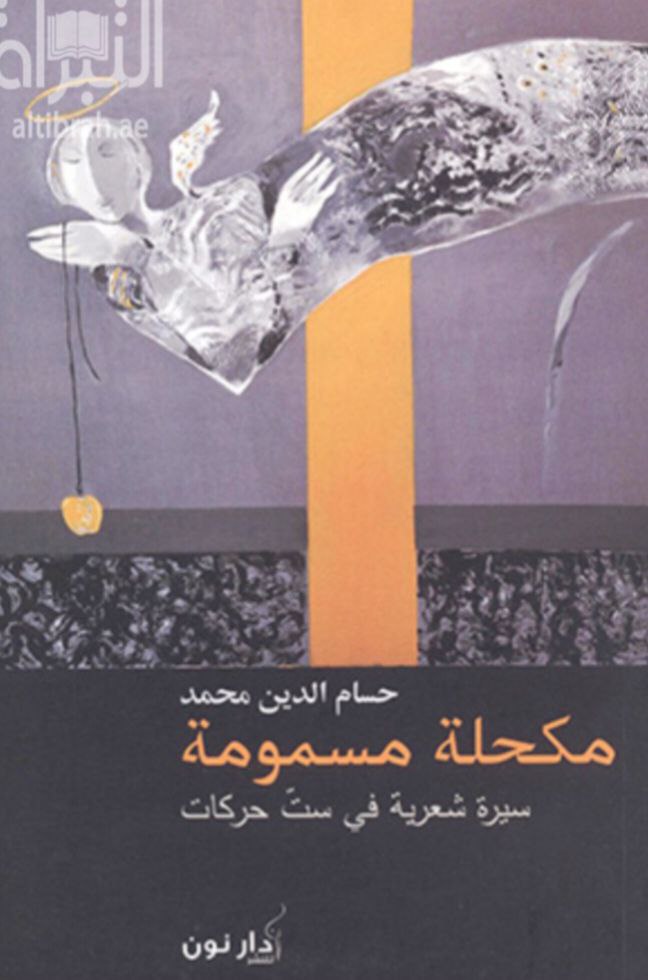الثورة – أحمد صلال – باريس:
يقود هذا الحوار الرشيق، الذي أجرته صحيفة الثورة مع الصحفي والشاعر الفلسطيني السوري حسام الدين محمد، يقود إلى سفر شيق في القصيدة ومصاحبتها وأسرارها، يطرح الحوار أسئلة إبداعيّة وجمالية وتخيلية وسياسية، قضايا شاسعة تحكمها قوانين القصيدة بالخصوص والكتابة بالعموم، ولا ننسى أن الفلسطيني السوري بدهشة الحنين والفرح الصغير والوجع الأكبر.
1- من كتاب “مكحلة مسمومة” بعنوان فرعي “سيرة شعرية في ستّ حركات” للشاعر حسام الدين محمد، عن دار نون للنشر في رأس الخيمة، وهو كتاب يمزج بين السرد والشعر، يحمل أكثر طابع سرد حكاية القصيدة؛ كيف يتبادل فيه السرد والشعر الأدوار، أو يعيد إنتاج سيرة الشعر سردياً؟
– أردت، في “مكحلة مسمومة”، تقديم تجربة في الكتابة اعتقدت أنها جديدة، أقدّم فيها قصصاً دفعتني إلى كتابة القصائد، تدور القصائد وقصصها حول حكايات عاطفية، حول مشاعر شغف وتولّه وخيانة.
افترض الكتاب مهام على الحكاية، بما يسمح بفهم علاقتها مع الشعر، قام القاصّ، في داخلي، بسرد الحكاية، وقام الشاعر بتكثيفها وتقطيرها وتعيينها في “مادة” موازية، فقد بدا لي، من ملاحظات القرّاء، أن غلبة المتعة عند أكثرهم، كانت للسرد، وكانت هذه مناسبة لي للتفكر “وربما للنقد، لو توفّر” في أسباب ذلك ومعانيه.
كان العرب يسمّون الميكانيك “علم الحيل” ويمكن القول: إن “ميكانيكا” الكتاب فيها حيل عديدة، بدءاً من العنوان المخادع الذي يقول إنه “سيرة شعرية في ستّ حركات” مع أن القارئ النبيه سينتبه أنها خمس حركات، ومنها أيضاً ادعاء السرد أنه سرد رغم أن شعرنة الواقع همّ كبير فيه، وورطة الشعر في جسم “قصيدة النثر”، التي توحي بنقيضها، وتشير إلى مفارقة تقاليد القصيدة العربية الموزونة العتيدة بحيث يقع، ربما، في شر أعماله، حين يتعرّى من جذوره، ويشعر قارئه بالغرابة والأجنبية، وهي حيلة شعرية أخرى.
2- يكشف الكاتب أستار نفسه، لكنه مع نسائه المتمرّدات غريبات الأطوار، المنسرحات سرداً وشعراً، حدثني عن المرأة في شعرك..
– من المفارقات الخاصة بالكتاب أن مدير دار النشر حينها، الصديق الشاعر خالد الناصري، قرر طبعه في دمشق، حصلت نتيجة ذلك ملابسات عديدة فحُبست مجمل نسخ الكتاب هناك، كما حُبست أنا في مغتربي، فلا الكتاب يخرج ولا أنا أستطيع الوصول إليه، أتخيّل أن لكل سوريّ قصة تندرج في المصائر العجيبة للتراجيديا العامة، وتنتظم ضمن الكابوس الأسود الذي حاق بالبلاد، كانت إحدى فتيات القصائد والقصص التي التقيتها في لندن، وما كان لنا، بالتالي، من طريق “شرعيّ” لرفع سويّة العلاقة إلى طور أعلى، كمن هذا التفصيل طبعاً في حكايتنا التي أخذت حيّزاً واسعاً من الكتاب، وبدونا فيها خاضعين لملابسات السياسة واشتباكها بالقضايا الأخرى، كما بمتاهات العلاقة والتباساتها المحيّرة، إحدى الفتيات كانت أيضاً لبنانية وقد حضرت، في علاقتنا ملابسات الجغرافيا والدين والسياسة، أرى الآن، بعينين مغبّشتين، وأنا أفكّر بهاته النسوة الجميلات اللاتي انسرحن، كما تقول، في حياتي، كيف ضعن جميعاً في المتاهة التراجيدية التي دخلنا فيها كأفراد، وكأشخاص ينتمون إلى منظومات اجتماعية تاريخية متشابكة، تتمظهر اشتباكاتها في علاقات الغرام والانتقام (إذا استعرنا عنوان فيلم أسمهان الشهير!) تحضر في القصائد أيضاً قصص مع رسامة ألمانية وفتاة رومانية هاربة من ملهى ليلي (!)، وتحضر معهما تعقيدات اللغة والجنسية والهوية، وهو جانب سيزداد تأزماً وتعقيداً في مجموعتي اللاحقة بالإنكليزية

3- يتبادل السرد والشعر المواقع فلا نعلم إن كشفت الحكاية سر القصيدة، أم فضحت القصيدة أستار الحكاية، وإذا كان الكتاب يغري بالقراءة النقدية للعلاقة بين الواقع والشعر، فإنه، أساساً، مكتوب ليؤكد على أساس العلاقة بين القارئ والكاتب: متعة القراءة وأولويتها؛ بين متعة القراءة والقراءة النقدية؛ هل أنصف وحصل الشاعر حسام الدين محمد على التقدير النقدي والحظوة الجماهيرية؟
– هذه ملاحظة جميلة، اختبرت بنفسي هذه الفكرة كناقد، بطريقة أخرى، عندما قدمت تناظراً بين كتابين لروائية لبنانية صديقة تدعى هاديا سعيد، ارتدى الكتاب الأول قناع المذكرات، وارتدى الثاني قناع الرواية، وحين شرّحت الكتابين وجدت أن الرواية كانت أكثر انطباقاً على الواقع من المذكرات التي قامت بتمويهه!
كان كتابي، كما قلت تجربة إبداعية، ولعي أحظى بقارئ نقدي محايد يستطيع التيقن إذا حفر فيه إن كانت الحكاية كشفت سر القصيدة أو العكس، كنت أتمنى لو أن هذه التجربة شاعت أكثر، وقام غيري من الشعراء أو القاصّين بتجارب مماثلة تُغني الفكرة، أتذكر، إن لم أكن مخطئاً، أنني قرأت مرة قصّة للسوري محمد كامل الخطيب، كانت موزونة بأكملها، ولعل هناك تجارب أخرى لا أعرفها.
هناك أكثر من كاتب، طبعاً، يعمل قاصداً على محو الحدود بين الشعر والسرد، عبر تقديم قصص فيها شعرية عالية (قصص زكريا تامر للأطفال مثلاً)، أو قصائد يمكن قراءتها كقصص، وهو أمر شائع في الشعر الانكليزي، أعتقد أن هذا الميل يتجلّى في كتاب شعريّ سينشر لي قريباً، لم أتوصل إلى عنوان له بعد.
أول ما خطر لي، بالنسبة لتساؤلك عن “الحظوة الجماهيرية”، أن أرد بوسم (إيموجي) “أضحكني” أو “أبكاني” (المعروفين في وسائل التواصل) لأن الكتاب، كما قُلت، حُجر عليه في سوريا، ولم توزع نسخه في معارض الكتب، ووئدت هذه التجربة بالنتيجة، حظيت، مع ذلك، باهتمام مشكور، من مؤسسة إعلامية، وإعلاميّ قدير، صوّر حلقة عن الكتاب في حلقة تلفزيونية، لكنني أحسست أن ترويجي لذلك، وأنا الخجول طبعاً، والمتحفظ على أشكال التسويق الفائض الذي يهواه بعض الشعراء، أنه سيسيء إليّ، فانكفأت.
4- صدرت مؤخراً عن دار نشر بولويل البريطانية مجموعة شعرية الإنكليزية للشاعر والكاتب السوري المقيم في بريطانيا حسام الدين محمد بعنوان “Grave Seas” “قبر في بحر” تضمنت المجموعة مقدمة بعنوان “أحجية سورية”، وست عشرة قصيدة، حدثني عن السر وراء السرد المتميز المزركش بسيرة الكاتب على حد تعبير الناقد السوري خلدون الشمعة؟
– الشعر هو سيرة الشاعر، هو حدبته التي يحملها على ظهره، وعصاه العرجاء (على وصف الشاعر الصديق طاهر رياض)، إنه أحجيته التي ينوء تحت ثقل حلّ التباساتها، لعل رياضيّاً فهيماً، أو مختصاً بعلم الأعصاب، يتمكّن يوماً من ابتكار معادلة تفسّر هذه العلاقة البهية بين الشعر والشاعر، بالمناسبة، قمت مرة، مستعيناً بمعادلات اللسانيات الإحصائية، بخوض تجارب في قصائد لمحمود درويش وآخرين، تقصّيت مثلاً قدرة درويش على تمثّل صوت الأنثى في قصيدة “يطير الحمام”، وهو ما أثبته فعلاً رجحان استخدام الأفعال على الصفات (التي هي سمة أكثر للذكورة)، فوضعت إصبعي على حيّز لغوي من عبقريته، وعلى تمثّله البهيّ للأنوثة، وهو شأن عظيم في درك الإنسانية لو شئت.
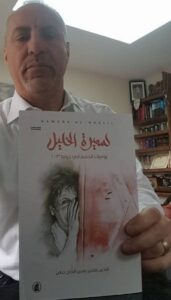
5 – “الإمساك بأحلام الحب والأمل لأولئك الذين يحاولون البقاء أحياء في الأزمنة المظلمة” على حد تعبير الشاعرة العراقية هيفاء زنكنة، حدثني عن الألم الكامن في الأزمنة المظلمة؟
عاش السوريون ومن في حكمهم في هذه المنطقة المنكوبة وعلى رأسهم الفلسطينيون طبعاً- في أزمنة تفظيع هائلة بأجسادهم وأرواحهم وأحيازهم الجغرافية والاجتماعية والثقافية، فصار الإمساك بأحلام من يحاولون البقاء أحياء في الحب والأمل، مهمة مركزية فعلاً لمن يريد أن يعبر الجسر، وقد أحسنت الصديقة هيفاء في هذا الوصف.
6- غير أن قصائدك تقف أمام كوارث الحاضر لتعزية نفسه”، حدثني عن كوارث الحاضر?.
– أعتقد أن مجموعتي حاولت أن تدخل في كوارث الحاضر من مناطق شديدة الحلكة والتعقيد، من ذلك قصيدة أتخيّل فيها أخويّن يتسابقان على قتل بعضهما البعض، ويتناجيان، خلال ذلك، عن طفولتهما التي يختلط فيها الجميل بالشرير، ويصلان برأسين مقطوعين إلى أمهما التي تعدّ لهما العشاء، من ذلك أيضاً قصيدة تصف أحوال ناس موتى/ أحياء في مقبرة على اتساع بلاد حيث يرى الأب ابنته .. كل يوم، والجنود يحاولون الفرار كل يوم إلخ، ثم يقف السيّاح لالتقاط صور لهم مع أولئك المطحونين في تلك المقبرة، قصائد المجموعة، بهذا المعنى، هي محاولتي للجواب عن سؤالك.
7- حدثنا عن وجعك الفردي الفلسطيني السوري?.
السوريّون – الفلسطينيّون “استعارة” هائلة لآلام الجنس البشري، تحدّثت في مقدمتي عن كيف سمّيت أوروبا على اسم أميرة كنعانية من صيدا، وكيف أن المهاجرين الأوائل من شواطئنا صاروا ملوكاً وأساطير ومصادر للمعرفة، وكيف تحولنا في العصر الحديث إلى صيد للمهرّبين وطعام للبحر، اقتراحي كان أن خلاصنا، هو بأشكال عديدة، خلاص للبشرية نفسها.
8 – دمشق المدينة التي ولدت فيها، كيف كانت طفولتك والمدينة؟.
– زرت دمشق بعد 36 عاماً من الفراق، أول ما فعلته هو البحث عن قبر أبي في مقبرة الجورة في الميدان، تحدثت عن هذه الطفولة في قصيدة عن أبي بعنوان “محمد نامه” تذكرت فيها كيف كنت “أهبط الممر الصغير بين الخانكية وزقاق الطالع، فيتماهى رعب الجنّ في أحشائي مع بهموت العسس”، وتذكر كيف كانت النوافذ مطلية بالأزرق “لتضليل طائرات إسرائيل” (حسب مطلب سلطات النظام عام 1967) وتذكر سكة الحديد قرب بيتنا في منطقة الثريا، والبرية الواسعة والضفادع وسراعيف السمك في الأقنية، محت الحكومة منطقة الخانكية ووضعت فوقها جسراً بشعاً، وتكسرت سكّة الحديد، ولم تعد هناك برية واسعة ولا ضفادع ولا أسماك!