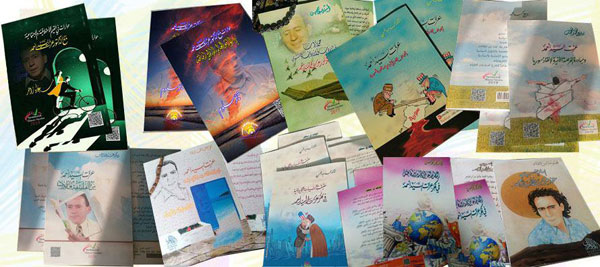نحصد ثمن التَّلاعب بمقوِّمات الفنون والآداب.. د.أحمد لـ “الثورة”: النَّاقد يمارس النَّقد بإرادة وأهداف حرَّة
الثورة – سعاد زاهر:
الدكتور عزت السيد أحمد شاعر وأديب وباحث، حاصل على دكتوراه في الفلسفة، غادر سوريا إلى تركيا قبل أكثر من خمسة عشر عاماً، أستاذ الفلسفة الإسلامية والبلاغة العربية في جامعة بولاند أجاويد بتركيا.. له نحو أربعمئة مادة علمية وأدبية إبداعية في الفلسفة والسياسة وفنون الأدب، منشورة في الدوريات والمجلات والصحف العربية والدولية، أما كتبه المنشورة منذ نحو ثلاثين سنة إلى الآن عددها ما يقارب مئة كتاب في الفلسفة والفكر والأدب والشعر والقصة.
كان لصحيفة “الثورة” الوقفة التالية معه، والتي تخصّصت في كل ما يتعلّق بالنقد وغياب الحركة النقديّة..
كيف تفهم النقد ونحن نعيش كل هذه التغيرات؟
النقد اصطلاحاً- وإن اختلفت أساليب التَّعبير، هو كشف الغلط أو الخطأ أو الخلل أو النَّقص أو العيب والإعلان عنه علىٰ الملأ أو ما بحكمه، الكشف والإعلان شرطان متلازمان في العمليَّة النَّقديَّة أيّاً كان ميدانها وموضوعها.. أما الكشف من دون الإعلان فليس نقداً، والإعلان من دون الكشف نقلٌ لا نقدٌ.
أعني بذَلكَ.. إذا أنت عرفت نقداً لأمر ما قام به شخص ما وأعلنته أنت ففعلك ليس نقداً، وإنَّما هو نقل سواء أكان نقلاً أميناً أم غير أمينٍ، وبعضهم يرى أنَّ النَّقد هو تبيان المحاسن والمعايب، وهٰذا غير دقيق إلا في مجال النَّقد الأدبي الذي هو موضوع كلامنا.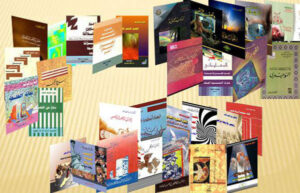
ما أبرز مواصفات الناقد..؟
النَّاقد هو الذي يختصُّ بنقد فنٍّ أو أكثر من فنون الأدب أو الفنون بالعموم، ومعنى التَّخصُّص هنا اتِّخاذ ذَلكَ حرفة من جهة والإدراك المعرفي اللازم لممارسة هذا التخصص، وأقول الإدراك المعرفي اللازم حتىٰ أفصل بينَ المعرفة وطريقة امتلاك المعرفة، الكثيرون يمتلكون معارف أكثر من النقاد، ولكن النقاد يمتلكون طريقة إدارة هذه المعرفة بما يتناسب مع ممارسة النقد ويخدمه، وهذا ما يسميه المنهجية النقديّة أو لا بأس إن قلنا النقد المنهجي، وإن ارتبط ذَلكَ بديكارت فلا مشكلة.
وإلى جانب ذلِكَ وبالتوازي معه، النَّاقد الأدبي والفنِّي يمارس نقده متعة وابتهاجاً باختراق النص وإلقاء أضواء عليه غير مدركة من الآخرين وربما من المبدع ذاته، الممارسة النَّقدية الحقيقية استمتاعية أكثر مما هي كشف العيوب والأخطاء والعثرات، كشف عيوب النص وعثراته متعة وبهجة طبيعية، ولٰكن إذا كان الهدف هو كشف العيوب والأخطاء والنَّواقص فهذا يكون تشفياً لا استشفاءً، وإن كان يدخل شكلاً ضمن النَّقد.
النَّاقد يمارس النَّقد بإرادة حرَّة وأهداف حرَّة، ولا بأس من القول بإرادة شخصيَّة وأهداف شخصيَّة وذاتيَّة، بغية تحقيق ذاته الإبداعيَّة من بوابة النَّقد.. النَّاقد يمارس النَّقد وهو يشعر أنَّهُ يقوم بعمليَّة إبداعيَّة، ولا نختلف معه أو نعترض عليه في هٰذا الإحساس، بل يمكن القول إنَّهُ لا يمكن أن يكون المرء ناقداً ما لم يمتلك حسّاً أو ذائقة إبداعيَّة أو رُبَّما قدرة إبداعيَّة من مستوًى ما في موضوعات أو ميادين النَّقد التي يشتغل فيها.
ما أسباب تراجع الحركة النَّقدية؟
من المهم بداية التَّمييز بَيْنَ تراجع النَّقد وتراجع الحركة النَّقديَّة، ومن المهمِّ قبل ذَلكَ أن نميِّز بَيْنَ النَّقد والحركة النَّقديَّة، ومن المهمِّ قبل كليهما أن نفهم أنَّ النَّقد في أصله وأساسه ليس ممارسةً أدبيَّة وظيفيَّة وإنَّما هو ممارسة فطريَّة تشمل سائر جوانب الفعل والسُّلوك الإنساني، يمارسه الصَّغير والكبير بوصف ممارسته مقتضىً من مقتضيات بناء الكيان أو الكينونة الفرديَّة والجمعيَّة بناءً يقوم علىٰ تجاوز الأخطاء أو ما نحسب أنَّهُ من الأخطاء.
ومن المهم قبل ذَلكَ كله أن نضع في اعتبارنا أنَّ كلامنا في غياب النَّقد والحركة أو الحركات النَّقديَّة سيكون مختلفاً تماماً عن الكلام الذي قلته وقلناه في الموضوع ذاته قبل عشرين سنة وأكثر، هذا ثاني أو ثالث حوار معي تحت عنوان غياب النَّقد منذ ثلاثين سنة إلى الآن، وسنكون اليوم أمام معطيات مختلفة تمام الاختلاف عمَّا كان عليه كلامنا في الحوارات السابقة بسبب الاختلاف الهائل بينَ معطيات المرحلتين وأسباب غياب النَّقد والحراك النَّقدي، كل الأسباب والتَّعليلات السابقة لن تكون جزءاً من كلامنا لعدم وجود أي تماثل أو تشابه بَيْنَ الحالين أو الأزمتين بَيْنَ هذين الزمانين المختلفين.
أما الحركة النَّقديَّة فشيءٌ مختلف جملة وتفصيلاً، وثمة إيضاحٌ آخر لا بُدَّ منه في هذا السِّياق، وهو أنَّ الحركة النَّقديَّة شيءٌ والمذهب النَّقدي شيءٌ آخر، المذهب أو المدرسة ولا بأس من القول التَّيار النَّقدي هو طريقة أو منهجيَّة لها خصائص وصفات معيَّنة في طريقة النَّقد يتَّبعها نقاد أو يصنف النَّقد أو النُّقَّاد عَلى أساسها ولا يشترط تشكيلهم جماعة أو حركة.
أما الحركة النَّقديَّة ففيها دلالتان فهي: إمَّا أن يقصد بها الحراك أو النَّشاط النَّقدي في مجتمع ما أو على مستوى جغرافي يكبر ويصغرحتىٰ يصل إلىٰ المستوى العالمي، وبهذا المعنى فالحديث عنها حديث عن النَّقد من دون تحديدٍ منهجيٍّ أو مذهبيٍّ أو أيديولوجيٍّ أو غير ذَلكَ..
الحديث عنها حديث عن النَّقد أي نقد وأي ناقد. أو أن يقصد بها تيارٌ فكري أو سياسيٌّ أو مذهبيٌّ وكلها ينضوي تحت اسم تيار أو توجُّه أيديولوجي..
في هذه الحال وحدها تقريباً لن نكون أمام ممارسة نقديَّة وإنما سنكون أمام ممارسة أيديولوجيَّة تسييسيَّة تحريفيَّة تقوم علىٰ تحميل النَّص ما لا يحمل وتقويله ما لا يقول، وفي أحسن الأحوال تقوم عَلىٰ إبراز ما يتناسب مع الحركة وأيديولوجياتها والتركيزعليه وتشتيت الفهم عمَّا لا يناسب أو لا ينسجم مع الحركة وأيديولوجيتها..
مهما كانت الحيادية في كلّ هَذه الحركات فإنَّهَا تظلُّ مسيسة ومتَّهمة بالتضليل.
والآن، بعد كلّ هذه الإيضاحات سيكون من العجيب المدهش أن نتساءل عن سبب غياب النَّقد أو الحركات النَّقديَّة أو كليهما، وسيكون من الأشد إدهاشاً وغرابة أن نعلم أنَّهُ فعلاً هناك غياب للنقد والحركات النقديّة، هذا يعني أحد أمرين أو كليهما معاً إمَّا أنه لا يوجد إنتاج أدبي يستدعي النقد أو أنه يوجد إحباط من الممارسة النقدية أو جدواها، والأعجب من ذَلكَ أنَّ السَّببين -على ما يبدوان عليه من تناقض- موجودان معاً وكلاهما معاً هو السبب الحقيقي لغياب النَّقد والحركات النَّقديَّة.
إلى أين تودي بنا المغالاة في المديح، والتفريط بمقومات الإبداع؟.
منذ أكثرمن ثلاثين سنة سلخت الكثير من جهودي الفكريَّة عَلىٰ مختلف المنابر للتَّحذير من مخاطر التَّفريط في مقومات الإبداع الفنِّي والأدبي حَتَّىٰ لا يتحوَّل الإبداع إلىٰ غثاء وتفاهات يطلق عليها الشِّعر والقصة والرِّواية وما إلىٰ ذَلكَ، ودخلت في صراعات شخصيَّة من أنصار ما يسمَّى الحداثة في الشِّعر والأدب والفن..
كلُّ ما كان يهمهم نسف محدِّدات ومقوَّمات الشِّعروالأدب لأكثر من سبب ومنها ليسهل عليهم إطلاق اسم الشِّعر على أي تفاهات يكتبونها، لم يدركوا ما سيؤدِّي إليه هذا الاستهتار من مخاطر في المستقبل الذي نعيشه اليوم، وبعضهم كان يدرك أنَّهُ يخرِّب.
اليوم نحصد ثمن التَّلاعب بمقوِّمات الفنون والآداب، اليوم لم تعد هناك أي هويَّة للشِّعر ولا للقصَّة ولا للرِّواية ولا للرَّسم ولا حَتَّى الموسيقا، أي شخص منعدم الموهبة، منعدم اللغة.. بل حَتَّى منعدم الهواية، يكتب أيَّ كلامٍ ويسمِّيه ما يشاء: شعر، قصة، رواية… يخربش أي خربشات ويسميها لوحة..
وقد ساهمت وسائط التَّواصل الاجتماعي في تعزيز ذَلكَ كثيراً، وأضافت إليها مصيبة أُخْرَىٰ هي أنَّ كلَّ كائنٍ فيسبوكيٍّ أو تويتريٍّ يسرق من هنا وهناك وينسب لنفسه ما يسرق، أو يختلق تفاهات وينسبها إلى هذا الأديب أو ذاك.. وهلمَّ جرّاً مما يزيد في تمييع الحقيقة وهلاميتها.
هٰذا كله أدَّى إلى إحباط النُّقَّاد الحقيقيين، ونهضت أطقم جديدة وآليَّات جديدة وعقليَّات جديدة، من النُّقَّاد والنَّقد المتوازي مع هَذه التفاهات، يسمُّونها عقليَّات التَّطبيل، عقليّات التَّطبيل موجودة دائماً، ولٰكنَّهَا الآن صارت بوجوهٍ جديدةٍ وآليَّات جديدةٍ، وهي الجمهور نفسه بما قام عليه من جهل وانعدام المعرفة وحتى الأميَّة.
فالنُّقَّاد الخبراء والحقيقيون لا يمكن أن ينجرفوا أو يسيروا مع هَذه الفقاعية أو الرِّعاعيَّة أو يمارسوا ممارساتها.. بعض منهم حاول مجاراة معطيات العصر والسير مع هَذه الموضة أو مسايرتها ولٰكنَّهُم أخفقوا لأنَّهم لا يمكن أن يجاروا جمهور وسائط أو وسائل التَّواصل الاجتماعي…
فيكف يمكن أن يجاروا نجومه الذي يعرفون كيف يخترقون الجمهور من خلال مداعبة غرائزه؟!.
إنَّهَا معادلة صعبة
هل أثر تغيّر آليات النشرعلى غياب النقد؟.
بالتأكيد هٰذا العامل ذاته ينطوي عَلىٰ سبب آخرمن أسباب غياب النَّقد والحركات النَّقديَّة، إضافة إلى القراءة وتغيُّر القراء، قديماً كانت الكتابة والقراءة لها أصحابها وجمهورها الذي يتابعها ويتتبعها من خلال الكتب والمجلات والجرائد، ولا يتنطَّع أحدٌ للكتابة أو القراءة إلا من له في ذَلك باع وفي عقله امتلاء، إلا الاستثناء، وهَذه كلُّها تلاشت وتلاشى معها إلىٰ حدٍّ كبيرما يسمَّى جمهور القراء، لم يبق إلا القليل الذي كان مواظباً ومعتاداً، ونشأت أجيال جديدة عَلى ثقافة الإنترنت والطَّلاق مع القراء، وهَذه مسألة أُخْرَى من ناحية الخطرالذي يواجه البشريَّة كلَّها وليس فقط جمهورالقراء والقراءة.
وسيزيد الطِّين بلة بما يسمَّى الذَّكاء الاصطناعي الذي سيشلُّ العقول والإرادات ويتحكَّم بها تحكماً يتزايد تدريجيّاً حَتَّىٰ يصبح البشر عبيداً حقيقيين لهٰذا الهاتف الذي يوضع في الجيب اليوم، وسيصغر ليكون شريحة تلصق بالرَّأس أو تحت الأذن قريباً. • كيف يمكن الاشتغال على انعاشها؟
بالعموم أخشى أن يكون الوقت قد فات، المسألة ليست مسألة إنعاش مريض يحتضر، الأمور خرجت عن السَّيطرة وخروجها عن السَّيطرة في تزايد مرعبٍ عَلىٰ المستوى العالمي وليس المحلي فقط أو العربي أو الإقليمي.. الأزمة عالميَّة بإدارة عَلىٰ المستوى العالمي.
النَّقد ليس إيجاداً، النَّقد تعاملٌ مع موجودٍ، النَّقد تعامل مع مخرجات موجودةٍ، قائمةٍ، حاضرة، وليس هذا فحسب بل يشترط في هذا الموجود أو الموجودات أن تتصف بخصائص وسمات وصفات معينة يقوم النَّاقد بالتَّعامل معها ومعالجتها وفق أسس ما نسمِّيه النَّقد، فلا المخرجات موجودة ولا النَّقد موجودٌ، البقيَّة الباقية من الممارسات النَّقديَّة هي على أيدي البقية الباقية من النُّقَّاد القدماء، وهم وهي في طريقهما إلىٰ التَّلاشي والزَّوال كما ذكرت من قبل، هي في اضمحلال متزايدٍ منذ انتشار وسائط أو وسائل التَّواصل الاجتماعي.
إذاً العوامل المختلفة الأطراف والجهات المتضايفة إلى بعضها عملت على اضمحلال الكتابة الإبداعيَّة إلى ما يشبه حالة الموت، وكل ذَلكَ سيعني بالضرورة الحتميَّة موت الصَّنائع والأعمال التي تقوم عَلى مخرجات الإبداع الأدبي وعَلى رأسها النَّقد.
تريدين إنعاش النَّقد؟! ليس أمامك إلا إنعاش الإبداع الأدبي، بمجرِّد وجود إبداع أدبيٍّ سيعني ذَلكَ بالضَّرورة وجود نقد وحركاتٍ نقديَّة وانتعاشاً للنَّقد والحركات النَّقديَّة، ولكنَّ إنعاش النَّقد هذا أمر بات بحكم المستحيل في هذا الزَّمان وما يحكم هذا الزَّمان من خصائص ومعطيات.
ما متطلبات إحيائها؟
متطلَّبات إحياء النَّقد والحركة النَّقدية هي متطلبات إحياء الإبداع، فمجرَّد إحياء الإبداع وتحقُّق الإبداع يعني نشأة النَّقد والحركة النَّقديَّة بالضَّرورة، ومن ثَمَّ أكرِّر فإنَّ متطلَّبات إحياء النَّقد والحركة النَّقدية هي ذاتها متطلَّبات إحياء الإبداع الأدبيِّ، وسيضاف بالضَّرورة إلى متطلَّبات إحياء الإبداع الأدبي والجمال متطلَّبات أخرى مرتبطة ببنية النَّقد بوصفه عملاً مضافاً أَو لاحقاً عَلىٰ الأدب، ولكن حسبنا عَلى أقل تقدير أنَّهُ مجرَّد أن ينهض الإبداع الأدبي سينهض النَّقد وينتعش النَّقد لأن النَّقد هو النَّبات الذي يعيش عَلى الماء والماء هو الإبداع، فإذا لم يكن هنالك ماء لم يكن هنالك هذا النَّبات.
مهما قدَّمنا من محفِّزات للمبدعين كي يبدعوا فإنَّنا لا نستطيع أن نحرِّك النَّشاط الإبداعي العام ما لم يكن المناخ الحضاري والتَّاريخي السِّياسي والاقتصادي والاجتماعي حاضناً لهذا الإبداع ومحرضاً له وطالباً له ومستهلكاً له.
قد لا يقبلون ذَلكَ اليوم وقد لا يصدقون ذَلكَ وقد لا يقتنعون بذَلكَ، ولٰكن هَذه هي الحقيقة، مع انتشار الكمبيوتر والإنترنت قال المتنبِّئون العالميون: إن عصر الكتاب قد انتهى وإن عصر الصحافة الورقيَّة قد ولَّى وانتهى كانت هَذه الأحكام الصَّادمة عَلى شكل تساؤلات في أكثر الأحيان وفي بعض الأحيان عَلى شكل قرارات أَو أحكام قطعيَّة أَو شبه قطعيَّة، كل من كان يحب القراءة والمطالعة لم يكن يقبل ذَلكَ أو يصدقه ولو حلفت له ألف ألف يمين، وكنت من هَؤلاء في هَذه البدايات، لكن ليست بالأماني تكون الأمور، وليست بالرَّغبات تسير، وخطوة خطوة انتهينا إلى ما انتهينا إليه، وعلينا أن نتأقلم مع الوقائع الجديدة ونخطِّط لحسن إدارتها قبل أن تخرطنا وتخرط رغباتنا ببرمجياتها وتطبيقاتها الذَّكيَّة وغير الذَّكيَّة.
ما الفائدة التي تعود على الفكر والثقافة والفن لو أننا اعتنقناها مجدداً؟
النَّقد هو النَّبات والأدب هو الماء ولا يمكن أن يوجد النَّبات من دون وجود الماء، إذا لم يكن هنالك أدب لن يكون هنالك نقدٌ أدبيٌّ، لكن في المقابل يمكن أن يوجد الماء ولا يوجد النَّبات.
هل هذا ممكن؟
نعم يمكن أن يوجد الماء ولا يوجد النَّبات، أعني بذَلكَ أنَّهُ أيضاً يمكن أن يوجد أدب ولا يوجد نقد، وقد لا يؤدِّي ذَلكَ إلىٰ مخاطر، لكن لننظر إلى هَذه العلاقة بَيْنَ الماء والنَّبات، الماء إذاً هو نسغ النِّعمة والخير يوجد ليفيد، ليقدِّم الفائدة، والنَّقد هو ثمرة من ثمار هذا الماء، أي هو أحد تجليَّات الفوائد التي يقدِّمها الأدب، وأحد التَّجليَّات وليس هو الفائدة بحدِّ ذاته لأنَّ النَّقد هو الذي يؤدِّي إلى تطوُّر الأدب ذاته وتنوِّعه وغناه وتجاوزه الأخطاء والمثالب والعيوب، ويقوم أيضاً بتقديم الفوائد التي يتضمنها الأدب للمجتمع وللعقليَّة الاجتماعيَّة.
ومن ناحية أُخْرَى، فإنَّهُ ليس من باب الخيار أن نعتنق النَّقد أَو لا نعتنقه، نقبله أَو لا نقبله، المسألة ليست مسألة إراديَّة شئنا أم أبينا.. بل إنَّ المصيبة الأكبر من ذَلكَ أنَّهُ حَتَّى لو كان النَّقد سيئاً وسلبيّاً وسفيهاً وتافهاً فإننا مجبورون عَلى التَّعامل معه، لسنا مجبرين عَلى قبوله ولا على اعتناقه ولكنَّنَا مجبورون عَلى التَّعامل معه.
ومن ناحية ثالثة، لا ينبغي علينا الاستنفار لتشجيع النَّقد والحركة النَّقديَّة، إنَّهَا مسألة لا تنتظر التَّشجيع ولا التحفيز، لا شكَّ في فائدة التَّحفيز والتَّشجيع، لٰكنَّ ذَلكَ ليس شرطاً ولا واجباً لا غنى عنه، فمجرَّد وجود حالة إبداعيَّة ونشاط إبداعيٍّ سيعني أنَّ النَّقد سيكون موجوداً والحركة النَّقديَّة ستكون موجودة.
في هذا السياق لا بُدَّ أن أشير إلى مسألة مهمَّة جدّاً، وهي أنَّ حرِّيَّة التَّعبير والمناقشة والمجادلة لا تعني أنَّهُ لا توجد هناك خطوط حمراء، في كلِّ المجتمعات توجد خطوط حمراء لا يجوز لأحد أن يجاوزها أو يتخطَّاها أو يتعدَّاها، كلُّ مجتمع له خصوصيَّته في ذَلكَ، ولا يظنّ أحد أنَّ أوروبا أو أميركا ليس فيهما خطوط حمراء، نعم هم يفعلون العجائب تحت باب الحرِّيَّة فيما نظنُّ ونعتقد، وإن هناك خطوطاً حمراء حَتَّى الآن وإلى الأبد، لا يحقُّ لأحد تجاوزها.
الحرية لا تعني الانفلات، لا تعني قلة الأدب، لا تعني قلة الذَّوق، لا تعني الإساءة، لا تعني انعدام الأمانة.
الكلام في ذَلكَ كله أطول بكثير.. وكثير ما قلته ليس إلا القليل، لأنَّ الموضوع أصلاً وبطبيعته مليء ثقيل.