الثورة – همسة زغيب:
ابن خلدون المؤرخ والفيلسوف الاجتماعي والسياسي، والفقيه والمعلم والعالم من علماء العرب والمسلمين، وأحد أبرز علماء القرون الوسطى، ومن أكبر المؤرخين العرب، ينسب إليه تأسيس علم الاجتماع، وأحد أوائل واضعي أصول فلسفة التاريخ، ما يجعله واحداً من أعظم العقول في التاريخ الإسلامي والعالمي سبق زمانه بمئات السنين، بحسب ما جاء في محاضرة الباحث مازن ستوت العلمية والثقافية في الجمعية الجغرافية السورية تحت عنوان: “ابن خلدون”.

تحدث فيها عن نشأة ابن خلدون ودراسته لعلوم القرآن الكريم والفقه والاقتصاد وعلم الاجتماع الخاص بالعمران وأصبح عالماً متقدماً وكبيراً في العلوم الاجتماعية، ولاسيما في أثر المناخ على المجتمعات، وأسباب الفساد وانهيار الدول، إضافة إلى كتابه “المقدمة” الذي اكتسب به شهرة عبر العصور وله موسوعة تاريخية اعتُبرت من أهم مصادر الفكر العالمي، تقلب في مراكز الحكم والسلطان، وعرف المجد والشهرة، وابتُلي بالسجن والنفي والتشريد، وذاق مرارة الاغتراب.
ولفت ستوت إلى أن ابن خلدون بدأ حياته العملية مبكراً، إذ لم يكد يستوفي سن العشرين حتى تم تعيينه بمنصب صاحب “العلامة” في بلاط أبي إسحاق الحفصي في تونس، ويعتبر في الوسط الأدبي والبحثي والإبداعي والشعر رمزاً تاريخياً للفكر المستنير وهو من أبرز المفكرين في عصره فكان شخصية استثمارية في تاريخ الفكر الإنساني لأنه قدم رؤى ثابتة حول طبيعة الإنسان والمجتمع والتاريخ وأول من حاول كتابة تاريخ الحضارة بمعناها الشامل، وأنه دعا لاستخدام العقل في دراسة التاريخ، إذ كانت نظرته إلى التاريخ نظرة غربية، وكان عبق عصر النهضة واضحاً في فكره.
وذكر الباحث أن عبد الرحمن بن خلدون ولد في 27 أيار1332م، في مدينة تونس زمن الدوّلة الحفصية، وتوفي في 16 آذار 1406م، عن عمر ناهز 76 سنة.
كُنِّيَ “أبا زيد” حين صار أباً، ولُقّب وَلِيَّ الدِّين حين أصبح قاضياً في مصر، وطغى اسمه “ابن خلدون” على سائر العائلة التي تنسب إلى خالد بن عثمان، وقد عُرف جدهم هذا بـ”خلدون” بإضافة واو ونون إلى اسمه، إذ كان ذلك من علامات التعظيم عند أهل الأندلس والمغرب.
كُنِّيَ “أبا زيد” حين صار أباً، ولُقّب وَلِيَّ الدِّين حين أصبح قاضياً في مصر، وطغى اسمه “ابن خلدون” على سائر العائلة التي تنسب إلى خالد بن عثمان، وقد عُرف جدهم هذا بـ”خلدون” بإضافة واو ونون إلى اسمه، إذ كان ذلك من علامات التعظيم عند أهل الأندلس والمغرب.
وأضاف: إن عبد الرحمن ينتمي إلى أسرة عريقة من عرب اليمن في حَضْرمَوت، يمتد نسبها إلى الصحابي وائل بن حجر، كان لعبد الرحمن أربعة إخوة، وكان والده عالماً وفقيهاً، زهد في الحياة السياسية وآثر العلم والدرس.
عاش ابن خلدون حياة مضطربة، لم ينعم فيها بالهدوء والاستقرار، إذ “كان كثير التنقل كالظّل”، كما كتب عنه السلطان المغربي مولاي زيدان آنذاك، فقد قضى في ترحاله الجغرافي 24 سنة في تونس، و26 سنة متنقلاً بين أرجاء المغرب والأندلس، و24 سنة في مصر والشام والحجاز.
عاش ابن خلدون حياة مضطربة، لم ينعم فيها بالهدوء والاستقرار، إذ “كان كثير التنقل كالظّل”، كما كتب عنه السلطان المغربي مولاي زيدان آنذاك، فقد قضى في ترحاله الجغرافي 24 سنة في تونس، و26 سنة متنقلاً بين أرجاء المغرب والأندلس، و24 سنة في مصر والشام والحجاز.
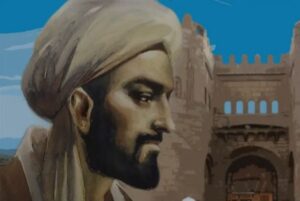
كما بيّن ستوت أن ابن خلدون قرأ القرآن وحفظه وجوّده على محمد بن سعيد بن برّال بالقراءات السبع، ودرس “الشاطبية” في القراءات و”العقلية” في رسم المصحف، كما قرأ القرآن على أبي العباس أحمد الزواوي إمام المقرئين في المغرب.
ثم أقبل على العلوم بشغف، وأخذ يتردَّدُ على مجالس كبار علماء عصره في جامع الزيتونة، وانفتحت له آفاق جديدة وواسعة للتعلم في مجالس كبار شيوخ العلم، الذين كانوا في موكب سلطان بني مرين فترة استيلائه على تونس سنة 748هـ/1347م.
وأكّد أنه بحسب غالبية الدارسين، اعتمد ابن خلدون المنهج الاستقرائي منهجاً علمياً، مستخدماً التاريخ أداة رئيسية للبحث، لذلك لُقِّب “رائد المدرسة التاريخية” قبل المؤرخ والفيلسوف الإيطالي فيكو، وعالم الاقتصاد الألماني فون شمولر.
وهناك من يقول: إن ابن خلدون اعتمد منهج الاستنباط بدرجة كبيرة، وفريق آخر يقول إنه اعتمد المنهجين معاً، لافتاً إلى أن ابن خلدون نظّم عدة قصائد في صباه وشبابه، وأوردها في مواطن متفرقة من كتاباته، نماذج من سبع قصائد نظمها في مرحلة وظائفه الديوانية والسياسية، منها:قصيدة طويلة تبلغ نحو مئتي بيت أنشدها للسلطان أبي عنان المريني، يستعطفه فيها لإخراجه من المعتقل.
وقصيدتان نظمهما للسلطان المريني أبي سالم في ليلة المولد النبوي، عندما وصلت إليه هدية ملك السودان.
والرابعة أنشدها في طلب سماح الوزير عمر بن عبد الله بمغادرة البلاد، ولسلطان غرناطة ابن الأحمر، أنشد قصيدتين بمناسبة المولد النبوي، والسابعة بمناسبة ختان ولديه.
بعد ذلك ظل ابن خلدون ينظم الشعر حتى منتصف العقد الخامس من عمره، وذكر في كتابه “التعريف” لنماذج من ثلاث قصائد: الأولى هنأ بها أبا العباس سلطان تونس بعد شفائه من مرض أصابه، والثانية أرفقها بكتابه “العبر” المهدى إليه، أما الثالثة فاعتذر فيها إلى سلطان مصر، عن فتوى أرغم على كتابتها ضده في فترة الفتنة الناصرية.
والرابعة أنشدها في طلب سماح الوزير عمر بن عبد الله بمغادرة البلاد، ولسلطان غرناطة ابن الأحمر، أنشد قصيدتين بمناسبة المولد النبوي، والسابعة بمناسبة ختان ولديه.
بعد ذلك ظل ابن خلدون ينظم الشعر حتى منتصف العقد الخامس من عمره، وذكر في كتابه “التعريف” لنماذج من ثلاث قصائد: الأولى هنأ بها أبا العباس سلطان تونس بعد شفائه من مرض أصابه، والثانية أرفقها بكتابه “العبر” المهدى إليه، أما الثالثة فاعتذر فيها إلى سلطان مصر، عن فتوى أرغم على كتابتها ضده في فترة الفتنة الناصرية.
واختتم المحاضرة بالحديث عن المؤلفات الصغرى لابن خلدون، نجد كتاب “الباب المحصل في أصول الدين”، وهو على الأرجح باكورة أعماله، ونسخة وحيدة منه محفوظة في مكتبة الأسكوريال، وكتاب “شفاء السائل لتهذيب المسائل”، وهو رد على بعض أسئلة الصوفية، توجد منه مخطوطتان، بالإضافة إلى تلخيصات لكتب ابن رشد وشرح لقصيدة البردة ورجز في أصول الفقه.

